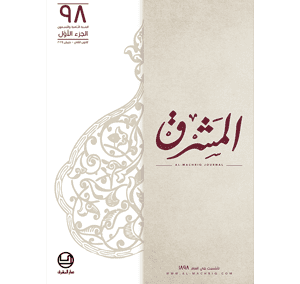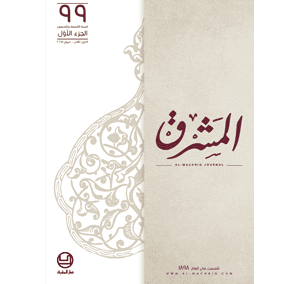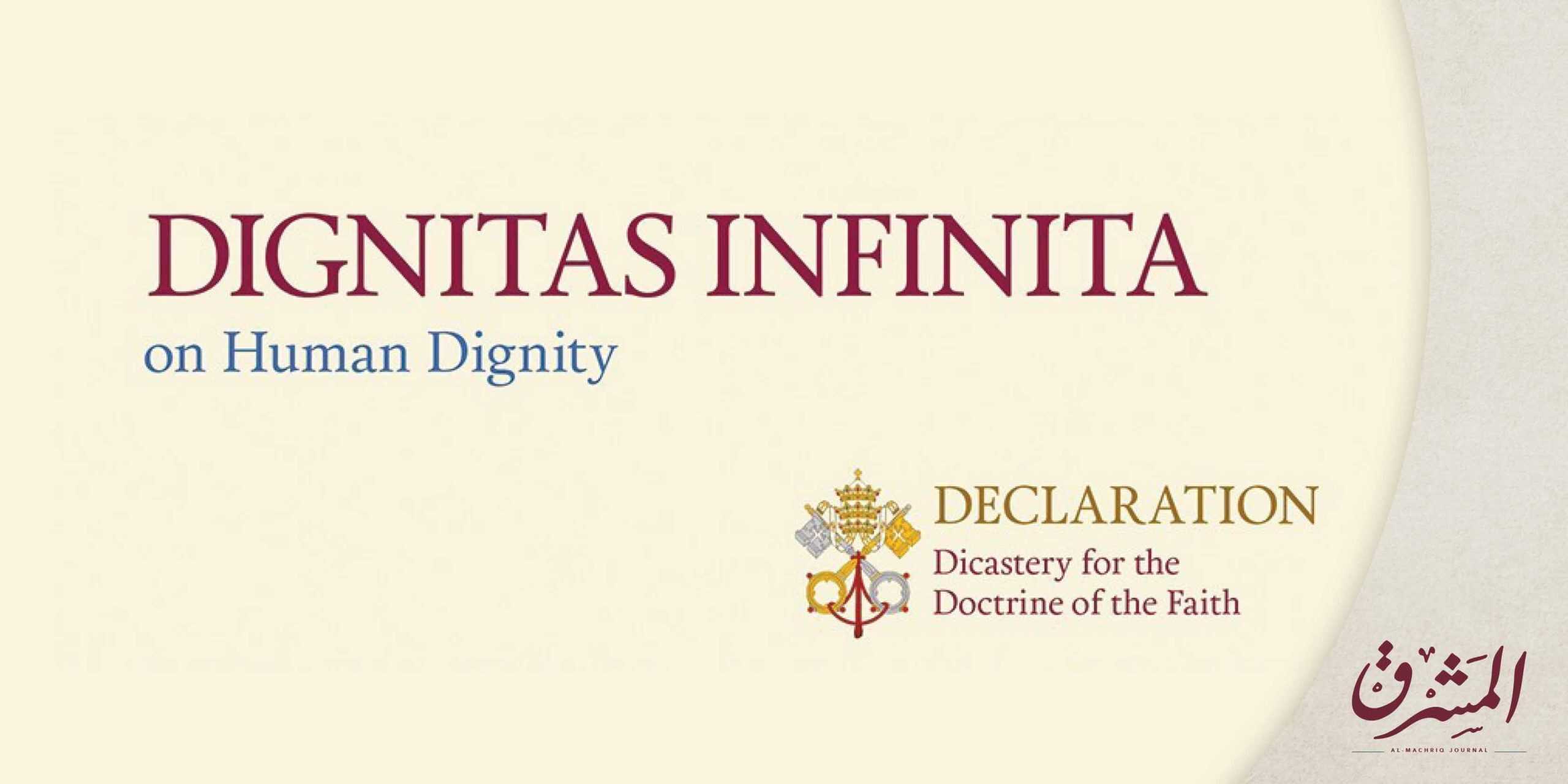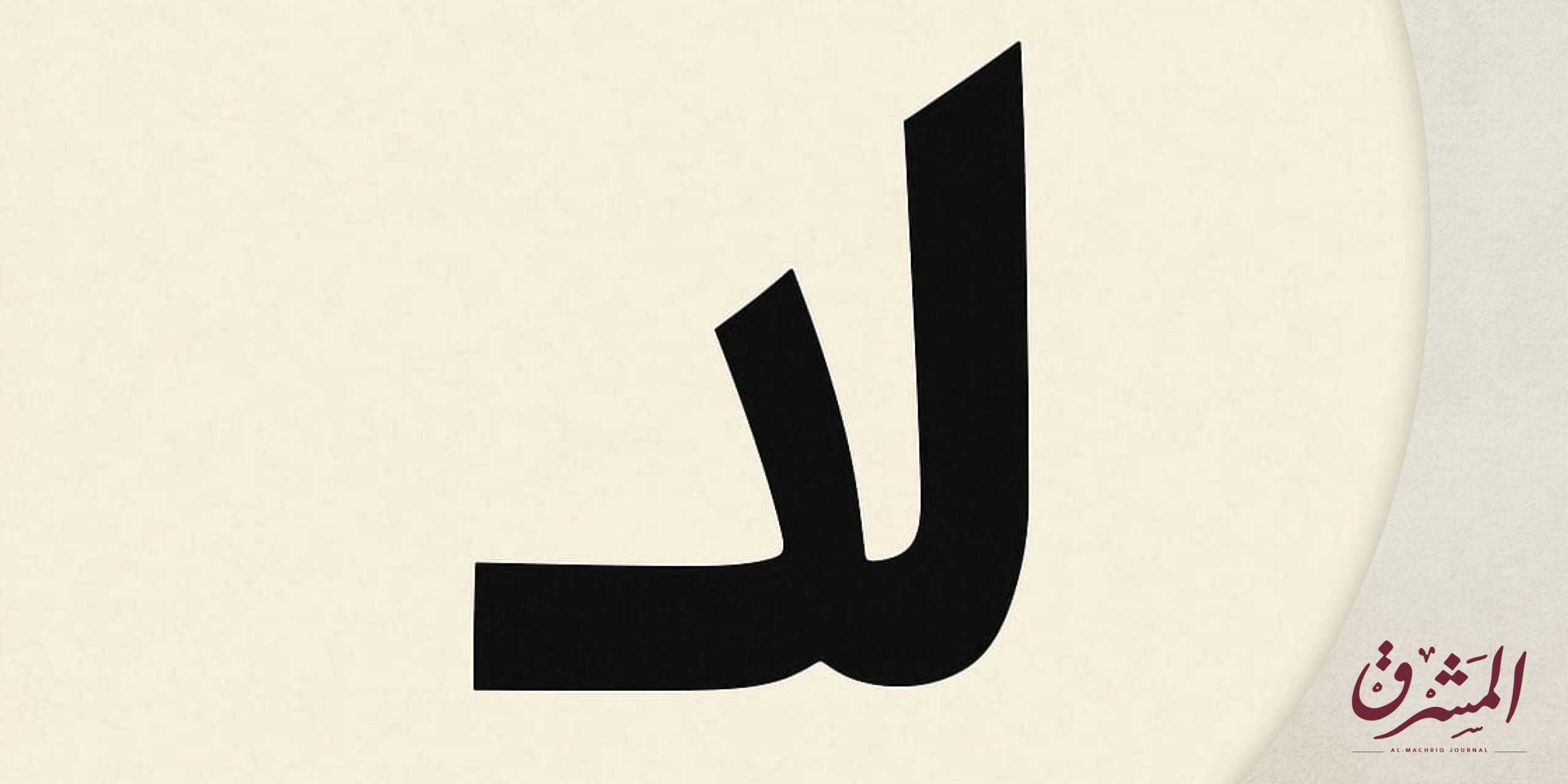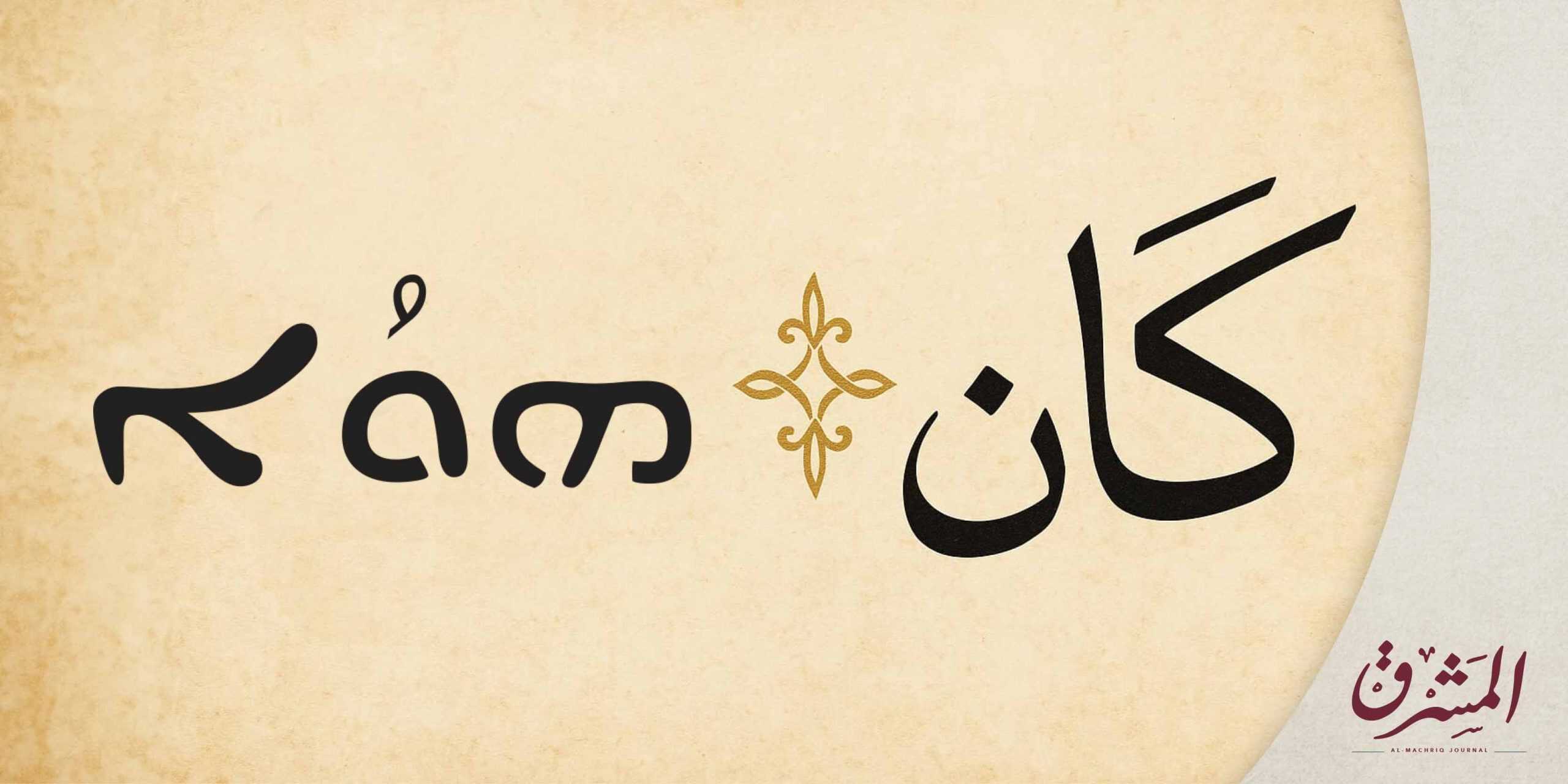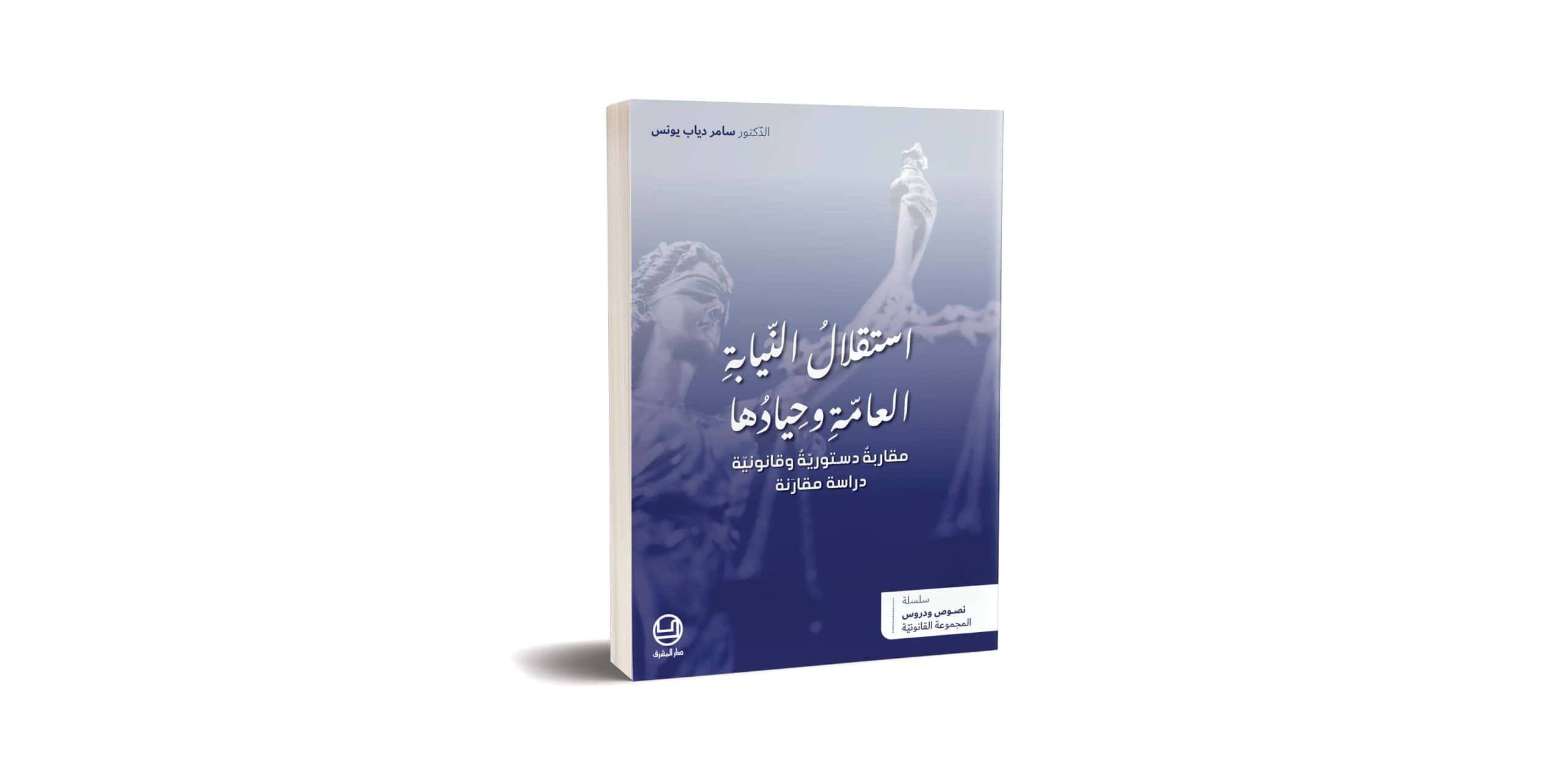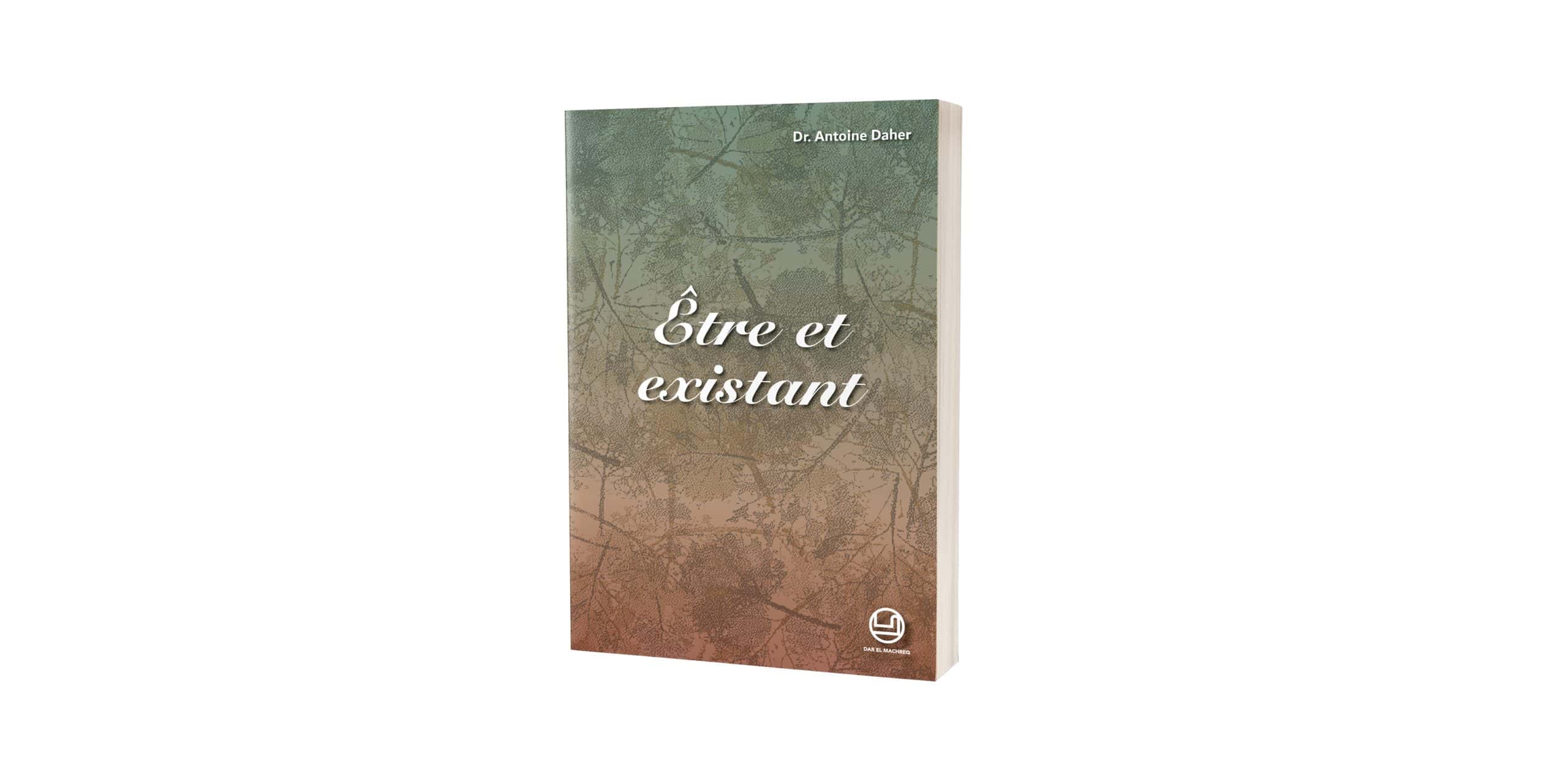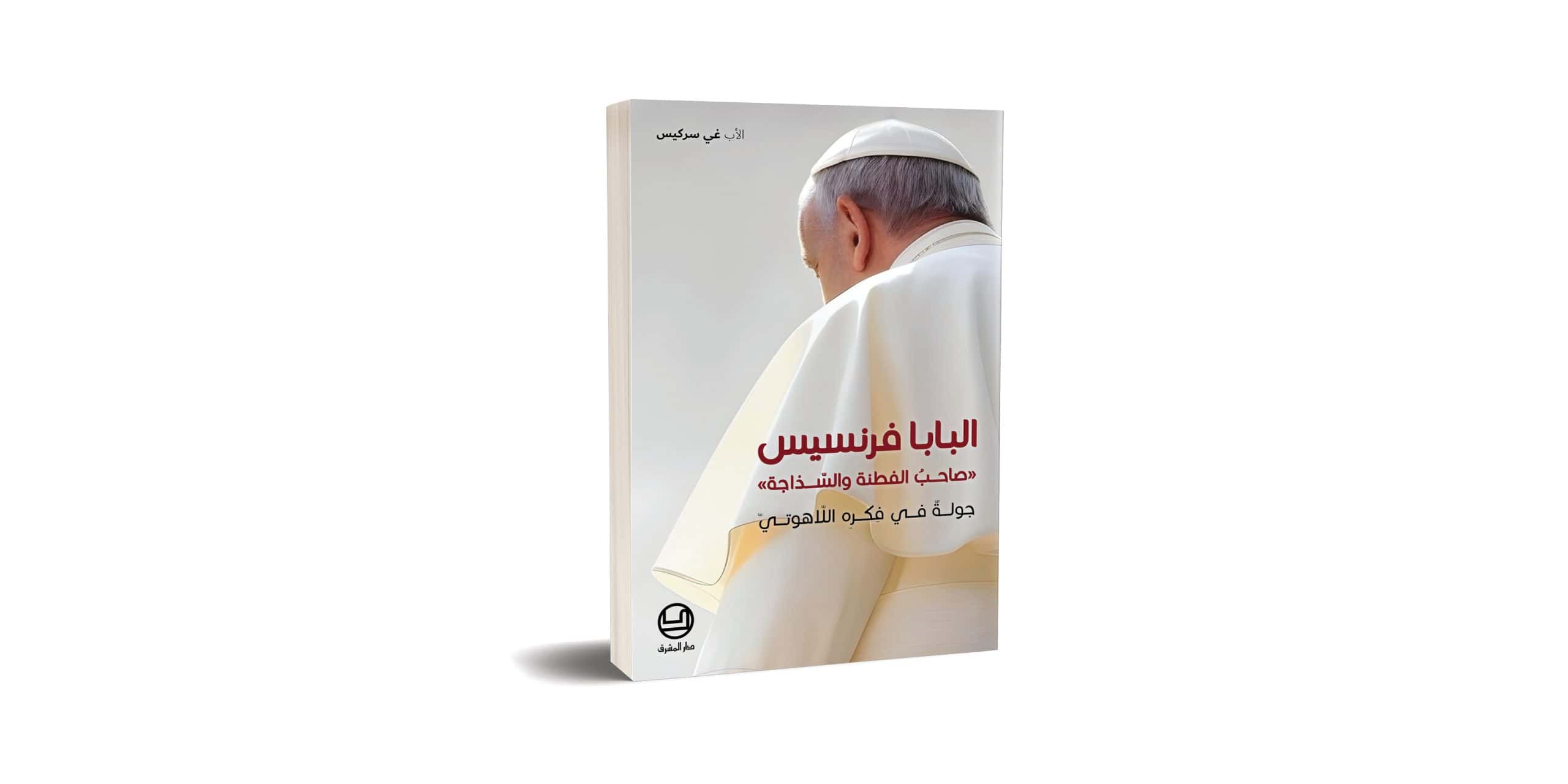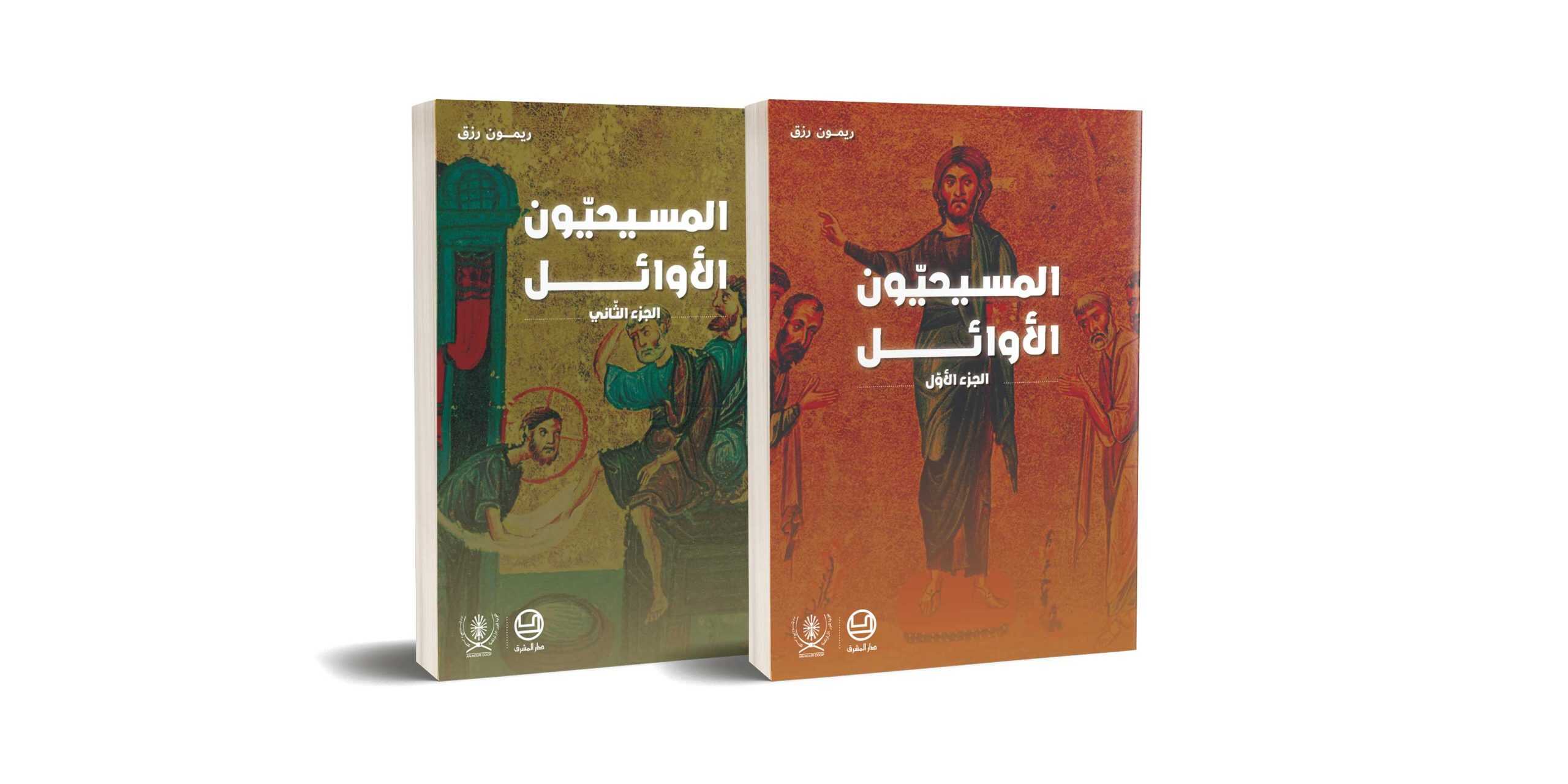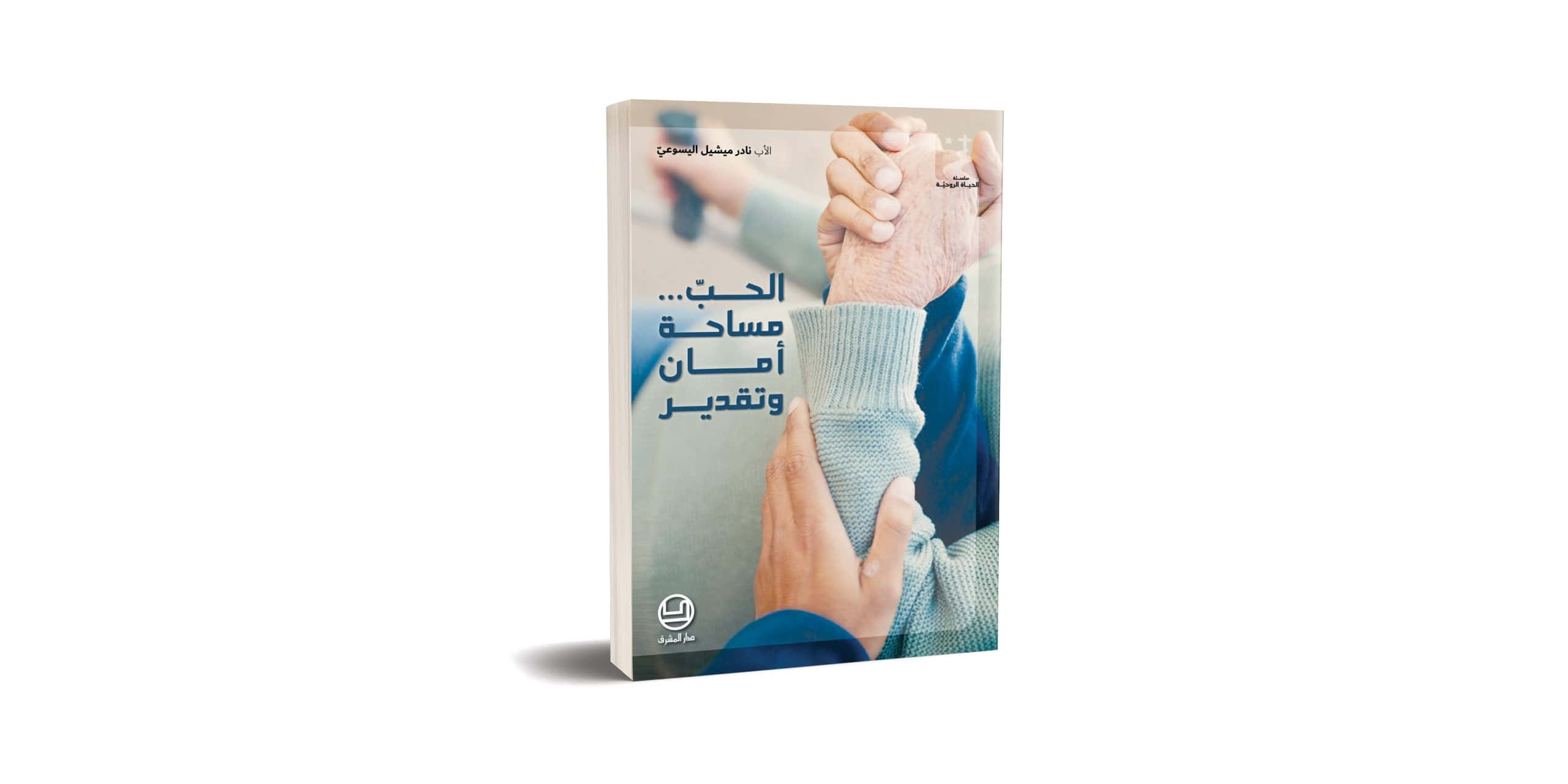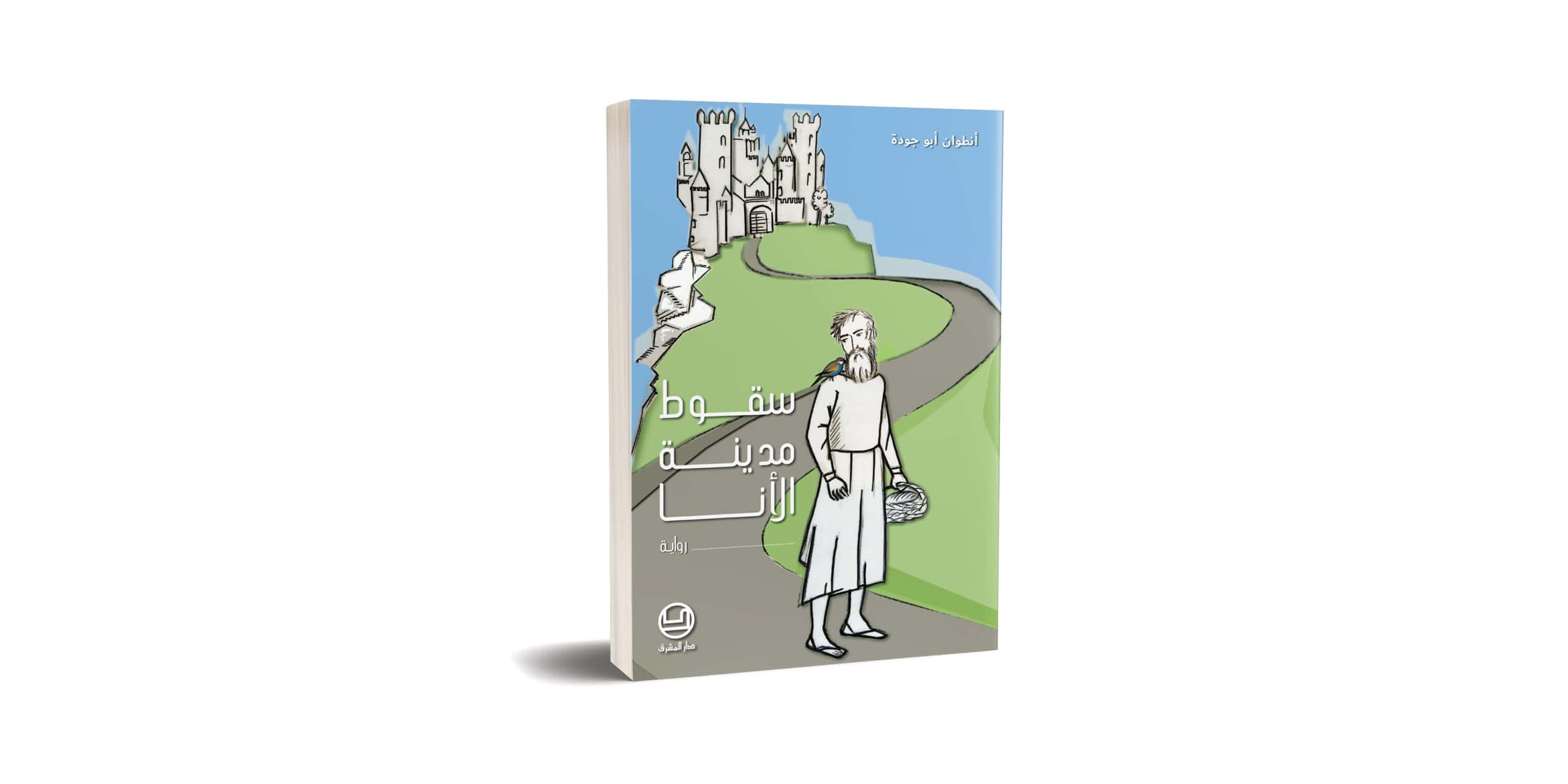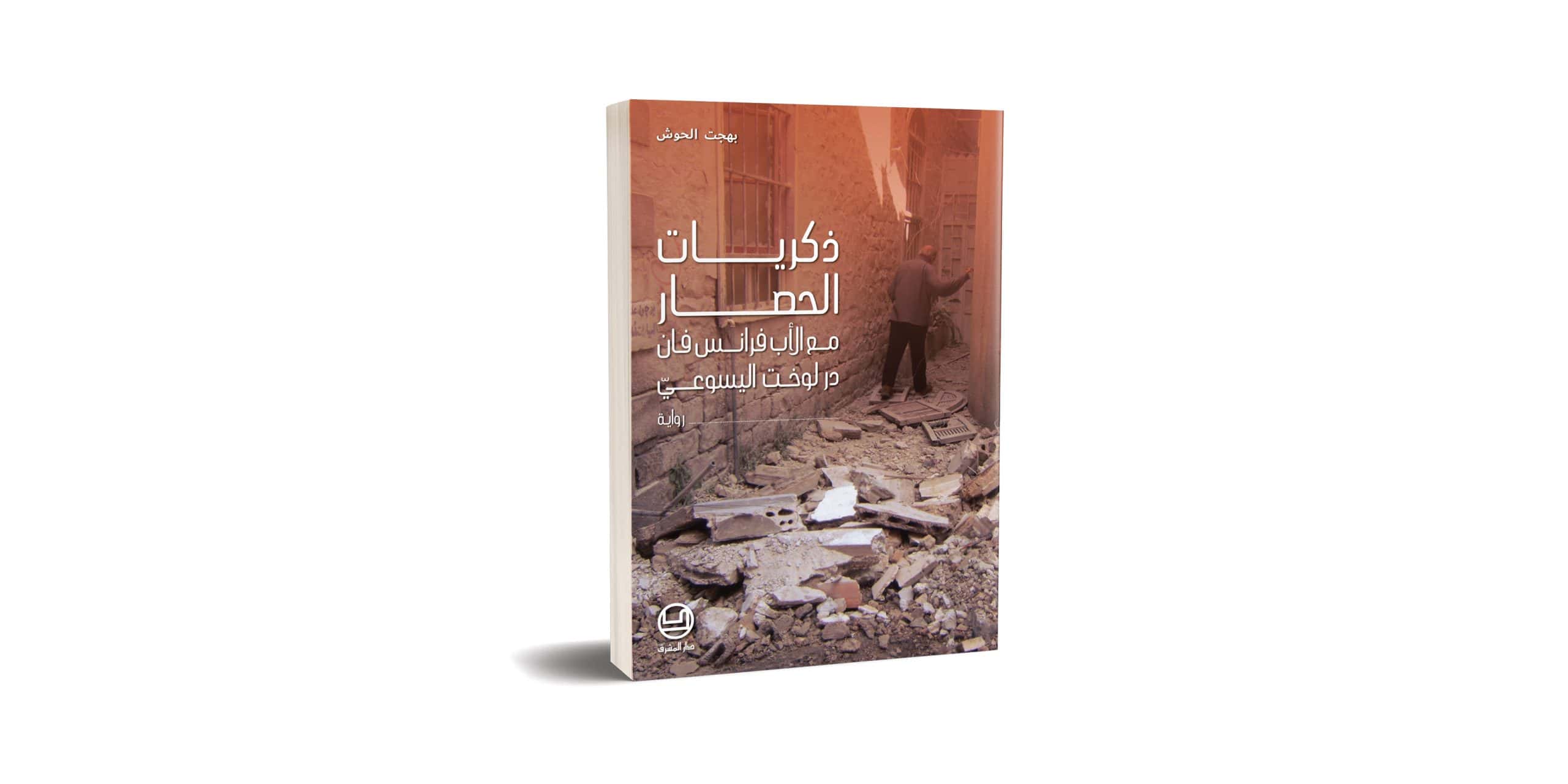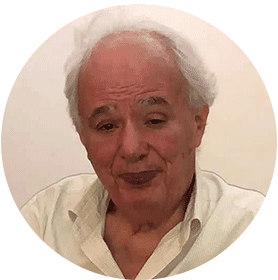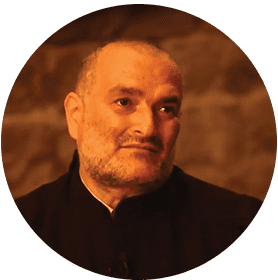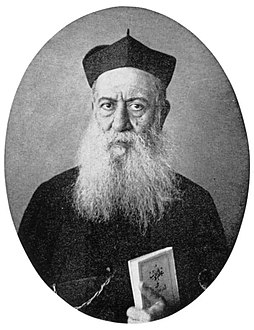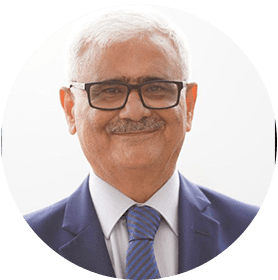كاتب
محور
مجلد
سنة
مقال
افتتـاحيّــة العدد الأحدث
اقرأ الافتتاحيّة كاملةً
المرأة من الاستمرار بالعناية المنزليَّة إلى القيادة الاجتماعيَّة الفعَّالة!
لفتت انتباهي المقالة المنشورة، في هذا العدد من مجلَّة المشرق، عن دور المرأة في الاقتصاد وإدارة الأعمال، وألهمتني أن أدوِّن هذه الكلمة في لحظة يحتاج فيها العالم الأوسع والأصغر، أكثر من أيِّ وقت مضى، إلى إعطاء المرأة موقعًا مركزيًّا في عمليَّة الإصلاح، والرِّعاية،...
مقالات العدد الأحدث
المرأة من الاستمرار بالعناية المنزليَّة إلى القيادة الاجتماعيَّة الفعَّالة!
لفتت انتباهي المقالة المنشورة، في هذا العدد من مجلَّة المشرق، عن دور المرأة في الاقتصاد وإدارة الأعمال، وألهمتني أن أدوِّن هذه الكلمة في لحظة يحتاج فيها العالم الأوسع والأصغر، أكثر من أيِّ وقت مضى، إلى إعطاء المرأة موقعًا مركزيًّا في عمليَّة الإصلاح، والرِّعاية، والبناء، والصُّمود.
فالمرأة لم تعد مجرَّد شاهدة أو داعمة خفيَّة لمسيرة التَّنمية، بل أصبحت فاعلة رئيسة لا يمكن الاستغناء عنها. في إدارة الأعمال، وفي الابتكار الاقتصاديِّ، وفي التَّغيير الاجتماعيِّ، تبرهن المرأة على ذكاء استثنائيٍّ، وقدرة على التَّوفيق بين العقلانيَّة والإنسانيَّة، وبين الحزم والبصيرة، ما يجعل منها ركيزة أساسيَّة في بناء مستقبل أكثر عدلًا وتوازنًا.
إنَّ إعطاء المرأة مساحة أوسع في مواقع القرار لا يُعدُّ استجابة لمطلب العدالة والمساواة فحسب، بل هو خيار استراتيجيٌّ يعكس وعيًا بأهميَّة التَّنوُّع، وفعَّاليَّة القيادة المتعدِّدة الرُّؤى، وثراء التَّجربة الإنسانيَّة. إنَّ عالم الغد لن يُبنى بدون النِّساء، بل سيتقوَّى ويستمرُّ بهنَّ ومن خلالهنَّ.
تؤدِّي المرأة اللُّبنانيَّة والعربيَّة دورًا متناميًا وحيويًّا في المجتمع، ولا سيَّما في ميادين الإدارة والاقتصاد والماليَّة، حيث أثبتت قدرتها على المساهمة الفعليَّة في دفع عجلة التَّنمية والتَّقدُّم. لقد تجاوزت المرأة اليوم الصُّورة التَّقليديَّة الَّتي حُصرت في إطارها لسنوات، واستطاعت أن تبرز في ميادين العلم والعمل والقيادة، بفضل ما تمتلكه من كفاءة أكاديميَّة ومهنيَّة، فنالت أعلى الدَّرجات العلميَّة من أهمِّ الجامعات، ودخلت سوق العمل بثقة ومهارة. هذا التَّقدُّم لم يقتصر على التَّحصيل العلميِّ فحسب، بل انعكس أيضًا في أساليب القيادة والإدارة الَّتي تمارسها المرأة، والَّتي تمتاز غالبًا بالمزج بين الحزم والمرونة، وبين الرُّؤية الاستراتيجيَّة والذَّكاء العاطفيِّ، ما يضفي على بيئات العمل طابعًا أكثر توازنًا وإنسانيَّة.
وتأتي مشاركة المرأة في الاقتصاد لتؤكِّد أنَّها ليست عنصرًا مكمِّلًا فحسب، بل هي شريك أساسيٌّ في النُّموِّ والإنتاج. فكلَّما زادت نسبة مشاركتها في القوى العاملة، كلَّما ارتفع النَّاتج المحليِّ، وتوسَّع النَّشاط الاقتصاديُّ، وتقلَّصت الفجوات الاجتماعيَّة، ما يعزِّز العدالة ويقوِّي النَّسيج الاجتماعيَّ. كما أنَّ تمكين المرأة اقتصاديًّا وإداريًّا يمنحها استقلاليَّة حقيقيَّة، ويعزِّز دورها كمحرِّك للتَّغيير في الأسرة والمجتمع، ويجعل منها نموذجًا ملهِمًا للأجيال الصَّاعدة من الفتيات. لكن على الرُّغم من كلِّ هذا التَّقدُّم، فإنَّ الواقع لا يزال يفرض تحدِّيات كبيرة أمام تطوُّر هذا الدَّور، أبرزها العقليَّات التَّقليديَّة الَّتي تقيِّد المرأة في أدوار نمطيَّة، وتمنعها من الوصول إلى كامل إمكاناتها.
لذلك، فإنَّ تطوير دور المرأة في المجتمع يستدعي عملًا جذريًّا على عدَّة مستويات. لا بدَّ أوَّلًا من إعادة النَّظر في الذِّهنيَّات والمفاهيم الثَّقافيَّة الَّتي تقيِّد مشاركتها، وذلك من خلال تربية قائمة على قيم المساواة والعدالة والاحترام، تبدأ من المناهج التَّعليميَّة وتُترجم في البيوت والمدارس والإعلام. كما أنَّ التَّشريعات لا بدَّ من أن تواكِب هذا التَّحوُّل، من خلال سنِّ قوانين تضمن للمرأة فرصًا متكافئة في العمل والمشاركة السياسيَّة والإداريَّة، وتمنع كلَّ أشكال التَّمييز في الأجور أو التَّرقية. ولا بدَّ أيضًا من توفير بيئة مهنيَّة آمنة ومرنة تدعم المرأة وتراعي خصوصيَّاتها، لا سيَّما من خلال سياساتٍ تتعلَّق بالإجازات العائليَّة، ودعم ريادة الأعمال النِّسائيَّة، وتسهيل الوصول إلى مراكز القرار.
ويُعتبر الإعلام أداة محوريَّة في إعادة تشكيل صورة المرأة في الوعي الجمعيِّ، إذ لا يكفي الحديث عن المساواة نظريًّا، بل يجب أن تظهر المرأة في الإعلام نموذجًا ناجحًا وفاعلًا في كلِّ المجالات، بعيدًا عن الصُّور النَّمطيَّة السَّطحيَّة الَّتي تختزلها في الجمال أو التَّبعيَّة. إنَّ تمكين المرأة لا يُعدُّ مكسبًا فرديًّا للنِّساء فحسب، بل هو استثمار في طاقة إنسانيَّة جماعيَّة قادرة على الإبداع والتَّجديد، وبناء مجتمع أكثر عدلًا وتوازنًا وابتكارًا. فليس من الممكن أن ينهض المجتمع بجناح واحد، ودورُ المرأة لم يعد خيارًا ولا ترفًا، بل هو ضرورة وطنيَّة وإنسانيَّة لبناء مستقبلٍ يليق بالجميع.
الأب سليم دكَّاش اليسوعيّ: رئيس تحرير مجلَّة المشرق. رئيس جامعة القدِّيس يوسف. رئيس رابطة جامعات لبنان. عضو في الاتِّحاد الدَّوليّ للجامعات (منذ العام 2016). حائز شهادة دكتوراه في العلوم التَّربويَّة من جامعة ستراسبورغ – فرنسا (2011)، وشهادة دكتوراه في الآداب – الفلسفة من جامعة بانتيون - السُّوربون 1 (1988)، ويدرِّس فلسفة الدِّين والحوار بين الأديان والرُّوحانيَّة السِّريانيَّة في كلِّيَّة العلوم الدِّينيَّة في الجامعة اليسوعيَّة.
مفهوم «الإنسانيَّة» في المسيحيَّة، المعنى، المقصود، والقيمة
برز مصطلح «الإنسانيَّة» حديثًا كقيمة مركزيَّة في الخطابات الدِّينيَّة والفكريَّة، لا سيَّما في وثائق مثل «وثيقة الأخوَّة الإنسانيَّة» الصَّادرة في العام 2019. تتناول المقالة مفهوم الإنسانيَّة من جوانب متعدِّدة: بيولوجيَّة، وأخلاقيَّة، وفلسفيَّة ولاهوتيَّة. فالإنسانيَّة لا تقتصر على الانتماء إلى الجنس البشريِّ، بل تتضمَّن سلوكيَّات وقيمًا مثل الرَّحمة، والعدل، والحرِّيَّة.
تستعرض الدِّراسة جذور المفهوم في الفكر اليونانيِّ (أرسطو)، والكتاب المقدَّس، والفلسفة المسيحيَّة (توما الأكوينيِّ وأغسطينوس)، حيث تُربط الإنسانيَّة بصورة الله والكرامة الذَّاتيَّة. وتقارنها بالفكر الحديث، كما في فلسفة كانط Kant، الَّتي ترى الحرِّيَّة والكرامة محورًا للإنسان، في مقابل تشاؤم هوبز Hobbes، ونزعة روسو Rousseau للتَّغيير عبر التَّربية.
وتنتهي المقالة بالدَّعوة إلى إحياء مفهوم الإنسانيَّة الواحدة في ظلِّ الأزمات العالميَّة، مؤكِّدًة أهمِّيَّة الطَّبيعة البشريَّة ركيزةً أخلاقيَّة، ومبرِزةً وثيقة الفاتيكان «الكرامة الإنسانيَّة اللَّامتناهية» Dignitas infinita خطوةً نحو توحيد الرُّؤية بشأن قيمة الإنسان وحقوقه.
كلمات مفتاحيَّة: الإنسانيَّة – الأنسنة – حقوق الإنسان – الكرامة الإنسانيَّة - الفطرة الإنسانيَّة – الفلسفة الأخلاقيَّة – الفكر الدِّينيّ – صورة الله في الإنسان - اللَّاهوت المسيحيّ – العقل والحرِّيَّة – الأخوَّة الإنسانيَّة – الوثيقة الباباويَّة – الفكر الفلسفيّ الغربيّ - أرسطو – أوغسطين – توما الأكوينيّ – إيمانويل كانط.
La notion d’« humanité » dans le christianisme : p
le sens, la visée et la valeur
par P. Salim Daccache
Le terme « humanité » s’est imposé récemment comme une valeur centrale dans les discours religieux et philosophiques, notamment à travers des textes comme le Document sur la fraternité humaine publié en 2019. Cet article explore la notion d’humanité sous divers angles : biologique, éthique, philosophique et théologique. L’humanité ne se réduit pas à l’appartenance à l’espèce humaine, mais englobe aussi des comportements et des valeurs telles que la compassion, la justice et la liberté. p
L’article retrace les racines du concept dans la pensée grecque (Aristote), la Bible, et la philosophie chrétienne (Thomas d’Aquin, Augustin), où l’humanité est liée à l’image de Dieu et à la dignité qui lui est intrinsèque. Il compare ensuite cette approche à la pensée moderne, avec Kant, pour qui la liberté et la dignité sont essentielles, face au pessimisme de Hobbes ou à l’appel de Rousseau à changer l’homme par l’éducation. p p .
L’article conclut en appelant à raviver l’idée d’une humanité unifiée face aux crises contemporaines. Il insiste sur l’importance de la nature humaine comme fondement éthique et met en lumière le document promulgué par Vatican « Dignitas infinita »: La dignité humaine infinie, comme un pas vers une vision commune de la valeur et des droits de l’être humain..bh
Mots-clés: L’humanité – L’humanisme – Les droits de l’homme – La dignité humaine – La nature humaine – La philosophie morale – La pensée religieuse – L’image de Dieu dans l’homme – La théologie chrétienne – La raison et la liberté – La fraternité humaine – Le document pontifical – La pensée philosophique occidentale – Aristote – Augustin – Thomas d’Aquin – Emmanuel Kant. p
الأب سليم دكَّاش اليسوعيّ: رئيس تحرير مجلَّة المشرق. رئيس جامعة القدِّيس يوسف. رئيس رابطة جامعات لبنان. عضو في الاتِّحاد الدَّوليّ للجامعات (منذ العام 2016). حائز شهادة دكتوراه في العلوم التَّربويَّة من جامعة ستراسبورغ – فرنسا (2011)، وشهادة دكتوراه في الآداب – الفلسفة من جامعة بانتيون - السُّوربون 1 (1988)، ويدرِّس فلسفة الدِّين والحوار بين الأديان والرُّوحانيَّة السِّريانيَّة في كلِّيَّة العلوم الدِّينيَّة في الجامعة اليسوعيَّة.


ديناميَّات قيادة المرأة في الاقتصادات النَّاشئة: بين العقبات الهيكليَّة وعوامل النُّهوض
تستقصي هذه الدِّراسة دور المرأة المتطوِّر في مجال الأعمال التِّجاريَّة، مع التَّركيز على مشاركتها في القيادة وريادة الأعمال والابتكار الرَّقميِّ، سواء على الصَّعيد العالميِّ أو في الاقتصادات الهشَّة مثل لبنان. بالاعتماد على الأطر النَّظريَّة، بما في ذلك نظريَّة رأس المال البشريِّ، ونظريَّة الدَّور الاجتماعيِّ، والنَّظريَّة القائمة على الموارد، والنَّظريَّة المؤسَّسيَّة، يستكشف البحث كيفيَّة مساهمة المرأة في التَّنمية الاقتصاديَّة والتَّحوُّل التَّنظيميِّ على الرُّغم من العوائق الهيكليَّة المستمرَّة. تسلِّط الدِّراسة الضَّوء، من طريق تحليل مزيج من الإحصاءات العالميَّة، ودراسات الحالة الإقليميَّة، والمبادرات الشَّعبيَّة اللُّبنانيَّة، كيف أنَّه في حين أنَّ النِّساء يمثِّلنَ ٦٪ فقط من الرُّؤساء التَّنفيذيِّين العالميِّين و٢٨٪ من المناصب القياديَّة في العالم، إلَّا أنَّ وجودهنَّ يعزِّز، بشكل كبير، الحوكمة، والمرونة، والاستدامة في الأعمال التِّجاريَّة. ففي لبنان، حيث لا تزال القيود المؤسَّسيَّة والماليَّة قائمة، تستفيد رائدات الأعمال من الشَّبكات غير الرَّسميَّة، والأدوات الرَّقميَّة، والاستراتيجيَّات المجتمعيَّة لخلق قيمة اقتصاديَّة شاملة. تشير النَّتائج إلى أنَّ مشاركة المرأة في الأعمال التِّجاريَّة لا تعزِّز المساواة فحسب، بل ترتبط بتحسين الأداء الماليِّ، وإدارة الأزمات والابتكار على المدى الطَّويل. وتختتم المقالة بالتَّشديد على الحاجة إلى إصلاحات متكاملة في السِّياسات، وبرامج التَّمكين الرَّقميِّ، والدَّعم المؤسَّسيِّ لتسريع التَّكافؤ بين الجنسَين في قيادة الأعمال وريادتها.
كلمات مفتاحيَّة: القيادة النِّسائيَّة – ريادة الأعمال – المساواة بين الجنسَين – التَّمكين الرَّقميّ – التَّنمية الشَّاملة – الإصلاح المؤسَّسيّ.
Dynamiques du leadership féminin
dans les économies émergentes: Entre obstacles structurels et leviers d’action
Cet article examine l’évolution du rôle des femmes dans les entreprises, en mettant l’accent sur leur participation au leadership, à l’entrepreneuriat et à l’innovation numérique, tant au niveau mondial que dans les économies fragiles telles que le Liban. S’appuyant sur des cadres théoriques tels que la théorie du capital humain, la théorie des rôles sociaux, la vision basée sur les ressources et la théorie institutionnelle, cette recherche explore la manière dont les femmes contribuent au développement économique et à la transformation organisationnelle en dépit de barrières structurelles persistantes. Grâce à une analyse combinée de statistiques mondiales, d’études de cas régionales et d’initiatives locales libanaises, l’étude souligne que bien que les femmes ne représentent que 6% des PDG dans le monde et 28% des postes de direction, leur présence renforce considérablement la gouvernance, la résilience et la durabilité des entreprises. Au Liban, où les contraintes institutionnelles et financières persistent, les femmes entrepreneurs s’appuient sur des réseaux informels, des outils numériques et des stratégies communautaires pour créer une valeur économique inclusive. Les résultats indiquent que l’implication des femmes dans les entreprises favorise non seulement l’équité, mais est également corrélée à l’amélioration des performances financières, à la gestion des crises et à l’innovation à long terme. L’article conclut en soulignant la nécessité de réformes politiques intégrées, de programmes d’autonomisation numérique et d’un soutien institutionnel pour accélérer la parité hommes-femmes dans la direction des entreprises et dans les initiatives entrepreneuriales. .
Mots clés: Leadership féminin – Esprit d’entreprise – Égalité des sexes – Autonomisation numérique – Développement inclusif – Réformes institutionnelles. p
الدُّكتورة ندى الملَّاح البستانيّ: رئيسة مؤسِّسة لجمعيَّة التَّميُّز للأبحاث المبتكرة والاستدامة والتَّنمية الاقتصاديَّة AXISSED. أستاذة في كلِّيَّة الإدارة والأعمال في جامعة القدِّيس يوسف ببيروت. حائزة شهادة دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة «Jean Moulin Lyon 3» – فرنسا، وحائزة شهادة «HDR» في الإدارة والأموال من جامعة «Picardie – Jules Verne» – فرنسا، وماجستير في العلوم الدِّينيَّة من جامعة القدِّيس يوسف ببيروت. أستاذة ومستشارة في الهيئة اليسوعيَّة العالميَّة للتَّعليم JWL . عضو ناشط في العديد من الهيئات البحثيَّة العلميَّة AIS, LEFMI، وعضو مؤسِّس في المنظَّمة البيئيَّة Green Community.


نشوء اقتصاد دولة لبنان في ظلِّ الانتداب الفرنسيّ- السَّنوات الأولى، الأطر العامَّة والموارد الأهمُّ
تميَّزت السَّنوات الأولى للسَّيطرة الفرنسيَّة على بلادنا بمراحل عدَّة: بدأت بالسَّيطرة العسكريَّة على أراضي لبنان الحاليِّ كافَّة، ثمَّ كامل أراضي برِّ الشَّام. وبعد ذلك تمَّت السَّيطرة الإداريَّة التَّدريجيَّة وتنظيم إدارات الدَّولة اللُّبنانيَّة وإدارة أجهزة الانتداب. وتلتها بالتَّزامن معها عمليَّة تنظيم الاقتصاد: مركزيًّا عبر «المصالح المشتركة» الَّتي صمِّمت للسَّيطرة على المفاصل الاقتصاديَّة والسياسيَّة الأساسيَّة في منطقة الانتداب: من بنك مركزيٍّ فرنسيّ الهويَّة، وعملة واحدة مرتبطة بالفرنك الفرنسيّ لكلِّ نطاق الانتداب، كذلك نظام جمركيٍّ واحد وغيرها من أدوات ضبط الاقتصاد والسُّلطات العامَّة في كلِّ منطقة الانتداب الفرنسيِّ. وتُركت قطاعات اقتصاديَّة عديدة للدُّول النَّاشئة عن الانتداب، منها دولة لبنان الكبير.
لكنَّ دور الوزارات القطاعيَّة في الدُّول المكوِّنة لنطاق الانتداب الفرنسيّ أخذ يتوسَّع بخاصَّةٍ في دولة لبنان الكبير، ثمَّ الجمهوريّة اللُّبنانيَّة مع التطوُّرات الاقتصاديَّة والسياسيَّة ابتداء من العشرينيَّات ومن ثمَّ وبخاصَّةٍ في الثَّلاثينيَّات.
وفي هذا الإطار العامِّ انحصرت أهمُّ موارد الدَّخل في لبنان بأمرَين: أوَّلًا، الهجرة الَّتي استؤنِفت في العشرينيَّات. وثانيًا، قطاع الحرير الَّذي استعاد نشاطه بدفع من سلطات الانتداب ومصالح الفرنسيِّين في هذا القطاع في فرنسا حتَّى أواخر العشرينيَّات.
كلمات مفتاحيَّة: لبنان الكبير – الجمهورية اللُّبنانيَّة – الهجرة – إنتاج الحرير - الانتداب – المصالح المشتركة.
L’émergence de l’économie de l’Etat libanais au début du Mandat Français
par Dr. Boutros Labaki
Les premières années du Mandat français sur le Liban furent marquées par plusieurs étapes: le contrôle militaire de tous les territoires du Liban actuel, puis de tous les territoires du Levant. Parallèlement, un contrôle administratif et une organisation progressive des administrations de l’État libanais et des institutions du Mandat ont été mis en place. p
Ce processus fut suivi, de manière simultanée, par l’organisation de l’économie : de manière centralisée, à travers « l’Organisation des intérêts communs » destinés à contrôler les mécanismes économiques et politiques de base dans l’espace mandataire : Une banque centrale aux capitaux français, une monnaie unique liée au franc français pour toute la zone du mandat. Egalement un système douanier unique fut établi ainsi que d’autres outils, pour contrôler l’économie et les pouvoirs publics de toute la zone du mandat français. De nombreux secteurs économiques sont cependant laissés aux États issus du mandat, notamment le Grand Liban. p
Cependant, le rôle des ministères sectoriels dans les pays du Levant sous le mandat français commença à s’accroître, notamment au Grand Liban puis en République libanaise, avec les développements économiques et politiques des années 1920 et surtout des années 1930. p
Dans ce cadre général, les sources de revenus les plus importantes du Liban étaient au nombre de deux : Les remises de l’émigration, qui reprit dans les années 1920, et le secteur de la soie, qui reprit son activité avec le soutien des autorités mandataires et les intérêts du secteur séricicole français jusqu’à la fin des années 1920. p
Mots clés: Grand Liban – République Libanaise – émigration – sériciculture – Mandat – Intérêts Communs. p
الدُّكتور بطرس لبكي: دكتوراه في التاريخ الاقتصاديِّ من جامعة السُّوربون – باريس. أستاذ ورئيس مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعيَّة – الجامعة اللُّبنانيَّة. أستاذ ومدير أبحاث في جامعة القدِّيس يوسف، وأستاذ في الجامعة الأميركيَّة – بيروت، وفي جامعة ليون الثَّانية، ويعمل في المركز الوطنيِّ الفرنسيِّ للأبحاث العلميَّة في باريس ورين، كما في جامعة أكسفورد والمعهد الألمانيِّ للأبحاث التَّربويَّة الدَّوليَّة في فرانكفورت. له العديد من الأبحاث في المجالَين الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ، وآخرها كتابُه «هجرة اللُّبنانيِّين (1850-2018) مسارات عولمة مبكِّرة».


أثر علوم اللُّغة في الخطِّ العربيّ
يُعتبر المعيار الجماليُّ أساسًا في الخَطِّ العربيِّ، وقد نَفَرَ الكُتَّاب واللُّغويُّون العرب من تكرار الحروف المتماثلة، فلجأوا إلى الحذف. يتناول هذا البحث كتابة «إذَن» بالنُّون، والألف «إذًا»؛ كما يتناول وصلَ «في» بِـ «ما» وانفصالهما؛ بالإضافة إلى وصل «لا» النَّافية بـ «أنْ» النَّاصبة للفعل المضارع، و«أنْ» المُخَفَّفة من «أنَّ»، و«أنْ» التَّفسيريَّة؛ كذلك كتابة التَّاء مربوطةً، أو مبسوطة؛ وحذف الألف وزيادتها والواو في المواضع المختلفة.
ختامًا، لو اعتمد العلماء قاعدة «كلُّ ما يُقْرَأُ يُكْتَبُ، وما لا يُقْرَأُ لا يُكْتَبُ»، لبَسَّطوا قواعد الإملاء العربيِّ.
كلمات مفتاحيَّة: الجوار – الخطّ – علوم اللُّغة – الكتابة – الحذف والزِّيادة – أثر – الألف والهمزة.
L’Influence des sciences linguistiques
sur la calligraphie arabe
par Dr. Ghassan Hamad
Le critère esthétique est considéré comme fondamental dans la calligraphie arabe. Les écrivains et linguistes arabes étaient rebutés par la répétition de lettres similaires et avaient recours à la suppression. Cette recherche porte sur l’écriture de «idhan» avec «nun» et «alif» «idhan»; ils abordent également le lien entre «fi» et «ma» et leur séparation. En plus de relier la forme négative «la» à «an» qui rend le verbe au présent nominatif, et à «an» qui est une version allégée de «anna», et à «an» qui est explicative ; De plus, l’écriture de la lettre taa’ est soit connectée, soit étendue. Suppression et ajout de la lettre alif et waw à différents endroits.
Enfin, si les savants avaient adopté la règle «tout ce qui est lu peut-être écrit, et ce qui n’est pas lu ne peut être écrit», ils auraient simplifié les règles de l’orthographe arabe.
Mots-Clés: Voisinage – Calligraphie – Sciences du langage – Ecriture – L’élision et l’ajout – Influence – La lettre Alef et le Hamza.
الدُّكتور غسَّان حمد: حائز شهادة الدُّكتوراه في اللُّغة العربيَّة وآدابها من جامعة القدِّيس يوسف – 2023، وعنوانها: أَثَرُ الجِوارِ اللُّغَويّ. مُدَرِّس في ملاك التَّعليم الثانويّ. وله عِدّة أبحاث لُغَويّة وأدبيَّة منشورة في مجلَّات مُحَكّمة، وديوانان شِعرِيَّان: قصائد حُبٍّ من جَبَل المَكْمل – دار الفارابي، 2018؛ ولقد مَسَّني الشِّعْر – دار الحداثة، 2024.


معنى النَّفي في «لا» النَّافية للجِنْس و«لا» العاملة عمل «لَيْس» و«لا» المُهْمَلة هو هو أم مختلف؟
يحاول هذا البحث الإجابة عن السُّؤال العنوان: «معنى النَّفي في «لا» النَّافية للجنس، و«لا» العاملة عمل «ليس»، و«لا» المهملة هو هو أم مختلف؟»، فيبدأ أوَّلًا بعرض أوجه «لا» السَّبعة؛ لينتقل بعدها إلى اللَّاءات الثَّلاث الَّتي هي عنوان البحث، فيفصِّل شروط عمل كلٍّ منها، وما قاله النُّحاة في معنى كلٍّ منها أيضًا في حالة مجيء الاسم بعدها مفردًا، ومثنًّى وجمعًا.
ويخلص البحث إلى أنَّ تفرقة النَّحاة في المعنى بين «لا» العاملة عمل «ليس»، و«لا» غير العاملة من جهة، وبين «لا» النَّافية للجنس من ناحية أخرى غير صحيح، فكلُّ هذه اللَّاءات تعني نفي الجنس نفيًا تامًّا، إلَّا إذا قلت: «لا رجلٌ في الدَّار بل رجلان»، عند ذلك يدلُّ السِّياق على أنَّ «لا» تنفي الوحدة لا الجنس.
كلمات مفتاحيَّة: «لا» النَّافية للجنس – «لا» العاملة عمل «ليس» – «لا» المهملة (غير العاملة) – المعنى – «لا» الجوابيَّة – «لا» الطَّلبيَّة – «لا» الزَّائدة – «لا» العاطفة – لغة تميم – المثنَّى – الجمع – البناء – الإعراب.
Le sens de la négation dans « lã » le négateur du genre, « lã » celui qui fonctionne comme « laysa » et « la » celui négligé est-il le même ou différent ?
par Dr. Ali Ahmed Ismail
Cette recherche tente de répondre à la question du titre : «Le sens de la négation dans «lā», le négateur du genre, «lā» qui fonctionne comme «laysa», et «lā» le négligé, est-il le même ou différent ?» Il commence par présenter d’abord les sept aspects de «lā»; Il passe ensuite aux trois «lā» qui constituent le titre de la recherche, et il explique les conditions de fonctionnement de chacun d’eux, et ce que les grammairiens ont dit sur le sens de chacun d’eux également dans le cas du nom qui le suit au singulier, au duel et au pluriel.
La recherche conclut que la distinction de sens faite par les grammairiens entre «lā» qui fonctionne comme «laysa» et «lā» qui ne fonctionne pas d’une part, et «lā» qui nie le genre d’autre part est incorrecte, car tous ces «lā» signifient une négation complète du genre, à moins que vous ne disiez: «Il n’y a pas un homme dans la maison, mais deux hommes», auquel cas le contexte indique que «lā» nie l’unité, pas le genre.
Mots-clés: «Lā» la particule négative – «Lā» qui fonctionne comme « laysa » – «Lā» le négligé (non opératoire) – le sens – «Lā» le creux – «Lā» l’impératif – «Lā» le redondant – «lā» l’émotionnel – le langage de Tamim – le duel – le pluriel – la construction – l’analyse.
الدُّكتور علي أحمد اسماعيل: حائز شهادة الدُّكتوراه في اللُّغة العربيَّة وآدابها من جامعة القدِّيس يوسف – 2022، بعنوان «الانزياح في شعر أدونيس». وهو مدير معهد بخعون الفنِّيِّ الرَّسميِّ. له أبحاث منشورة في مجلَّات مُحكَّمة، وتحقيق مخطوطة فتح الجليل (شرح قصيدة امرئ القيس الملك الضَّليل)، للشَّيخ أحمد السِّجاعي المصريِّ الأزهريِّ (ت. 1197هـ) – 2023، وديوانا شعر: الجدول المحترق، بيروت: دار الحداثة للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، 2023؛ وأناديكِ مِن آخر الكلمات، طرابلس: مطابع المكمل ، 2011.


«كان» ومشتقَّاتها بين إنجيل عيسى المسيح والقرآن
نشأنا، منذ صغرنا، على أنَّ «كان» هي فعلٌ ماضٍ ناقص، وأنَّ «هو» ضمير للغائب، ومع تحقيق مخطوطات إنجيل عيسى، بالعودة إلى النَّصّ السُّريانيِّ الأمِّ، تبيَّن لنا أنَّ الأمر مختلف تمامًا، فـ «كان» هي من «الكينونة» «وهو» من «الهويَّة»، وبالتَّالي فهما يلتقيان في المعنى، وينتهي بذلك مفهوم الفعل النَّاقص والجملة الاسميَّة في اللُّغة العربيَّة. قارنَّا هذا المعنى بما ورد في القرآن فوجدناه متطابقًا! علَّ أن يجد النُّحاة في نصِّ إنجيل عيسى، الَّذي سينشر قريبًا، مادَّة لإعادة صياغة قواعد كثيرة في اللُّغة العربيَّة.
كلمات مفتاحيَّة: كان – كينونة – هو – هويَّة – إنجيل عيسى – القرآن.
«Kana كان» et ses dérivés Selon l’Évangile de Issa le Christ et le Coran
par P. Hanna Skandar
Dès notre enfance, nous avons été élevés sur le fait que «kana كان» l’équivalent du verbe ‘être’ à l’imparfait «était» est un verbe qui relève du passé incomplet, et que «Huwa هو» ou le pronom personnel «il» en français est un pronom qui exprime une personne absente. p
Toutefois, lorsque j’ai édité les manuscrits de l’Évangile de Issa le Christ et je les ai comparés avec le texte mère syriaque, j’ai découvert que leur sens est complètement différent, car «kana كان» dérive du mot «kaynounat كينونة» qui veut dire « l’existence » et «Hawiyyat هويَّة» exprime « l’identité ». Donc, du point de vue sémantique, ils sont identiques, ce qui met fin au concept du verbe incomplet et à la phrase «sans verbe» en arabe… p
Nous avons comparé ce sens avec le Coran et nous l’avons trouvé identique! Dans le texte que j’ai édité sur l’Évangile de Issa le Christ et qui sera publié prochainement, les grammairiens trouveront de la matière pour reformuler de nombreuses règles de la langue arabe. p
Mots clés: kana كان – kaynounat كينونة – existence – Hawiyyat هويَّة – identité. p
الأب حنَّا إسكندر: أستاذ مادَّة التَّاريخ الوسيط واللُّغات القديمة في الجامعة اللُّبنانيَّة. نشر عشرات الكتب والمقالات البحثيَّة. فَهْرَسَ حوالى خمسين ألف وثيقةٍ وعشرات المخطوطات وحقَّقها، واشترك في عشرات المؤتمرات الدَّوليَّة في البلاد العربيَّة والأوروبيَّة.


التِّنِّين الرُّؤيويُّ بين الأساطير وأيديولوجيَّة عبادة الإمبراطور (رؤ 12-13)
يُعَدّ تنِّين سفر الرُّؤيا رمزًا قويًّا للصِّراع بين الخير والشَّرِّ، وله جذورٌ عميقةٌ في الأساطير القديمة. يَظهر التِّنِّين في الرُّؤيا ككائنٍ ضخمٍ أحمر اللَّون ذي سبعة رؤوسٍ وعشرة قرون، يسعى لافتراس الطِّفل المولود من المرأة، في صورةٍ دراميَّةٍ تشير إلى اضطهاد القوى الشِّرِّيرة لشعب الله أو للمسيح نفسه. لا ينفصل هذا التَّصوير عن رموزٍ أسطوريَّةٍ سابقة. ففي الميثولوجيا البابليَّة، على سبيل المثال، يواجه الإله مردوخ التِّنِّين تيامات، رمز الفوضى، ويقهره ليقيم نظام الخليقة. أمَّا في الأساطير الكنعانيَّة فيحارب الإله بعل التِّنِّين لاوياثان أو يمَّ. وفي الأساطير اليونانيَّة يواجه أبولو التِّنِّين بايثون. هذه الأساطير كلُّها تتحدَّث عن إلهٍ منتصرٍ على وحشٍ فوضويٍّ، يمثِّل الشَّرَّ والدَّمار. يستخدم كاتب سفر الرُّؤيا لغةً رمزيَّة مفعمةً بالصُّور المأخوذة من خلفيَّةٍ يهوديَّةٍ وهِلِّنِسْتيَّة، فيُعيد توظيف صورة التِّنِّين ليرمز إلى الشَّيطان أو الإمبراطوريَّة الرُّومانيَّة المضطهِدة، معيدًا تأويل الأسطورة القديمة في ضوء الرُّؤيا المسيحيَّة. وبذلك، يتحوَّل التِّنِّين من كائنٍ أسطوريٍّ إلى رمزٍ لاهوتيٍّ في معركة الخلاص.
كلمات مفتاحيَّة: سفر الرُّؤيا – التِّنِّين – الحيَّة – الأساطير القديمة – الثَّقافات القديمة – الإمبراطور – عبادة – أيديولوجيَّة.
Le dragon visionnaire
Entre mythes et idéologie du culte de l’empereur
(Apocalypse 12-13)
par l’Archimandrite Agapios Abu Saada
Le dragon de l’Apocalypse est un puissant symbole de la lutte entre le bien et le mal, et a des racines profondes dans la mythologie ancienne. Le dragon apparaît dans la vision comme une énorme créature rouge à sept têtes et dix cornes, cherchant à dévorer l’enfant né de la femme, dans une image dramatique indiquant la persécution des forces du mal du peuple de Dieu ou du Christ lui-même. Cette représentation est indissociable des symboles mythologiques antérieurs. Dans la mythologie babylonienne, par exemple, le dieu Marduk affronte le dragon Tiamat, symbole du chaos, et le vainc pour établir l’ordre dans la création. Dans la mythologie cananéenne, le dieu Baal combat le dragon Léviathan ou Yamm. Dans la mythologie grecque, Apollon affronte le dragon Python. Tous ces mythes parlent d’un dieu triomphant d’un monstre chaotique, représentant le mal et la destruction. L’auteur du Livre de l’Apocalypse utilise un langage symbolique rempli d’images tirées d’un contexte juif et hellénistique, réutilisant l’image du dragon pour symboliser Satan ou l’Empire romain oppressif, réinterprétant le mythe antique à la lumière de la vision chrétienne. Ainsi, le dragon se transforme d’une créature mythique en un symbole théologique dans la bataille pour le salut.
Mots-clés: Livre de l’Apocalypse – dragon – serpent – mythologie antique – cultures anciennes – empereur – culte – idéologie.
الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدى: راهب مخلِّصيٌّ من بيت ساحور - فلسطين. دكتور في لاهوت الكتاب المقدَّس، وباحثٌ في الدِّراسات المسيحيَّة الشَّرق أوسطيَّة. له عدَّة كتبٍ منشورة، ومنها: المسيحيُّون الفلسطينيُّون: أصالةٌ وطنيَّة وخصوصيَّة دينيَّة وصوتٌ جامع ودورٌ يفوق العدد؛ ابن هذا الشَّرق: دراسةٌ في الوجود المسيحيِّ في الشَّرق في القرون السِّتَّة الميلاديَّة الأولى؛ المسيحيُّون في الشَّرق الأوسط: براديغمٌ جديدٌ لتحليل إشكاليَّات الوجود والمستقبل.


قراءة كتابيَّة في «خدمة الزَّيت المقدَّس» تأوين / تحقيق الشِّفاء
كلمات مفتاحيَّة: الزَّيت المقدَّس – العهد الجديد – اللِّيترجيَّة – الكنيسة – الشِّفاء – المسيح.
Relecture Biblique de « l’Office de l’Huile Sainte » – Actualisation de la guérison
par Métropolite Nicolas Antiba
L’Eglise Byzantine célèbre, le Jeudi de la Grande et sainte Semaine avant la Pâque du Seigneur, « l’Office de l’Huile Sainte » connu sous le nom Huile des Pénitents ou Sacrement de l’Extrême Onction. Il est composé d’un grand nombre de lectures néotestamentaires (7 passages de l’Evangile et 7 passages des Epîtres), un matériau psalmique (2 psaumes, en plus de différents versets) ainsi que des hymnes et prières liturgiques (7 prières) composées avec des références bibliques. L’article est réparti en plusieurs paragraphes. Après un aperçu historique de l’office grâce à différents manuscrits du grand Eucologue et la place importante du Nouveau Testament, on aborde le rôle guérisseur de l’huile partant de l’Epître de Jacques, les guérisons évangéliques référées dans l’Office, le rôle de l’Eglise et des prêtres dans l’administration du Sacrement, avec un dernier paragraphe à propos de la grâce de la guérison octroyée par Dieu Lui-même. En conclusion, on propose que l’actualisation de la guérison s’effectue en une réponse ecclésiale sur l’importance de la place de la Parole de Dieu, l’effet de la foi du pénitent et par là la rémission des péchés. Ainsi, la Parole Divine, proclamée à la communauté croyante, pénitente et ecclésiale donne à la guérison une nouvelle dimension : restauration de tout l’être humain par le Christ ‘guérisseur de l’âme et du corps’.
Mots Clés: L’Huile Sainte – Le Nouveau Testament – La Liturgie – L’Eglise – La guérison – le Christ.
المتروبوليت نيقولا أنتيبا: النَّائب البطريركيُّ العامُّ في دمشق منذ العام 2018. تُوِّج أسقفًا في العام 2013 في دير المخلِّص، صربا، لبنان. خدم في الولايات المتَّحدة الأميركيَّة وأوروبا وسوريا ولبنان. درس اللَّاهوت واللُّغات الحيَّة والقديمة وغيرها في إيطاليا، كما أعطى دروسًا في جامعاتٍ لبنانيَّة وفرنسيَّة. له مقالاتٌ في مجلَّاتٍ عربيَّة وأجنبيَّة، وعدَّة مؤلَّفاتٍ في اللَّاهوت.


الخلاصة الفلسفيَّة للقدِّيس توما الأكويني
مقالات من أرشيف مجلَّة المشرق
السَّنة السَّابعة عشرة، العدد 2، شباط (1914)
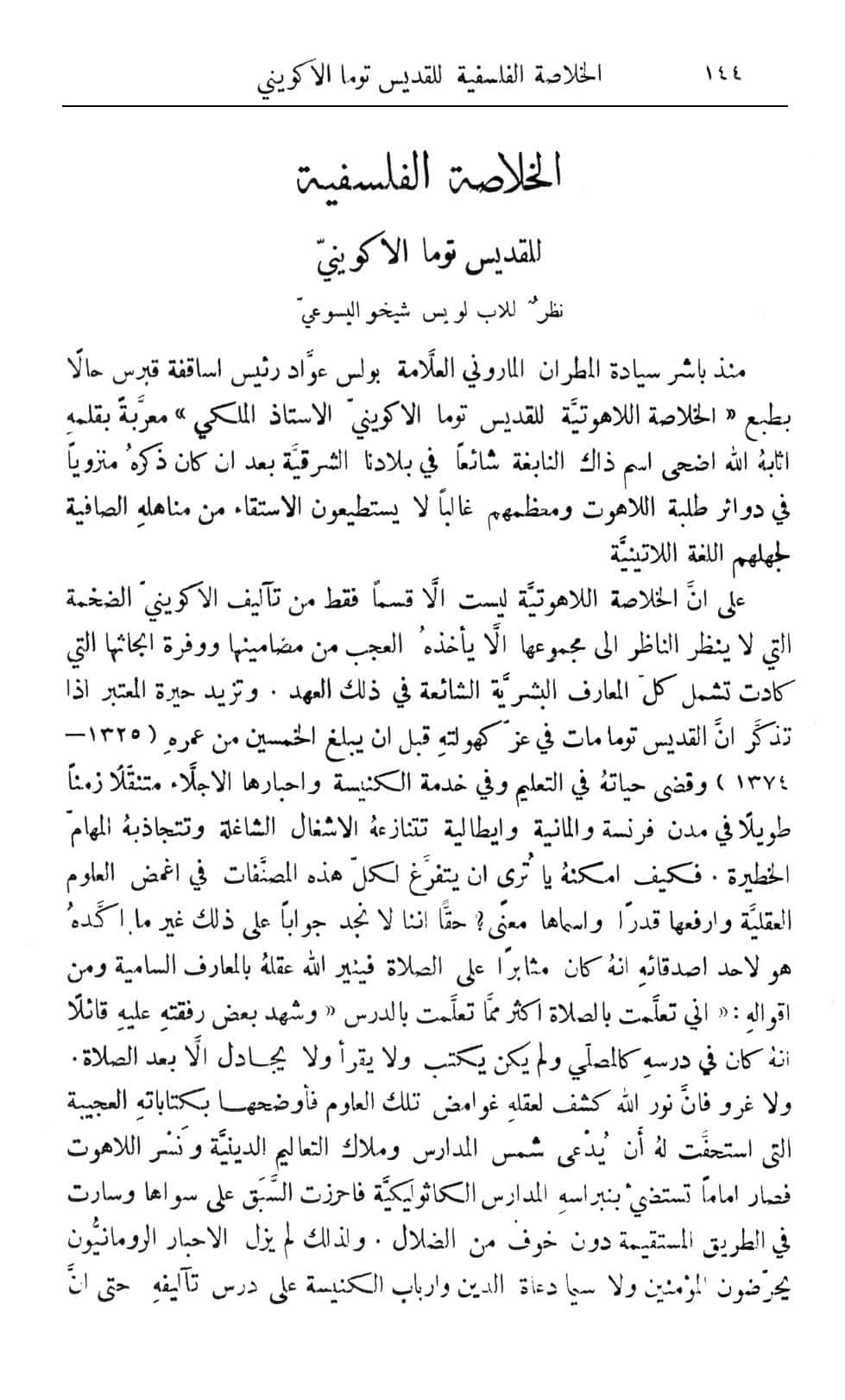
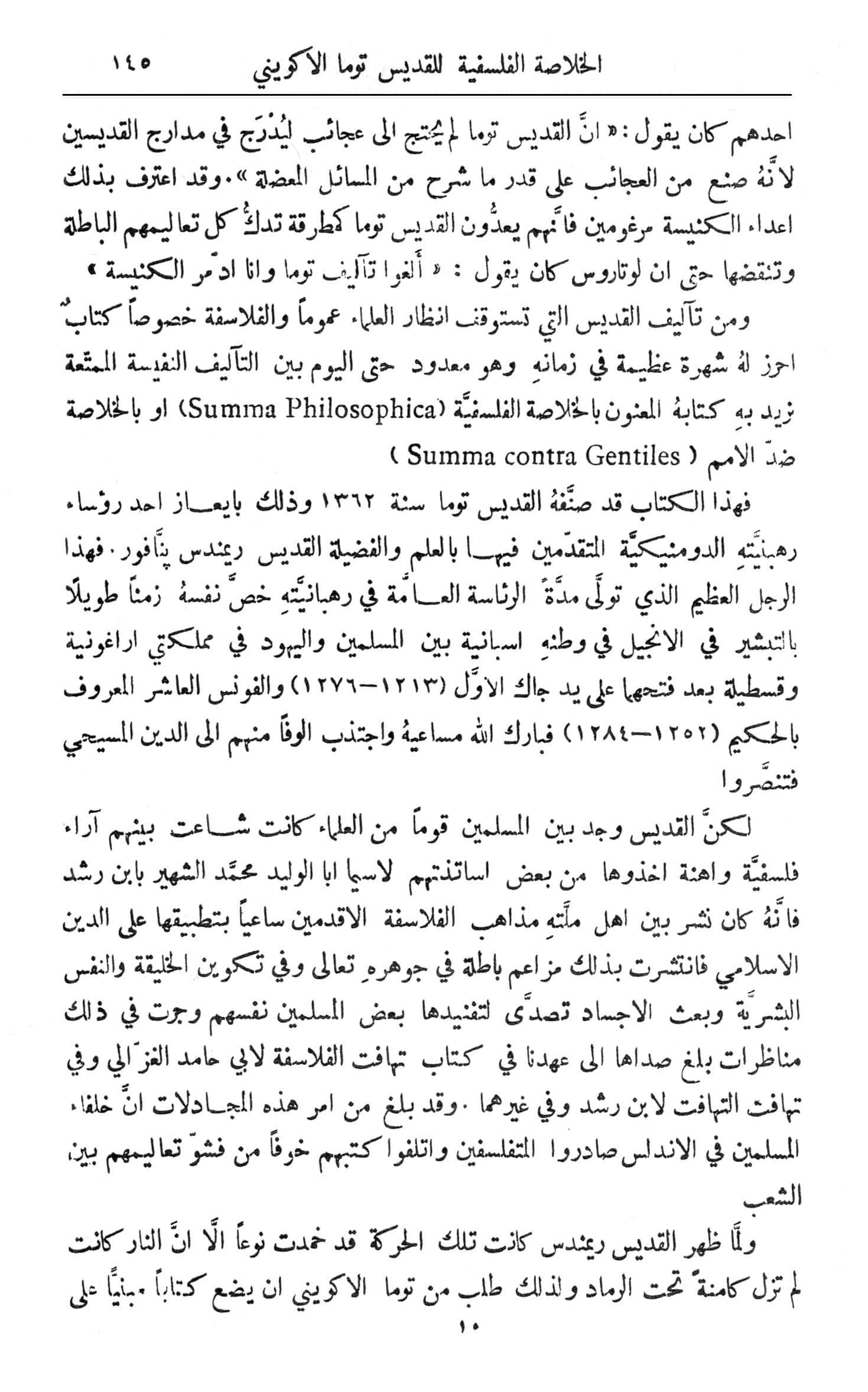
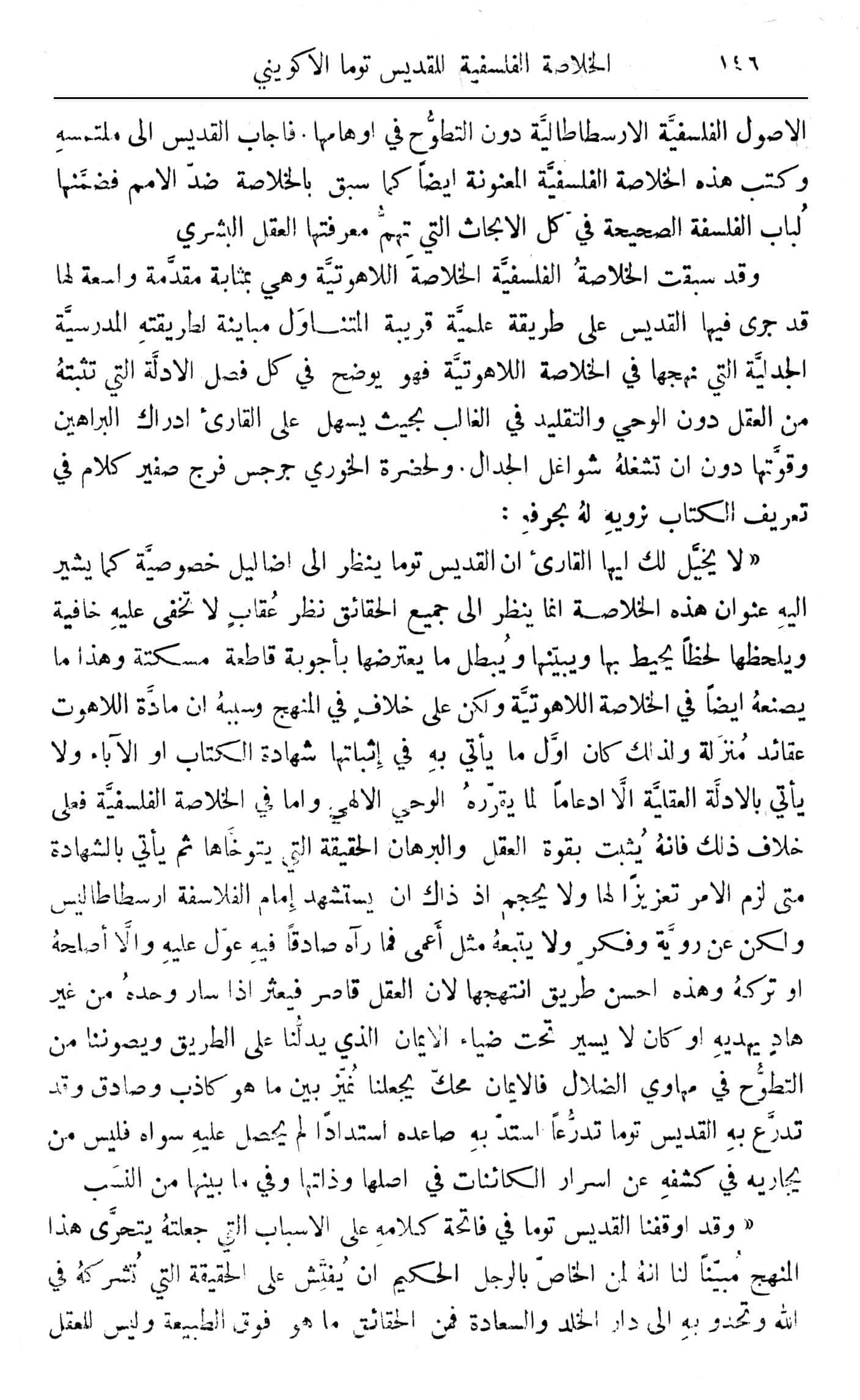
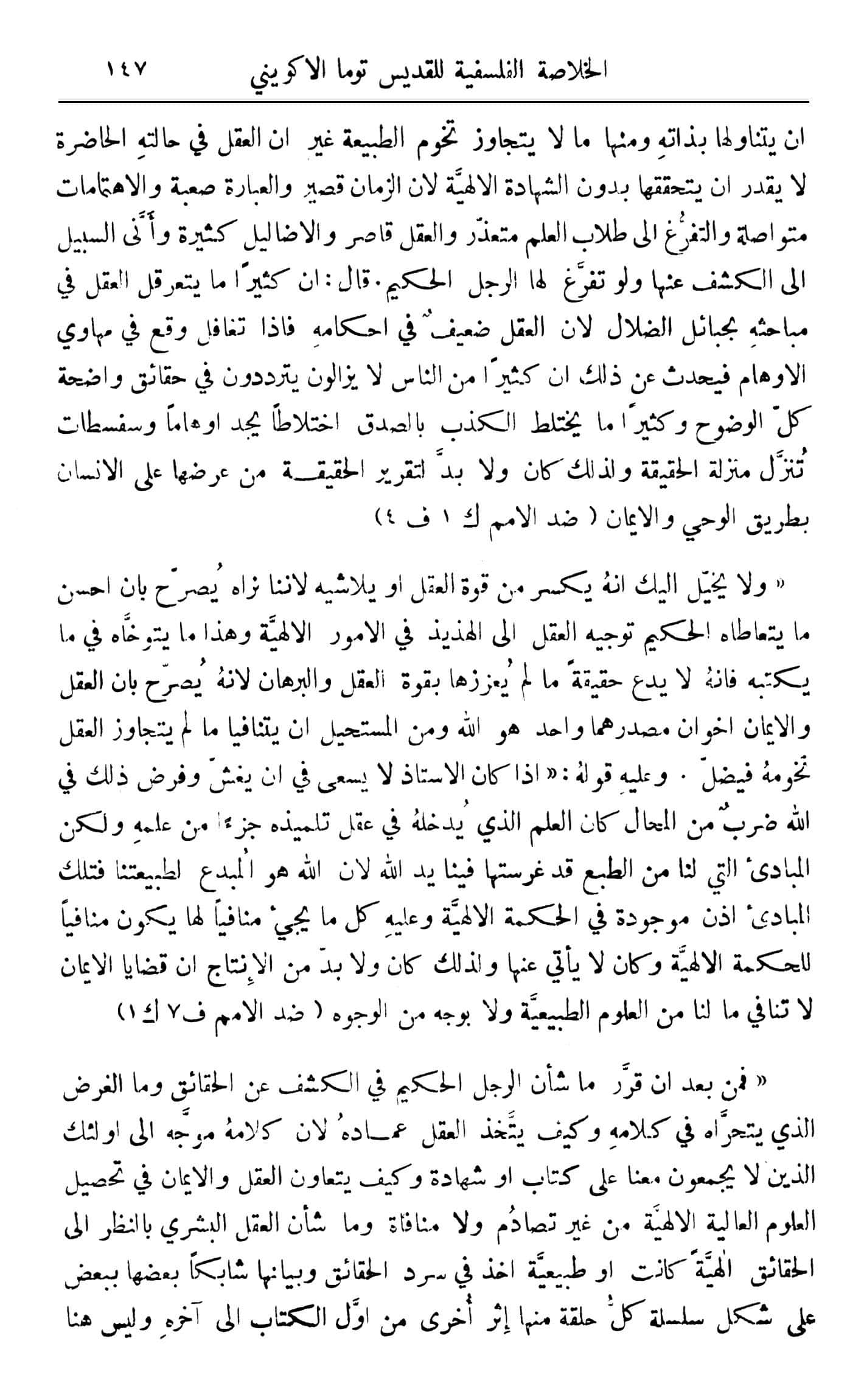
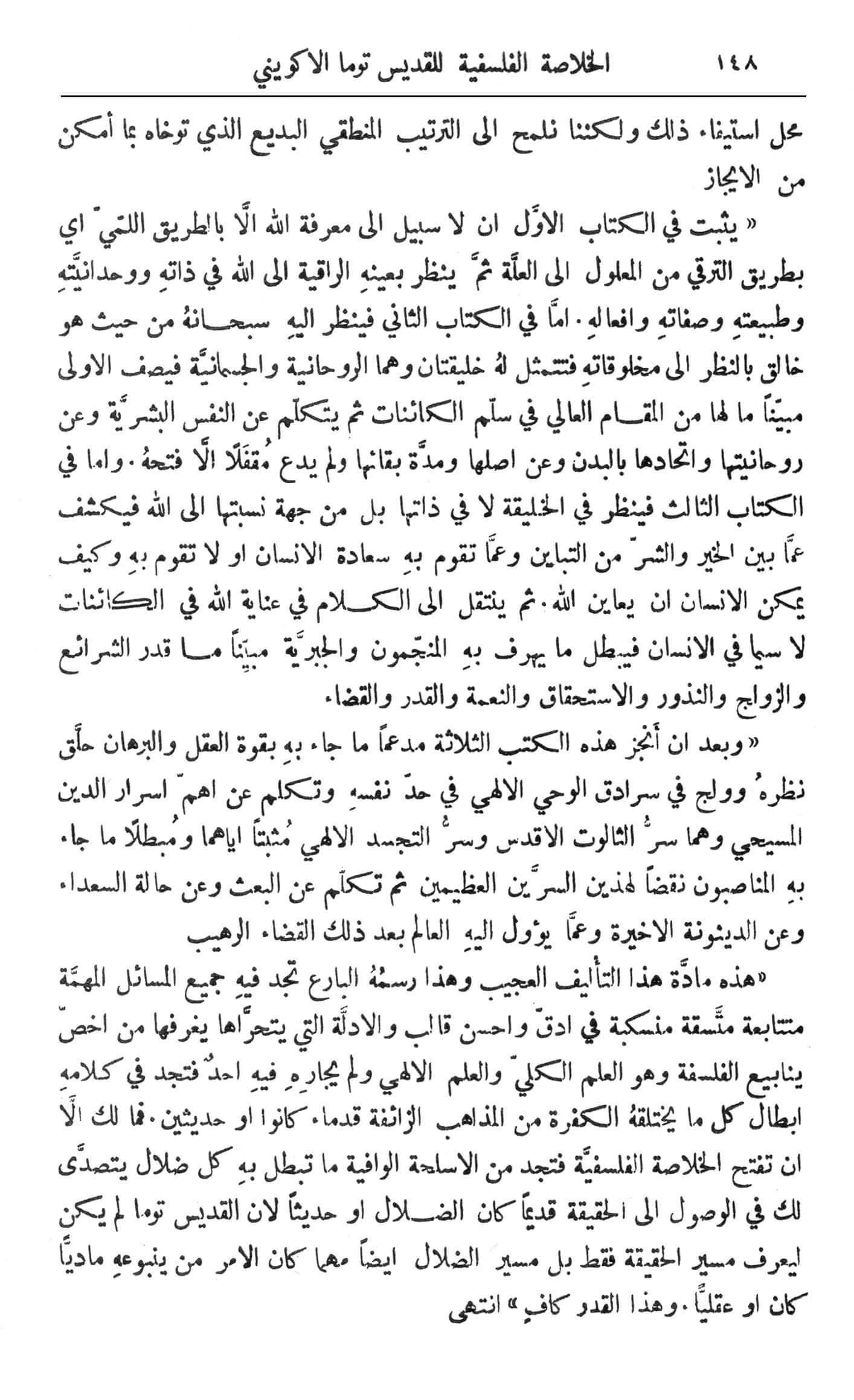
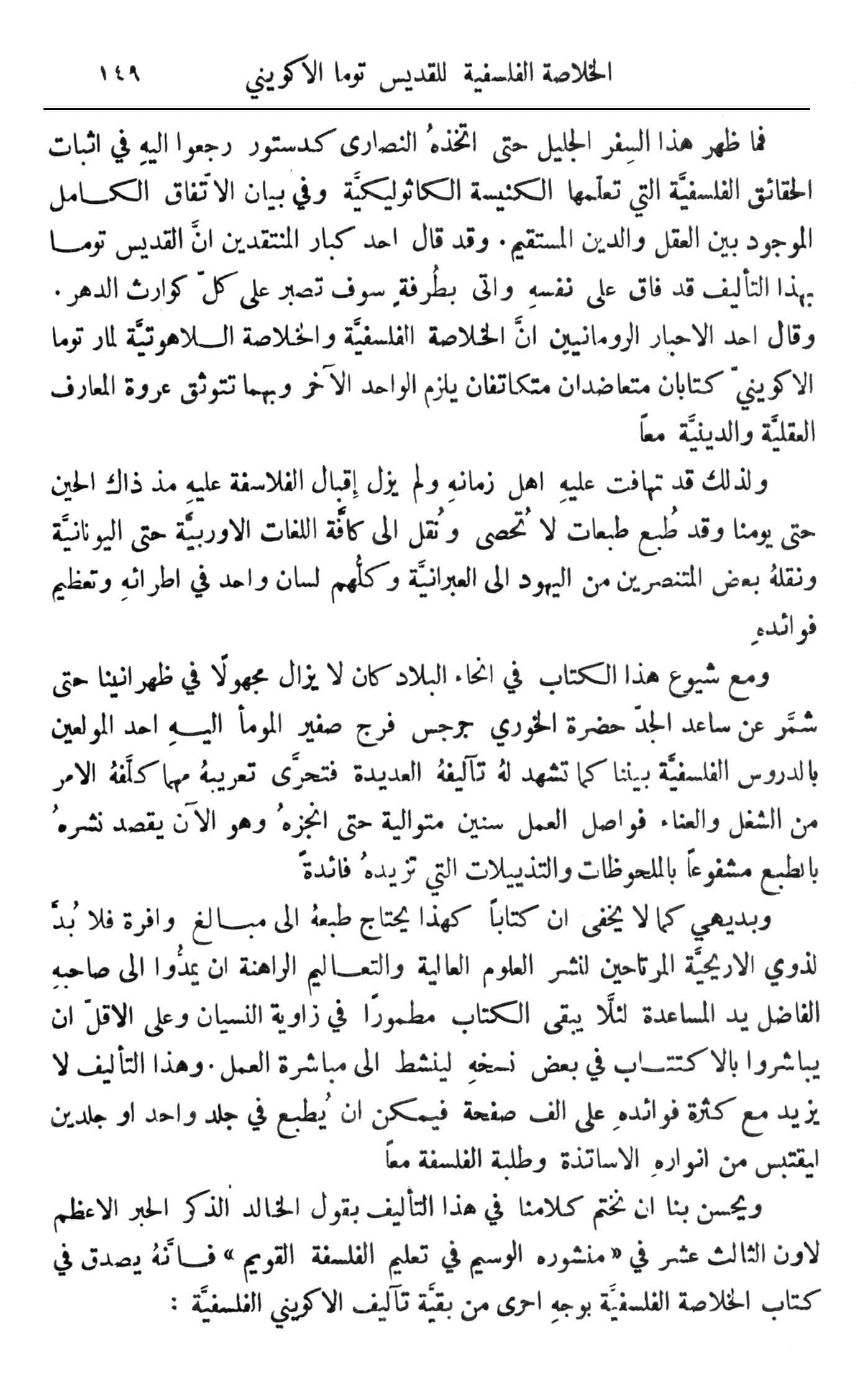
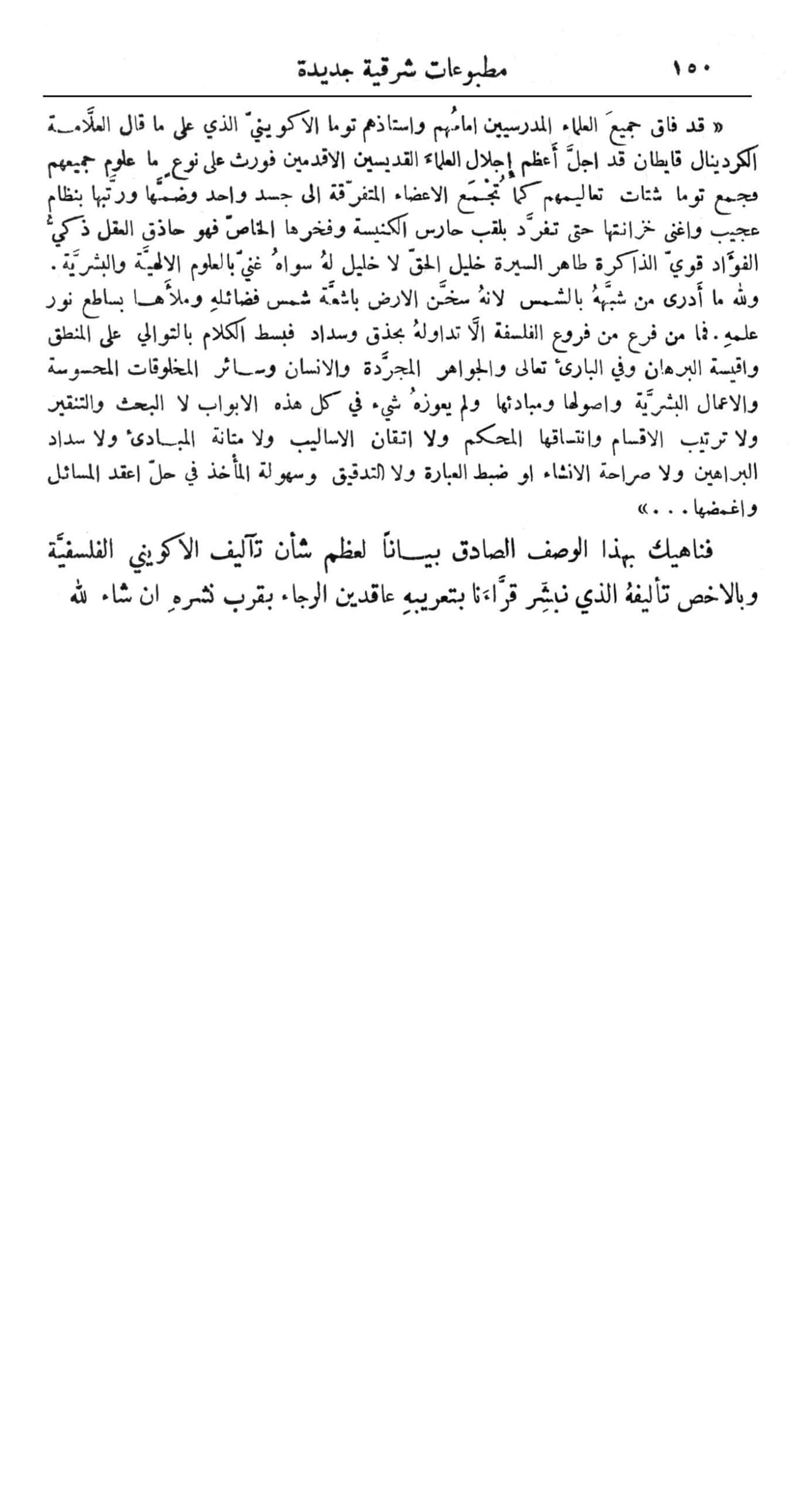


استقلالُ النِّيابة العامَّة وحِيادُها. مقاربةٌ دستوريَّةٌ وقانونيَّة – دراسة مقارَنة
سامر يونس
استقلالُ النِّيابة العامَّة وحِيادُها
مقاربةٌ دستوريَّةٌ وقانونيَّة – دراسة مقارَنة
ط.١، ٦٠٨ ص. بيروت: دار المشرق. ٢٠٢٥.
ISBN: 978-2-7214-8194-8
على يمين القوس…
يقف على يمين قوس المحكمة، قاضٍ، يمثِّل النِّيابة العامَّة، أو قُل يمثِّل مجتمعًا بكامله، بوكالةٍ ما، شعبيَّة. هكذا يفرض الادِّعاء العامُّ هيبته، بل موقعه، في مضبطة الجرائم، فتراه قاسي الملامح، يضرب بحسام القانون، يترافع مفنِّدًا ويعلن استقلاله، حتَّى، وخصوصًا عن المحكمة الَّتي على يساره! وبين يمينٍ ويسار، يُخيَّل إليك أنَّه طرف، لكنَّه في الواقع شديد التَّمسُّك بحياده، أو هكذا يراه، متمرِّدًا في الحقِّ، القاضي سامر يونس في كتابه عن دار المشرق استقلالُ النِّيابة العامَّة وحيادُها. مقاربةٌ دستوريَّة وقانونيَّة – دراسة مقارنة.
هذا الكتاب عنوانُ أطروحةِ دكتوراه في الحقوق، نالها القاضي سامر يونس في العام 2022 بدرجة جيِّد جدًّا من المعهد العالي للدُّكتوراه في الحقوق والعلوم الاقتصاديَّة والإداريَّة في الجامعة اللُّبنانيَّة، مع تنويه اللَّجنة الفاحصة والتَّوصية بنشرها. وها هو دار المشرق يتلقَّف وينشر ويعمِّم الفائدة على مساحة القضاء والمحاماة والأكاديميَّة والبحث العلميِّ. ربَّما لأنَّ المضمون يتخطَّى مجرَّد الكتاب والأطروحة، وربَّما لأنَّ الكتاب هو، فعلًا، عصارة ممارسةٍ وفكرٍ وما بينهما من شخصيَّة المؤلِّف.
من يعرف سامر يونس (أو يعرف عنه) يُدرك تمامًا أنَّ القلمَ، الَّذي خطَّ تأليفًا، يستمدُّ حبرَهُ من شرايينِ حامِلِهِ، وهي الَّتي حَمَلَتهُ إلى القضاءِ رسالةً، لا مجرَّد مهنة. قد أخدُشُ حياءَ أخلاقِه، لا من بابِ مجاملةٍ، لا هو ولا أنا نرتضيها، ولكن لاستحالةٍ عندي أن أفصلَ بين الكاتبِ والكتاب! كلاهُما واحد: في رصانةِ التَّأليف وفي بلاغةِ اللُّغة، في جوهرِ المضمون العميق وفي عمقِ البحثِ الجوهريِّ… كتابٌ في استقلال النِّيابة العامَّة وحيادها؟ كأنِّي بالكاتب، وصفًا!، مستقلٌّ إلى درجة إزعاجِ بعضِ من يهمِسُ في التَّعييناتِ والمناقلاتِ رأيًا، محايدٌ حيث الحياد واجب، إلَّا في الحقِّ، حيث يدفعُهُ عقلُهُ قبلَ قلبِه ليُدافعَ، شَرِسًا، عمَّن نالَهُ ظلمٌ من بني البشر، عندما هؤلاء يَنحدِرون إلى ما دونَ العدلِ، وهو، عنده، خطٌّ أحمر.
ولأنَّ القاضي يونس خدم في القضاء، (نعم، «خدم»)، محاميًا عامًّا في بيروت (كما في قضاء الحكم)، ولأنَّه خَبِرَ الظَّاهر والخفي وواجه بالحقِّ والقانون حالات متنوِّعة من المراجعات، ولأنَّه خرج منها كما دخلها، نقيًّا، مرتاح الضَّمير، فقد خرج أيضًا، وخصوصًا، بخلاصاتٍ ودروس مكَّنته من الجمع بين النَّظريَّة والتَّطبيق. لافتٌ جدًّا قوله، في تمهيد كتابه، إنَّه لم يعرف سوى أن يختار استقلال النِّيابة العامَّة وحيادها عنوانًا لأطروحته، وهو الَّذي شعر أنَّه ينتقل، «داخل القضاء نفسه، من جسمٍ إلى آخر، من روحٍ إلى أخرى، من طبعٍ إلى تطبُّع لم أستطع معه تأقلمًا أو تكيُّفًا»… لقد أعلن الدُّكتور يونس، منذ سطور مؤلَّفه الأولى، انتفاضةً علميَّة على الفصل القائم فعلًا بين «قاضٍ يدَّعي باسم الشَّعب والمجتمع، وآخر يحقِّق أو يحكم باسم هذا الشَّعب أو باسم هذا المجتمع ذاته». سيَّان عنده أكان القضاء واقفًا (قضاء النِّيابة)، أم جالسًا (قضاء حكم)، من حيث الاستقلال والحياد. مقاربةٌ غير تقليديَّة في مضمارٍ طَبَعَهُ التَّقليد، تعبِّر فعلًا عن جرأةِ مَن تولَّاها وحرِّيَّة فكره وصلابة دفاعه عن رؤيةٍ لا تنتمي إلى الموروث في أدبيَّاتنا بشأن النِّيابة العامَّة، يدفعه في ذلك حرصٌ واضح لتحصين القضاء الَّذي ينتسب إليه.
يأخذ القاضي المؤلِّف على واقع النِّيابة العامَّة خضوعها «التَّاريخيّ» لسلطة تسلسليَّة صارمة تقوم على حقِّ الإمرة وإصدار التَّعليمات، ما يهدِّد بتحويل قاضي النِّيابة العامَّة إلى مأمور، ويضرب استقلاله وحياده الواجبَين، وهو الَّذي يُفترض أن يكون محصَّنًا ومحميًّا من أيِّ خضوع أو تبعيَّة، حتَّى ولو تأتَّيا من سلطة تسلسليَّة وموجب «الطَّاعة». هل نسي أحدنا، في تاريخ لبنان الحديث، (ولا تعميم)، كم دخلت السِّياسة على القانون؟ بل على القضاء؟ هل يؤخذ على سامر يونس أن يكون، في بحثٍ علميٍّ رصين، قد ظهَّر، منتفضًا عليه، واقعًا فعليًّا غاب فيه الاستقلال أحيانًا، وحُرم فيه متقاضٍ من حقِّه في حياد النِّيابة العامَّة؟ وهذه الأخيرة هي محامي المجتمع والضَّامنة من أيِّ تعسُّف، أو هكذا يجب أن تكون؟
لقد خاض يونس غمار بحثه متنقِّلًا بين الأنظمة القضائيَّة عبر الحدود، داعمًا رأيه الإصلاحيَّ بأمثلةٍ عبر العالم، متوقِّفًا عند اجتهاد المحكمة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان، الَّتي أدانت افتقار النِّيابة العامَّة الفرنسيَّة لضمانتَي الاستقلال والحياد بسببِ خضوعِها إلى سلطةٍ تسلسليَّة ناجمة عن حقِّ إصدارِ «التَّعليمات الفرديَّة»، الَّتي غالبًا ما تكون شفهيَّة أو هاتفيَّة. وعلى نحوٍ مرتبط، لا يغيب الجانب الدُّستوريُّ عن الكتاب، حيث يذكِّر المؤلِّف أنَّ لبنان قد التزم في مقدِّمة دستوره، (الفقرة باء)، مواثيق الأمم المتَّحدة والإعلان العالميَّ لحقوق الإنسان، داعيًا إلى مواءمة القوانين الوضعيَّة الوطنيَّة والمواثيق الدَّوليَّة، مذكِّرًا أيضًا بالتَّوصيات ذات الصِّلة الصَّادرة عن «مجلس أوروبَّا»، في العام 2000، بشأن المبادىء التَّوجيهيَّةِ لاستقلال النِّياباتِ العامَّة الأوروبيَّة»، كما وتوصيات الأمم المتَّحدة، في شأنِ «المبادئ التَّوجيهيَّةِ المُطبَّقةِ على دورِ قضاةِ النِّيابة العامَّة»، في المؤتمر الثَّامن لمكافحة الجريمة المنعقد في كوبا في العام 1990.
وفي بحثه العميق في مكامن الخلل وفي نقده العلميِّ للمنظومة القانونيَّة الَّتي ترعى النِّيابة العامَّة، لم يكتفِ بعرض الواقع وإظهار ما يعتوِره من اضطرابٍ تراكميٍّ، تشريعًا وممارسة، بل ذهب إلى اقتراح تعديلاتٍ تشريعيَّة تهدف إلى ضبط السُّلطة التَّسلسليَّة بقيود تحول دون التَّعسُّف في التَّعليمات الَّتي تصدر عنها، كأن تكون خطيَّة، لا شفهيَّة. كما يقترح منحَ قاضي النِّيابة العامَّة حقَّ رفض تلك التَّعليمات، في حال كانت تخالِف قناعته! بل أبعد من ذلك، يقترح القاضي يونس إلغاء التَّعليمات الفرديَّة برمَّتِها، لما قد يشوبها من «شبحِ التَّسييس» والإبقاء على التَّعليمات العامَّة والمجرَّدة فحسب «Les instructions générales et abstraites» الَّتي يعود، عندها، للرَّئيس التَّسلسليِّ أن يتَّخذها. يُدافع الكاتب عن اقتراحه بالاستناد إلى ما يشوب ما اصطُلح على تسميته بالقضايا الحسَّاسة وهي، في الواقع، تلك المتعلِّقة بسياسيِّين أو بشخصيَّاتٍ عامَّة أو باعتباراتٍ ماليَّة – اقتصاديَّة.
يصرُّ القاضي سامر يونس في كتابه – المرجع على النَّظر إلى قاضي النِّيابة العامَّة على أنَّه خصم شريف في الملاحقة، منزَّه عن أيِّ موقف شخصيٍّ أو تبعيَّة، موضوعيٌّ، مهنيٌّ، شفَّاف ومتجرِّد، وُجهته الحقيقة، سواء ذهبت في اتِّجاه المدَّعي الشَّخصيِّ أم في اتِّجاه المشتبه فيه أو المدَّعى عليه أو المتَّهم. وفي السِّياق، يقترح إمكان تنحِّي قاضي النِّيابة إذا ما استشعر ظرفًا يهدِّد استقلاله وحياده.
هذا الحياد وذاك الاستقلال يحملان الكاتب، بجرأته المعهودة، على الدَّعوة إلى إصلاح قانونِ أصولِ المحاكماتِ الجزائيَّة اللُّبنانيِّ وتعديله، لا سيَّما في الشِقِّ المتَّصلِ منه بصلاحيَّاتِ النَّائب العامِّ التَّمييزيِّ، وحيث «إرادةٌ «غيرُ لبنانيَّة» قد شوَّهت، ولو بأدوات لبنانيَّة، ما كان يجب أن يكون عليه القانون المذكور.
وإلى الإصلاحات التَّشريعيَّة، يدعو القاضي سامر يونس إلى مناقبيَّة قضائيَّة تتخطَّى التِّقنيَّات. إنَّ التِّقنيَّات تُكتسب، أمَّا المناقبيَّات، فيخشى عليها من اهتمام لا يوليها دورها في تحصين القضاء. ربَّما تكون أحكام مشروع تنظيم القضاء العدليِّ واستقلاليَّته، الَّذي أقرَّه مجلس الوزراء بعد طباعة الكتاب، جزءًا مساهمًا في اتِّجاه عمليَّة التَّدريب المستمرِّ، إلَّا أنَّ الكاتب يعبِّر، مرارًا، عن ضرورة إصلاح نظام النِّيابة العامَّة وأحكامها التَّشريعيَّة، على اعتبار أنَّ هذه الأخيرة تبقى، هي، ضامنة الحقوق وحارسة الحرِّيَّات وحامية المجتمع، ومن دونها تبقى دولة الحقِّ مجرَّد مأمول، بما يذكِّر بالتَّرجمة غير الموفَّقة لـ «Etat de droit» بدولة القانون، فيما الحقُّ يعلو، كمفهوم مطلق، أمَّا القانون فمن صنع بني البشر وأهوائهم ومصالحهم.
بقَلَمِه المميَّز بذاته والموروث جينيًّا من والده الأديب الدُّكتور دياب يونس، يكتب القاضي والأستاذ الجامعيُّ عن مؤلَّفه: «هذا كتابٌ يُخاطبُ أرواحًا متمرِّدة وأجنحةً لا تنكسر». جبرانيَّات تذكِّر بأنَّ مغامرة سامر يونس الكتابيَّة الغنيَّة هي تعبيرٌ عن أجمل «الأرواح المتمرِّدة» ديمقراطيًّا وعلميًّا في كنف القضاء، ترفدُ «التَّائه» في «العواصف» القضائيَّة بأجنحةٍ تنقل السُّلطة الحامية والضَّامنة إلى ما يجب أن تكون: مستقلَّة وحياديَّة، من أجل النَّاس، كلِّ النَّاس. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وقد أحسن القاضي المؤلِّف خطواتٍ كثيرة، نيابةً عامَّةً عن أصحاب رأيٍ وعن أصحاب حقٍّ.
الدُّكتور زياد بارود : محامٍ بالاستئناف، ومحاضر في جامعة القدِّيس يوسف، ورئيس مجلس أمناء جامعة سيِّدة اللُّويزة. خدم وزيرًا للدَّاخليَّة والبلديَّات في حكومتَين متتاليتَين بين تمُّوز ٢٠٠٨ وحزيران ٢٠١١، وحازت الوزارة في أثناء ولايته المرتبة الأولى في جائزة الأمم المتَّحدة للخدمة العامَّة. بعد انتهاء خدمته الوزاريَّة، عُيِّن رئيسًا للَّجنة الخاصَّة باللَّامركزيَّة الإداريَّة الَّتي وضعت مشروع القانون الَّذي يناقشه مجلس النُّواب. له مؤلَّفات في الدُّستور واللَّامركزيَّة وقوانين الجمعيَّات والهيئة التَّعليميَّة.


Être et existant
Antoine Daher
Être et existant
ط.١، ١٨٠ ص، بيروت: دار المشرق، ٢٠٢٥
ISBN : 978-2-7214-1222-5
إنَّ المؤلِّف هو الطَّبيب المرموق والإنسانيُّ أنطوان ضاهر. وهو المحاضِر المتمرِّس في كلِّيَّة الصِّحَّة في الجامعة اللُّبنانيَّة. إلى جانب عمله، أكبَّ على مطالعة الأدب والفنِّ والفلسفة، وتدوين الخواطر الَّتي انبثقت من وجدانه، وعندما بلغ مرحلة التَّقاعد، شرع بتنظيم تلك الأفكار والتَّأمُّلات، فنُشرت بعد أعوامٍ ثلاثة على وفاته في دار المشرق، بفضل جهود ابنته السَّيِّدة دنيز ضاهر بستاني.
يتألَّف الكتابُ من قسمَيْن: الأوَّل (ص. ١٧-١١٠)، وعنوانه «الكائن». توسَّعَ فيه المؤلِّفُ بالكائن البشريِّ الحيِّ، الواعي، الاجتماعيِّ، الأخلاقيِّ، العاطفيِّ والمُفكِّر، وتطرَّق إلى إشكاليَّاتٍ عديدة كالحرِّيَّة، الحقِّ، الجسد، الأبديَّة، العدم، العالَم، الخلق والفكر. وفي الثَّاني (ص. ١١١-١٦٥)، وعنوانه «الموجود»، توقَّفَ عند ملفَّاتٍ ثلاثة: التَّصرُّف (أو العمل)، الجماليَّة، والموت. نعرض للقرَّاء ملفًّا مقتضبًا في القسمَين، ليستطيعوا اكتشافَ شيء من مقاربات الدُّكتور ضاهر الفلسفيَّة وآرائه:
– الكائنُ الأسمى (ص. ٧١-٧٧): سأل الكاتبُ عمَّا إذا كانت فكرة الله فطريَّة أم نتيجة الاستدلال المنطقيِّ؟ بدا له أنَّ الإنسان آمن بالألوهة منذ فجر التَّاريخ، فسجد للمخلوقات الَّتي استحسنها واستهابها، ثمَّ للآلهة الَّتي نسجها خياله، وأخيرًا للإله الواحد القدير والأبديِّ، مستطردًا إلى التَّباعدات والتَّناقضات بين أنبياء الدِّيانات المختلفة ورسلها، فنصح باختيار التَّعاليم الأقرب إلى الطَّهارة والنُّبل، رافضًا سعيَ الفلاسفة إلى إثبات وجود الله من طريق المنطق البشريِّ، فالإنسانُ يختار سلوك طريق الإيمان، ليس امتثالًا لبراهين عقليَّة، بل بعد عجزه عن تفسير دواعي الخلق، وقناعته بأنَّه لا يمكن أنْ يفتقر الوجودُ إلى المعنى.
– التَّوق إلى الجماليَّة (ص. ١٤٩-١٦٠): يُحسُّ المرءُ بالجمال ويعبِّر عنه غرائزيًّا، فإذا به يعبُر إلى عالم التَّأمُّل والإعجاب والتَّأثُّر الممتع. الفنُّ الأصيل لا ينسخ الواقعَ، بل يحكم عليه، كما أنَّه ينقل الإنسانَ التَّوَّاق نحو آفاقٍ مجهولة بعيدة عن الرَّتابة والحزن، ولذلك لا يعود هذا الإبداع مُلكًا شخصيًّا.
في المقدِّمة، أكَّد المؤلِّفُ أنَّه لا يحترف الفلسفة، بل هو مراقبٌ تمعَّنَ في البشر والوجود، وطبيبٌ فكَّر في المعنى بعد أن شاهد معجزة الجسم البشريِّ واحتكَّ بالموت (ص. ١٣). هدَف إلى إشراكنا في قناعاته الَّتي توصَّل إليها من خلال مسيرته واختباراته وقراءاته، علَّها تحثُّنا على الرَّغبة في الإجابة عن التَّساؤلات. فالإنسان «الَّذي وُجد مُرغمًا، باحثًا بلا كللٍ عن ذاته الهاربة منه، مدركًا أنَّه ضيفٌ في كيانه، راغب بإلحاحٍ بأن يصبح مالكًا ذاتَه» (ص. ١٧١).
أختم بفقرةٍ من الكتاب يتناول فيها الإيمان بالله : «من الثَّابت أنَّ الله حاضرٌ في اللَّاوعي الجماعيِّ. إنَّ الكسب من السُّجود له والإيمان به يفوق أضعافًا مُضاعفة ضرورةَ إثبات وجوده. فالله يظلُّ، بالنِّسبة إلى كثيرين، الحلَّ البسيط، السَّهل والمثاليَّ لإشكاليَّة الوجود. هو الَّذي خلق الكائنات، ومنحَها المعنى، ووجَّه مصيرَها. هو الدَّواءُ الشَّافي والملاذ الأخير عند الموت. هو أساسُ العدل والأخلاق والنِّظام الاجتماعيِّ. ينتج إيمانُنا به من عجزنا عن تفسير كلِّ ما يحيط بنا، ومن حاجتنا إلى عونه، ومن إملاءات عقلنا» (ص. ٧٦).
الأب غي سركيس : حائز درجة الدُّكتوراه في اللَّاهوت من الجامعة اليسوعيَّة الغريغوريَّة الحبريَّة (روما). أستاذ محاضر في جامعتَي القدِّيس يوسف، والحكمة. وهو كاهن في أبرشيَّة بيروت المارونيَّة. له مجموعة من المؤلَّفات الدِّينيَّة والتَّأمُّليَّة والفكريَّة في اللَّاهوت المسيحيِّ، وحوار الأديان والحوار الإسلاميِّ- المسيحيِّ، وبعضها من إصدار دار المشرق (نوبل للسَّلام… لمن؟، أؤمن… وأعترف، قراءة معاصرة في الإيمان المسيحيِّ، وإيمان في حالة بحث – النَّشاط اللَّاهوتيّ في المسيحيَّة، ودروس من الهرطقات، والبابا فرنسيس، صاحبُ الفطنة والسَّذاجة، جولةٌ في فكره اللَّاهوتيِّ).


البابا فرنسيس، صاحبُ الفطنة والسَّذاجة جولةٌ في فكره اللَّاهوتيّ
الأب غي سركيس
البابا فرنسيس
«صاحبُ الفطنة والسَّذاجة»
جولةٌ في فكره اللَّاهوتيِّ
ط.1، 180 ص. بيروت: دار المشرق، 2025.
ISBN: 978-2-7214-5681-6
تذخر المكتبة المسيحيَّة العربيَّة بكثير من التَّرجمات بشأن البابا الرَّاحل فرنسيس سواء في كتاباته أو عنه، لكنَّ ما كان ينقص مكتبتَنا المسيحيَّة نظرة مشرقيَّة عربيَّة أعمق في فكر الحبر الأعظم ولاهوته… وقد تمعَّن الأب غي سركيس، بحسِّه الرَّعويِّ وتعمُّقه اللَّاهوتيِّ، في هذه الرِّسالة، فقدَّم إلينا كتابًا هو من روح أسلوب البابا عينه، أي جذِلًا وبسيطًا وعميقًا، يأخذنا في «جولة» كما وعدنا، لا في فكر البابا اليسوعيِّ وحسب، بل في قلبه حيث كنزُه.
يُقال إنَّ «المكتوب يُعرف من عنوانه»، وهذا الكتاب يُعرف من مقدِّمته… فنستشفُّ مستوى الكتاب التَّحليليَّ الَّذي لا يستعرض المعلومات الدَّقيقة فحسب، بل يحلِّلها لاهوتيًّا وكنَسيًّا وكأنَّك، فعلًا، تدخل في عمق شخص البابا فرنسيس، وتعرف ما وراء المعلومة. يقدِّم الكاتب، ويشرح، ويحلِّل كلَّ مصطلح، فيبدِع، بطريقته التَّربويّة، في تعريف القارئ العربيِّ بما يمكن الإحاطة به فيما يخصُّ هذا البابا المميَّز.
وفي عالم يسهل الوصول فيه إلى المعلومة، يمكن القارئ أن يقع في فخِّ الكمِّ والسَّطحيَّة. لذلك، أصاب المؤلِّف في اختياره منهجيَّة كتابه، حين تناول رسائل البابا العامَّة وإرشاداته الرَّسوليَّة، وهي كثيرة وغنيَّة. لقد قدّم مضمون الوثيقة وتوجُّهاتها، معتمدًا أوَّلًا توضيح سبب اختيار البابا الموضوع، فمستخلِصًا العِبر للواقع المشرقيِّ العربيّ.
من هنا يبرز غنى هذا المؤلَّف بما يخصُّ كنيستنا… فالبابا فرنسيس يتوجَّه إلى العالم أجمع، وقد صدر معظم الوثائق باللُّغة العربيَّة، لكن، يبقى الرَّاعي هو من يؤدِّي دور الجسر الَّذي يصل المؤمنين بالكنيسة الجامعة، وهذا ما تصدَّى له الكاتب حين قدَّم الفكر الفرنسيسيَّ إلى مؤمنِي الشَّرق، موجِّهًا خطاهم في رحلة بحثهم الإيمانيَّة الشَّخصيَّة عن معنى وجودهم ورسالتهم في المشرق العربيِّ.
يشبه تقسيم الكتاب تقسيمات متاحف روما. فقد تختار زيارة جناح من دون غيره. وقد تختار التَّعمُّق والتَّذوُّق في غرفة، أو في عملٍ فنِّيٍّ على حساب آخر، كما في الكتاب الَّذي بين أيدينا، والَّذي لم يقسِّمه الأب سركيس التَّقسيم التَّقليديَّ، ولا جعله في أجزاء متسلسلة، بل اختار أسلوبًا مبسَّطًا في تناوله الموضوعات الأساسيَّة في فكر البابا والَّتي تعكس وثائقه المهمَّة: «البشارة، البيئة، العائلة، القداسة، الشَّبيبة، الانثقاف، الأخوَّة العالميَّة، المحبَّة المسيحيَّة، السِّينودسيَّة، كرامة الإنسان». وكأنَّ الكتاب موسوعة فرنسيسيَّة مصغَّرة، يمكن العودة إليها في كلِّ مرَّة يرغب فيها القارئ في التَّعمُّق في فكر البابا سواء أكان كاهنًا، أو خادمًا في كنيسة، أو باحثًا، أو مربِّيًا للتَّعليم المسيحيِّ… فهو يُناسب الجميع بأسلوبه المنهجيِّ العميق.
زيَّن الكاتب صفحات هذا المؤلَّف باقتباسات من النُّصوص الأصليَّة نفسها، وذيَّلها ببعض الأسئلة الَّتي تدعو المؤمنين والمؤمنات إلى التَّفكير في هويَّتهم المسيحيَّة المشرقيَّة، وماذا يعني اتِّباع المسيح اليوم؟
في الختام، لعلَّ القيمة المضافة لهذا الكتاب، هي في كونه يحثُّ القارئ على التَّفكير، ويجعله أقرب إلى منهج البابا «الكيميائيِّ»، الَّذي يجمع الحقائق ويفاعلها بعضها بعضًا ليُظهر حقيقة مبتكرة وأعمق.
الأب طوني حمصي اليسوعيّ : مدير التَّواصل الرَّقميِّ للرَّهبانيَّة اليسوعيَّة في الشَّرق الأدنى والمغرب العربيِّ. مشرف على النَّسخة الرَّقميّة للكتاب المقدَّس باللُّغة العربيَّة في ترجمته الكاثوليكيَّة. حائز شهادة ماجستير في اللَّاهوت الكتابيِّ – كلِّيَّة اللَّاهوت اليسوعيَّة – باريس، ودبلوم جامعيٍّ في الصِّحافة الرَّقميَّة، جامعة القدِّيس يوسف – بيروت. له العديد من التَّرجمات الصَّادرة عن دار المشرق.


المسيحيُّون الأوائل – الجزءان الأوَّل والثَّاني
ريمون رزق
المسيحيُّون الأوائل
ط.1، ج.1، 304 ص.؛ ج.2، 504 ص. بيروت: دار المشرق. 2024
(ج.1) ISBN: 978-2-7214-5676-2
(ج.2) ISBN: 978-2-7214-5677-9
صدر عن دار المشرق مجلَّدان عن تاريخ الكنيسة بعنوان المسيحيُّون الأوائل. ويبدو أنَّها سلسلة ستتضمَّن سبعة مجلَّدات، بحسب ما ورد في المقدِّمة.
الجزء الأوَّل
يهتمُّ الجزء الأوَّل بالقرن الميلاديّ الأوَّل، من القيامة إلى تدمير أورشليم (30-135).
الفصول الثَّلاثة الأوَل، من هذا الجزء، تعتمد اعتمادًا شديدًا على ما ورد في العهد الجديد لتتوسَّع فيه، من خلال اكتشافات التَّنقيبات الأثريَّة، وتصف لنا طبيعة حياة المسيحيِّين في القرن الأوَّل، وخصوصًا أماكن العبادة الَّتي ارتادوها.
الفصلان الرَّابع والخامس مخصَّصان للصَّلوات. التَّمهيد يبدأ بالفصل الرَّابع حيث يُشار إلى محوريَّة المسيح في الصَّلوات، ويعرض الفصلُ الخامس نماذج للصَّلوات. وبسبب شحِّ النُّصوص الَّتي أتتنا من تلك الفترة، يعتمد الكاتب كثيرًا على الصَّلوات الَّتي وردت في العهد الجديد، ويرى فيها نماذج للصَّلوات المسيحيَّة في ذلك الوقت.
بعرضٍ موجزٍ ووافٍ، يتناول الفصل السَّادس التَّعاليم والكتابات المسيحيَّة، بمعنى تشكُّلِ كتب العهد الجديد التَّدريجيّ، ويليه الفصل السَّابع المخصَّص للحياة التَّقويَّة والأسرار. وحيث إنَّنا في بدايات الكنيسة، لا يُطرَح هنا سوى سرَّين: الإفخارستيَّا أوَّلًا والمعموديَّة ثانيًا؛ وترتيب الطَّرح يأتي من أهمِّيَّة دور السِّرّ في الجماعة المسيحيَّة الأولى لا من تسلسل منحه الكرونولوجيّ. يُضاف إلى هذَين السِّرَّين واجب العناية بالفقراء وكأنَّ الكاتب يضعه في مرتبة السِّرِّ لجوهريَّته في الإيمان المسيحيّ (في الجزء الثَّاني سيطلَق عليه اسمُ السِّرّ).
الفصل الثَّامن يعرض «نسيج الجماعات المسيحيَّة الاجتماعيّ». اللَّافت في هذا الفصل هو المساحة الَّتي يخصِّصها الكاتب للمرأة ودورها في الكنيسة الأولى، وهي أكثر من نصف الفصل. هذا الدَّور انحسر تدريجيًّا مع تقدُّم العصور.
تتتالى بعد هذا الفصل الموضوعاتُ المعهودة: شخصيَّات بارزة من القرن الأوَّل، ويتمُّ الإلحاح على عرض فكرها أكثر منه عرض بيوغرافيَّتها. وعلى الرُّغم من أهمِّيَّة شخصيَّات الرُّسل، اختار الكاتب ألَّا يذكرها هنا، وقد أحسن في فعله ذلك، إذ يتميَّز الكتاب بعرض ما يُعتقَد أنَّه جديد على القارئ العاديّ، والحال، فإنَّ شخصيَّات الرُّسل معروفة لدى الجميع. يلي ذلك فصل يعطي لمحة موجزة عن الاضطهادات، ويليه آخر عن الهرطقات، ليُختتَم الكتاب بخلاصةٍ وخاتمة.
الجزء الثَّاني
يتناول الجزء الثَّاني القرنَين الثَّاني والثَّالث الميلاديَّين (136-260)، ويحمل العنوان الفرعيّ: «من بداءة الأدب المسيحيّ إلى الاضطهاد». يبدأ هذا الجزء بفصل قصير جدًّا هو بمثابة مقدِّمة تُعرَض فيها مكوِّنات الجماعة المسيحيَّة في تلك الفترة. يليها فصلان طويلان ومهمَّان: الأوَّل، ودائمًا في تلك الفترة، عن «الوجوه المسيحيَّة في الشَّرق»، والثَّاني عن «الوجوه المسيحيَّة في الغرب وأفريقيا».
بطريقة موسوعيَّة، يقدَّم كلُّ وجه بإيجاز، وتُعرَض أفكارُه والقضايا الَّتي تناولها. بعض الوجوه معروفة ولها كتب بالعربيَّة تتكلَّم عليها، وبعضها الآخر غير معروف. ولأسبابٍ صائبة، ركَّز فصل الوجوه الشَّرقيَّة على رجال الفكر وليس على البطاركة، في حين أنَّه تخطَّى، في الوجوه الغربيَّة، هذه القاعدة، وذكر باباوات روما من بين الوجوه، مع أنَّ عددًا منهم لم يشتهر بأعماله الأدبيَّة ولا بقراراته. السَّبب، برأيي، هو أنَّ قرارات مهمَّة اتَّخذها باباوات كنيسة الغرب حينها كان لها أثر في المسيحيَّة عامَّةً، ولذلك توجَّب أن يُشار إليهم. وإذ يخرج عن هذا المعيار واحدٌ أو اثنان منهم، ارتأى الكاتب، وهو على حقٍّ، أن يضع القائمة كاملةً من أجل الفائدة. لذلك راعى ذكرهم في فئةٍ واحدة، مع نبذة قصيرة عن كلٍّ منهم.
الفصل الرَّابع عرضٌ شامل لأبرز النُّصوص المسيحيَّة المنحولة، مع تحليل كافٍ لمضمونها ليكوِّن القارئ فكرةً عنها. في هذا الفصل نجد ذكرًا لكلِّ الكتب الَّتي أرادت أن تتشبَّه بأسفار العهد الجديد، سواء الأناجيل أو الرَّسائل أو أعمال الرُّسل، الَّتي تُعرَف اليوم بالكتابات الأبوخريفيَّة.
الفصل الخامس يتناول باقتضابٍ مريح ما تميَّزت به تلك الفترة: الانتشار المسيحيّ. أمَّا الفصل السَّادس فيعيد ما ورد في الجزء الأوَّل عن الكنائس البيتيَّة، مشيرًا إلى سِماتها في القرن الثَّاني. إنَّها لم تعد بيوتًا للسَّكن بل صارت بيوتًا خضعت هندستها للتَّعديل لتلبِّي حاجة العبادة. نحن أمام بدايات ما سيسمَّى: الكنيسة.
وعلى خُطى الجزء الأوَّل، تأتي فصولٌ تتكلَّم على الصَّلوات في ذلك العصر، والأسرار الَّتي بدأت تأخذ طابعًا ليترجيًّا. هنا أيضًا نجد عرضًا لسِرَّي الإفخارستيَّا والمعموديَّة، يتوسَّطهما «سرُّ خدمة القريب»، أي الاهتمام بالمحتاجين، ويضاف إلى الثَّلاثة سرٌّ جديد هو سرُّ المصالحة. ولأنَّ شروط منح المعموديَّة بدأت تتوضَّح، أفرز لها الكاتب فصلًا قصيرًا (الفصل العاشر) يعرض تحضير الموعوظين لنَيل هذا السِّرّ، يليه آخر قصير أيضًا عن الأخلاق المسيحيَّة .
التَّنظيم الكنسيّ، أو الهيرارخيَّا، الَّذي بدأ يتَّضح، معروضٌ في الفصل الحادي عشر، تليه علاقة الكنيسة بالدَّولة، وهي علاقة تسبَّبت باضطهاد المسيحيِّين. فيعرض الفصل لمحةً موجزة عن الاضطهادات وبعض الوجوه البارزة للشُّهداء.
تحت عنوان الخلافات الدَّاخليَّة والخارجيَّة، يعرض الفصل الثَّالث عشر جميع الهرطقات الَّتي ظهرت في تلك الحقبة. وبعد ذلك يأتي فصلان يتناولان مسألة الفنِّ الكنسيّ. فقد ظهر هذا الفنُّ في الدَّياميس، وبالتَّالي يتناول الفصلُ الرَّابع عشر موضوع المقابر، ويتوسَّع فيه ليشمل كلَّ الفنِّ الكنسيّ الَّذي بدأ بالظُّهور في تلك الحقبة تعبيرًا عن الإيمان.
نظرة عامَّة
تتميَّز فصول هذَين الكتابَين بأنَّها قصيرة من ناحية الحجم، تتفادى الاستفاضة الممِلَّة، وهي مزيَّنة بالصُّور، ما يجعل القراءة ممتعة حتَّى لمَن ليس متآلفًا مع قراءة الكتب. الملاحظة الَّتي لفتت انتباهنا هي الصُّور المستخدمة. لا شكَّ في أنَّها تضفي أجواء على النَّصِّ، لكنَّها في بعض الأحيان بدت كثيرة نوعًا ما، بحسب رأينا.
الأب سامي حلَّاق اليسوعيّ : راهب يسوعيّ، وأستاذ في جامعة القدِّيس يوسف – بيروت. له مؤلَّفات وترجمات عدَّة منشورة، بالإضافة إلى مقالاتٍ بحثيَّة في مجلَّة المشرق.


الحبُّ… مساحة أمان وتقدير
الحبُّ… مساحة أمان وتقدير
ط.1، 128 ص. بيروت: دار المشرق، 2025
ISBN: 978-2-7214-5678-6
«الحبُّ هو أروع وأنبل شعور يمكن أن يسكن قلبنا، وأجمل كلمة ترنُّ بعمق في وجدان كلِّ إنسان…» (ص. 7). بهذه الجملة، يفتتح المؤلِّف مقدِّمة كتابه، وحيث «نتطلَّع إلى هذه المساحة من الحياة التي تحقِّق أملنا في الحبِّ، وما يعنيه من شعور بالأمان والتَّقدير» (ص. 7).
اعتمد المؤلِّف، الأب نادر ميشيل، في بحثه الأنثروبولوجيِّ هذا، على الإصغاء إلى النَّاس محاولًا فهم ما يعبِّرون عنه وما يعيشونه، فيبدأ، في الفصل الأوَّل، «بتوضيح معنى الأمان والتَّقدير» (ص. 11-12)، متطرِّقًا إلى «مكانة الكلمة» (ص. 16-17) في حياة البشر، ومعنى وجودهم حيث يعيش الإنسان في «جسد مجنَّس»، تشدُّه الرَّغبة نحو الآخر. هنا، يتوقَّف المؤلِّف أمام واقع الإنسان البشريِّ الباحث عن اللَّذَّة والمُعاني من الألم، متلمِّسًا معنى الحياة الحقيقيَّ. «وفي هذا كلِّه نسمع صوت الله الَّذي يتكلَّم في قلبنا ومن داخل واقعنا الإنسانيّ، ويعلِّمنا طريق الحبِّ الحقيقيِّ» (ص. 9).
ثمَّ يورد المؤلِّف «شروط الأمان والتَّقدير في أيِّ علاقة» (ص. 17-19).
في الفصل الثَّاني من الكتاب (ص. 41-67)، وعنوانه «مظاهر عيش الأمان والتَّقدير»، يعرض المؤلِّف بحث الإنسان عن الحبِّ والأمان والتَّقدير في واقع حياته، وطريقة عيشه الرَّغبة ومظاهرها الصَّحيحة وغير الصَّحيحة. وهو، في الاتِّجاهات الأخيرة، يُشير إلى «الانغلاق على الذَّات، والتَّسلُّط والبحث عن القوَّة، والتَّلاعب بالمشاعر، والنِّفاق والتَّملُّق»، حيث إنَّ الإنسان مدعوٌّ دومًا إلى مراجعة ذاته ليعي في أيِّ اتِّجاهٍ تمضي حياته.
في الفصل الثَّالث (ص. 69-88) يقترح علينا الأب ميشيل فتح الإنجيل، والاقتداء بيسوع المسيح في بحثه عن الأمان والتَّقدير، وقد وهبَهما للنَّاس الَّذين يحيطون به. فبالنِّسبة إليه، «إنَّ قراءة الإنجيل توضح وتعمِّق» البحث الأنثروبولوجيَّ عن الحبّ.
في الفصل الرَّابع (ص. 89-107) دعوة إلى أن نستمرَّ في اتِّباع يسوع «فنلتقي معه» أشخاصًا مثل نيقوديمس، مرتا ومريم ولعازر، والمرأة السَّامريَّة. لقد التقاهم يسوع ودخل معهم في حوار انطلاقًا من واقع حياتهم، وسار معهم نحو طريق النُّور والحياة، ما يجعلنا نقتدي به في حبِّه التَّقيِّ والعميق للآخر الَّذي كان يلتقي به.
وفي النِّهاية، يقول المؤلِّف بضرورة التَّأمُّل بيسوع «نبع الحبِّ والأمان والتَّقدير» وهذا ما يشير إليه عنوان الكتاب الَّذي يستمدُّ معناه من التَّأمُّل بيسوع.
إنَّ الهدف الَّذي سعى إليه الأب ميشيل في بحثه المتوغِّل عميقًا في كينونة الإنسان، هو الإفادة الَّتي سيعود بها الكتاب على القُرَّاء سواء كانوا من الشَّبيبة، وهم في سعيٍ دائم إلى فهم معنى الحبِّ، أو من المتزوِّجين ومَن يستعدُّون للزَّواج، أو الرُّهبان والرَّاهبات في مراحل تكريس حياتهم لمجد الرَّبِّ، أو كلِّ شخص يبغي أن يعي نداء الحياة الحقيقيَّة، من أجل أن يغرِفوا جميعًا من معنى الحبِّ الحقيقيِّ من يسوع المسيح، نبع الحبِّ والمحبَّة.
ويوضح صاحب الكتاب أنَّ القارئ لن يجد إجابات جاهزة، بل على القارئ أن يستنير بالكلمات الَّتي تُغنيه من خلال قراءة الإنجيل، كلمة الحياة، وهي «كلمة مترسِّخة في الله » (ص. 16)، فيستمدُّ منه معنى حياته وتوجُّهاته.
في نهاية كلِّ فصل من الفصول الأربعة، يطرح المؤلِّف بعض الأسئلة الَّتي تساعد القارئ على «مراجعة ذاته»، كما يعرض بعض النُّصوص الكتابيَّة الَّتي تغذِّي صلاته وتأمُّله.
كلُّ فصول الكتاب تتنفَّس مساحة من التَّواصل والمحبَّة تساعد الإنسان في مساره نحو عيش الحياة الَّتي دعا إليها الرَّبُّ يسوع بهديٍ من نور كلمة الله الَّتي تبدِّد الظُّلمات، وتُزيح غمامة اليأس من قلب الإنسان.
الدُّكتورة بيتسا استيفانو: حائزة شهادة دكتوراه في العلوم الدِّينيّة، وإجازة في الآداب العربيَّة ودبلوم في علم النَّفس من جامعة القدِّيس يوسف في بيروت. أستاذة محاضرة في معهد الآداب الشَّرقيّة في الجامعة، ومسؤولة عن الأبحاث في مكتبة العلوم الإنسانيَّة فيها. أستاذة محاضرة في الجامعة الدُّومينيكيَّة – باريس. ولها العديد من المقالات المنشورة باللُّغتيَن العربيَّة والفرنسيَّة.


سقوط مدينة الأنا
سقوط مدينة الأنا
ط.١، ١٩٢ ص. بيروت: دار المشرق. ٢٠٢٥
ISBN: 978-2-7214-0007-9
يقدِّم أنطوان أبو جودة، في روايته سقوط مدينة الأنا الصَّادرة عن دار المشرق، ضمن «سلسلة أقلام جديدة» الَّتي تُشجِّع المواهب الأدبيَّة الشَّابَّة، الفكرة الفلسفيَّة أو الدِّينيَّة بأسلوب أدبيٍّ مشحونٍ بالصُّور والتَّساؤلات الذّاتيَّة والحوار المكتنز بالأفكار في سعيها الدَّائم إلى إجابات عن مصير الإنسان.
يعتمد المؤلِّف أدوات السَّرد الرِّوائيِّ انطلاقًا من تجربته في مقاربة التَّحدِّيات، وفي مواكبة بحث يفشل مرارًا في العثور على أجوبة عن معنى الحياة الحقيقيَّة والوجود. قد يبدو المشهد مشابهًا للسَّعي إلى الوصول إلى الأرض الموعودة الَّتي يراها المرء من بعيد، ولكنَّه لا يدخلها.
توجَّه المؤلِّف بإهدائه «إلى كلِّ الصغار الَّذين سقطوا في حروب الكبار، كبار الأنا» (ص.5)، فمواجهة الأنا هي قضيَّة إيجابيَّة للوقوع على وضوحٍ في الرُّؤية اختصرتها الرِّواية من «مغادرة الأنا» مدينتَها في الصَّفحة الأولى (ص. 7)، وهي «مدينة ظلاميَّة من كلِّ الأزمنة» (ص. 7)، حيث تبرز التَّناقضات والثُّنائيَّات كما بين العمَّال والفلَّاحين الكادحين الَّذين «يعيشون في بيوت فقيرة جدًّا» (ص. 7) والأغنياء الَّذين يتمتَّعون بحياة هانئة في «السُّوق، الَّذي هو، ساحة واسعة ونظيفة نسبيًّا» (ص. 8).
تخبر الرِّواية عن مدينة الأنا وكذلك عن قصَّة «نمُّول» (ص. 7) «رجلِنا الفقير الحالم» (ص. 10)، والَّذي «يقتات بعضًا من النَّمل لتخفيف وطأة الجوع» (ص. 14)، من هنا أتى لقبه.
تتنقَّل مشاهد الرِّواية في مطارح عدَّة، وفي مهنٍ مختلفة بأنواعها وجغرافيَّتها، من بائع الطُّيور، ورجل الدِّين الصَّالح، والآخر الطَّالح، إلى الرَّاقصة، والصَّيَّاد والشَّبكة، ثمَّ النَّاسك وغيرهم، وصولًا إلى دبي، الصِّين، التِّيبت، الهند، ولبنان… فيشير هذا التَّنوُّع إلى ضياع عبثيٍّ في البحث عن المدينة المقدَّسة، وهي رحلة الرِّواية، أساسًا، تقميشًا وتساؤلات.
وقد أتى بروز بعض الشَّخصيَّات الغامضة في الرِّواية تسهيلًا للحبكة الرِّوائيَّة وتوضيحًا لمسرى البنية القصصيَّة، كما في بائع الطُّيور (ص. 17) وحيث تظهر شخصيَّة «الكسيح» «الَّذي اختفى بعد أن وعد «نمُّول» بإرشاده إلى طريق المدينة المقدَّسة (ص. 15)، ولكنَّ نمُّول يهتدي أخيرًا، من خلال التَّأمُّل في صنائع الله، إلى «الحياة الرُّوحيَّة» (ص. 74)، والَّتي يبحث عنها كلُّ إنسان على تنوُّع حالاته الاجتماعيَّة ومشاكله.
لقد كان من اللَّافت تكرار الصُّدف في الحبكة، والَّذي بدا، وكأنَّه لخدمة سياق السَّرد ليس أكثر، فيما انبسط الخيال على مساحات واسعة من سقوط مدينة الأنا، ومعها اتَّسع فضاؤها الرِّوائيّ، وتمدَّد ليطال جغرافيا واسعة وإنْ ظهرت مشتِّتة أحيانًا، حتَّى الاهتداء إلى أنَّ مفتاح أسرار الحياة الحقيقيَّة هو في إسقاط الأنا من خلال جناحَي الحبِّ والإيمان «الله يريدكنَّ أصحَّاء روحيًّا وكاملات في الحبِّ، سرِّ السَّعادة الأبديَّة، لكنَّ هذا ليس ممكنًا إذا فضَّلتنَّ الانفصال عنه. فالأنا هي حائط يرتفع بينكنَّ وبينه، لا تتردَّدنَ في تحطيمه» (ص. 118).
وستكون محطَّة الرِّواية النِّهائيَّة، مع تعرُّف «نمُّول» إلى ناسك من لبنان يتزيَّن بفضائل: التَّواضع، الطَّاعة، التَّمييز، والإحسان (ص.149)، فيفهم مغزى وصيَّته: «انطلِقوا غدًا عائدين إلى مدينة الأنا، ومتى وصلتم، أنذروا الجميع كي يغادروا المدينة، فمن يترك الأنا ينجو، ومن يمكث فيها يهلك» (ص. 159). وهكذا تعثر الشَّخصيَّة الرَّئيسة في الرِّواية على خلاصها، لتبدأ الحقبة الجديدة (ص.183)، بتوجُّه «النَّاجين إلى الوادي المقدَّس في لبنان» (ص.185)، حيث تتجلَّى حكمة المدينة المقدَّسة بقول النَّاسك: «إمَّا أن نعبد الله وننمو في المحبَّة، أو نعبد الأنا وننمو في الأنانيَّة، وبين هاتين النَّزعتين يتخبَّط الإنسان (ص. 188)، وما يزال.
الدُّكتور جان عبد الله توما: حائز شهادة دكتوراه في اللُّغة العربيَّة وآدابها من الجامعة اللُّبنانيَّة. أستاذ محاضر في جامعات: القدِّيس يوسف، واللُّبنانيَّة، وسيِّدة اللَّويزة، ويشغل منصب رئيس قسم اللُّغة العربيَّة في جامعة الجنان. له تسعة عشر إصدارًا من كتب أدبيَّة، وشعريَّة، وروايات، ودراسات تربويَّة، وتحقيق مخطوطات.


ذكريات الحصار، مع الأب فرانس فان در لوخت اليسوعيّ
بهجت الحوش
ذكريات الحصار، مع الأب فرانس فان در لوخت اليسوعيّ
ط.١، ١٢٠ ص. بيروت: دار المشرق. ٢٠٢٥.
ISBN: 978-2-7214-0008-6
تظهر على الغلاف كلمة رواية، لكنَّ الكتاب أكثرُ من رواية، إنَّه وثيقة تاريخيَّة حقيقيَّة لم يكتبْها مؤرِّخ بل شاهد، ويمكن اعتمادها مرجعًا أكاديميًّا ومصدرًا للتَّوثيق.
الكتاب (أو الرواية) يسرد أحداثًا، بشكل لوحاتٍ حصلت بالفعل في مدينة حمص حين حاصَر الجيش السُّوريّ جماعات المسلَّحين المناهضة لنظام بشَّار الأسد، وحاصر معهم مجموعةً كبيرة من المدنيِّين الَّذين لم يتمكَّنوا، لسببٍ من الأسباب، من الفرار قبل أن يُفرَض طوقُ الحصار. ومن بين هؤلاء شخص اختار البقاء مع مَن بَقُوا، لأنَّه كاهن كرَّس نفسه لخدمة الرَّبِّ من خلال خدمته للإنسان. لقد شعر بأنَّه راعٍ لهؤلاء المدنيِّين، والرَّاعي الصَّالح لا يترك خرافه في الأزمة وينجو بنفسه. إنَّه الأب فرانس فان در لوخت اليسوعيّ.
وشاءت الظُّروف أن يكون مع هذا الرَّاعي شابٌّ أنهى دروسه الجامعيَّة، يحبُّ فتاةً، وخطبها، ويبحث عن عملٍ في مدينةٍ توقَّفت فيها كلُّ الأعمال. في فترة الفراغ هذه، طُلِبَ منه تطوُّعٌ شكلُه بسيط جدًّا: أن يقيم في الدَّير مع الأب فرانس كي لا يكون وحده، وأن يساعده في أعماله الإنسانيَّة.
لم يتردَّد هذا الشَّاب، وهو مؤلِّف الكتاب، في الموافقة. فقد تربَّى على روح الخدمة منذ نعومة أظافره، سواء في البيت أو في «الدَّير»، أي دير الآباء اليسوعيِّين الَّذي كان يتردَّد إليه. وعلى كلِّ حال، ليس لديه عمل يمنعه من قبول هذه الخدمة. فأقام في الدَّير، وهنا بدأت الحكاية. فقد حوصر مع الأب فرانس، ورضي بذلك ولم يهرب. وكان شاهدًا على أحداثٍ تجعل القارئ محتارًا تجاه ردَّة الفعل المناسبة لما يقرأه. هل يضحك، هل يتألَّم، هل يبكي، هل يشكر الله على رعايته؟ خليطٌ عجيب من هذه المشاعر في كلِّ مشهد: رائحةُ البول الخانقة لعجوز معوَّقة تعيش في القبو وتخدمها أختها الثَّرثارة الأكبر منها سنًّا، تركُ التَّابوت يسقط على الأرض وخروج الجثَّة منه للاحتماء من القذائف التي بدأت تنهار على المقبرة، ابتسامةُ طفل فقَد ساقه لقطعة سكاكر قدَّموها له، نبشُ قبرٍ وفتحُ تابوتِ عجوزٍ ماتت قبل شهر لدفنِ أختها إلى جانبها لأنَّ التَّوابيت نفدت…
لقد حاول الكاتب إبراز شخصيَّة الأب فرانس وعملَه الإنسانيّ: إسعافُ الفقراء والمعوزين، علاقاتٌ إسلاميَّة مسيحيَّة، تضامنٌ وتآخٍ بين جميع أطياف المحاصرين من أغنياء وفقراء، كبارًا وصغارًا، محاربين ومدنيِّين، مسيحيِّين ومسلمين… كما حاول الكاتب – الشَّاهد إخفاءَ نفسه قدر الإمكان، وعدم ذكر الدَّور الَّذي مارسه كمساعد للأب فرانس، والاستشارات بينهما، والقرارات المشتركة. لقد كان معه في كلِّ عمل إنسانيّ، وخاطَر معه بحياته مرارًا، وتعرَّض معه للقنص والقصف، لكنَّه لم يتباهَ بذلك بل بالعكس، سلَّط، في بعض الأحيان، الضَّوء على ضعفه وتردُّدِه، وعلى مساندة الأب فرانس له.
تمّ تأليف هذا الكتاب، وقرَّر الكاتب نشره في أيَّام حُكم الأسد مع كلِّ ما في هذه الخطوة من مخاطرة. الأسماء المذكورة فيه ليست الأسماء الحقيقيَّة. فالمطَّلعون على الأحداث يعرفون مثلًا أنَّ المصوِّر فارس هو باسل شحادة الَّذي كان يوثِّق الأحداث وقُتِلَ. وحرِص الكاتب على ألَّا ينحاز لأيِّ طرف، وحرصُه هذا لم ينبع من خوف. فحين سقط النِّظام سُئل عمَّا إذا كان يريد تعديل شيء في كتابه قبل أن يُطبَع، فالأحوال تغيَّرت، ويمكنه الكلام الآن بحرِّيَّة. لكنَّه رفض إجراءَ أيِّ تغيير، لأنَّه نهَج في كتابته منهجَ الأب فرانس: عدم الانحياز لأيِّ طرف كي نتمكَّن من أن نكون عناصرَ وفاقٍ ومصالحة.
فصول الكتاب قصيرة، مكتوبة بلغةٍ جذلة، تروي الأحداثَ بأمانةٍ ومن دون تضخيمٍ أو زخرفة. كثيرون قرأوه وقالوا: مَن يبدأ بقراءته لن يتركه حتَّى ينهيه.
الأب سامي حلَّاق اليسوعيّ : راهب يسوعيّ، وأستاذ في جامعة القدِّيس يوسف – بيروت. له مؤلَّفات وترجمات عدَّة منشورة، بالإضافة إلى مقالاتٍ بحثيَّة في مجلَّة المشرق.


كتّاب العدد الأحدث
مقالات هذا العدد
المرأة من الاستمرار بالعناية المنزليَّة إلى القيادة الاجتماعيَّة الفعَّالة!
لفتت انتباهي المقالة المنشورة، في هذا العدد من مجلَّة المشرق، عن دور المرأة في الاقتصاد وإدارة الأعمال، وألهمتني أن أدوِّن هذه الكلمة في لحظة يحتاج فيها العالم الأوسع والأصغر، أكثر من أيِّ وقت مضى، إلى إعطاء المرأة موقعًا مركزيًّا في عمليَّة الإصلاح، والرِّعاية، والبناء، والصُّمود.
فالمرأة لم تعد مجرَّد شاهدة أو داعمة خفيَّة لمسيرة التَّنمية، بل أصبحت فاعلة رئيسة لا يمكن الاستغناء عنها. في إدارة الأعمال، وفي الابتكار الاقتصاديِّ، وفي التَّغيير الاجتماعيِّ، تبرهن المرأة على ذكاء استثنائيٍّ، وقدرة على التَّوفيق بين العقلانيَّة والإنسانيَّة، وبين الحزم والبصيرة، ما يجعل منها ركيزة أساسيَّة في بناء مستقبل أكثر عدلًا وتوازنًا.
إنَّ إعطاء المرأة مساحة أوسع في مواقع القرار لا يُعدُّ استجابة لمطلب العدالة والمساواة فحسب، بل هو خيار استراتيجيٌّ يعكس وعيًا بأهميَّة التَّنوُّع، وفعَّاليَّة القيادة المتعدِّدة الرُّؤى، وثراء التَّجربة الإنسانيَّة. إنَّ عالم الغد لن يُبنى بدون النِّساء، بل سيتقوَّى ويستمرُّ بهنَّ ومن خلالهنَّ.
تؤدِّي المرأة اللُّبنانيَّة والعربيَّة دورًا متناميًا وحيويًّا في المجتمع، ولا سيَّما في ميادين الإدارة والاقتصاد والماليَّة، حيث أثبتت قدرتها على المساهمة الفعليَّة في دفع عجلة التَّنمية والتَّقدُّم. لقد تجاوزت المرأة اليوم الصُّورة التَّقليديَّة الَّتي حُصرت في إطارها لسنوات، واستطاعت أن تبرز في ميادين العلم والعمل والقيادة، بفضل ما تمتلكه من كفاءة أكاديميَّة ومهنيَّة، فنالت أعلى الدَّرجات العلميَّة من أهمِّ الجامعات، ودخلت سوق العمل بثقة ومهارة. هذا التَّقدُّم لم يقتصر على التَّحصيل العلميِّ فحسب، بل انعكس أيضًا في أساليب القيادة والإدارة الَّتي تمارسها المرأة، والَّتي تمتاز غالبًا بالمزج بين الحزم والمرونة، وبين الرُّؤية الاستراتيجيَّة والذَّكاء العاطفيِّ، ما يضفي على بيئات العمل طابعًا أكثر توازنًا وإنسانيَّة.
وتأتي مشاركة المرأة في الاقتصاد لتؤكِّد أنَّها ليست عنصرًا مكمِّلًا فحسب، بل هي شريك أساسيٌّ في النُّموِّ والإنتاج. فكلَّما زادت نسبة مشاركتها في القوى العاملة، كلَّما ارتفع النَّاتج المحليِّ، وتوسَّع النَّشاط الاقتصاديُّ، وتقلَّصت الفجوات الاجتماعيَّة، ما يعزِّز العدالة ويقوِّي النَّسيج الاجتماعيَّ. كما أنَّ تمكين المرأة اقتصاديًّا وإداريًّا يمنحها استقلاليَّة حقيقيَّة، ويعزِّز دورها كمحرِّك للتَّغيير في الأسرة والمجتمع، ويجعل منها نموذجًا ملهِمًا للأجيال الصَّاعدة من الفتيات. لكن على الرُّغم من كلِّ هذا التَّقدُّم، فإنَّ الواقع لا يزال يفرض تحدِّيات كبيرة أمام تطوُّر هذا الدَّور، أبرزها العقليَّات التَّقليديَّة الَّتي تقيِّد المرأة في أدوار نمطيَّة، وتمنعها من الوصول إلى كامل إمكاناتها.
لذلك، فإنَّ تطوير دور المرأة في المجتمع يستدعي عملًا جذريًّا على عدَّة مستويات. لا بدَّ أوَّلًا من إعادة النَّظر في الذِّهنيَّات والمفاهيم الثَّقافيَّة الَّتي تقيِّد مشاركتها، وذلك من خلال تربية قائمة على قيم المساواة والعدالة والاحترام، تبدأ من المناهج التَّعليميَّة وتُترجم في البيوت والمدارس والإعلام. كما أنَّ التَّشريعات لا بدَّ من أن تواكِب هذا التَّحوُّل، من خلال سنِّ قوانين تضمن للمرأة فرصًا متكافئة في العمل والمشاركة السياسيَّة والإداريَّة، وتمنع كلَّ أشكال التَّمييز في الأجور أو التَّرقية. ولا بدَّ أيضًا من توفير بيئة مهنيَّة آمنة ومرنة تدعم المرأة وتراعي خصوصيَّاتها، لا سيَّما من خلال سياساتٍ تتعلَّق بالإجازات العائليَّة، ودعم ريادة الأعمال النِّسائيَّة، وتسهيل الوصول إلى مراكز القرار.
ويُعتبر الإعلام أداة محوريَّة في إعادة تشكيل صورة المرأة في الوعي الجمعيِّ، إذ لا يكفي الحديث عن المساواة نظريًّا، بل يجب أن تظهر المرأة في الإعلام نموذجًا ناجحًا وفاعلًا في كلِّ المجالات، بعيدًا عن الصُّور النَّمطيَّة السَّطحيَّة الَّتي تختزلها في الجمال أو التَّبعيَّة. إنَّ تمكين المرأة لا يُعدُّ مكسبًا فرديًّا للنِّساء فحسب، بل هو استثمار في طاقة إنسانيَّة جماعيَّة قادرة على الإبداع والتَّجديد، وبناء مجتمع أكثر عدلًا وتوازنًا وابتكارًا. فليس من الممكن أن ينهض المجتمع بجناح واحد، ودورُ المرأة لم يعد خيارًا ولا ترفًا، بل هو ضرورة وطنيَّة وإنسانيَّة لبناء مستقبلٍ يليق بالجميع.
الأب سليم دكَّاش اليسوعيّ: رئيس تحرير مجلَّة المشرق. رئيس جامعة القدِّيس يوسف. رئيس رابطة جامعات لبنان. عضو في الاتِّحاد الدَّوليّ للجامعات (منذ العام 2016). حائز شهادة دكتوراه في العلوم التَّربويَّة من جامعة ستراسبورغ – فرنسا (2011)، وشهادة دكتوراه في الآداب – الفلسفة من جامعة بانتيون - السُّوربون 1 (1988)، ويدرِّس فلسفة الدِّين والحوار بين الأديان والرُّوحانيَّة السِّريانيَّة في كلِّيَّة العلوم الدِّينيَّة في الجامعة اليسوعيَّة.
مفهوم «الإنسانيَّة» في المسيحيَّة، المعنى، المقصود، والقيمة
برز مصطلح «الإنسانيَّة» حديثًا كقيمة مركزيَّة في الخطابات الدِّينيَّة والفكريَّة، لا سيَّما في وثائق مثل «وثيقة الأخوَّة الإنسانيَّة» الصَّادرة في العام 2019. تتناول المقالة مفهوم الإنسانيَّة من جوانب متعدِّدة: بيولوجيَّة، وأخلاقيَّة، وفلسفيَّة ولاهوتيَّة. فالإنسانيَّة لا تقتصر على الانتماء إلى الجنس البشريِّ، بل تتضمَّن سلوكيَّات وقيمًا مثل الرَّحمة، والعدل، والحرِّيَّة.
تستعرض الدِّراسة جذور المفهوم في الفكر اليونانيِّ (أرسطو)، والكتاب المقدَّس، والفلسفة المسيحيَّة (توما الأكوينيِّ وأغسطينوس)، حيث تُربط الإنسانيَّة بصورة الله والكرامة الذَّاتيَّة. وتقارنها بالفكر الحديث، كما في فلسفة كانط Kant، الَّتي ترى الحرِّيَّة والكرامة محورًا للإنسان، في مقابل تشاؤم هوبز Hobbes، ونزعة روسو Rousseau للتَّغيير عبر التَّربية.
وتنتهي المقالة بالدَّعوة إلى إحياء مفهوم الإنسانيَّة الواحدة في ظلِّ الأزمات العالميَّة، مؤكِّدًة أهمِّيَّة الطَّبيعة البشريَّة ركيزةً أخلاقيَّة، ومبرِزةً وثيقة الفاتيكان «الكرامة الإنسانيَّة اللَّامتناهية» Dignitas infinita خطوةً نحو توحيد الرُّؤية بشأن قيمة الإنسان وحقوقه.
كلمات مفتاحيَّة: الإنسانيَّة – الأنسنة – حقوق الإنسان – الكرامة الإنسانيَّة - الفطرة الإنسانيَّة – الفلسفة الأخلاقيَّة – الفكر الدِّينيّ – صورة الله في الإنسان - اللَّاهوت المسيحيّ – العقل والحرِّيَّة – الأخوَّة الإنسانيَّة – الوثيقة الباباويَّة – الفكر الفلسفيّ الغربيّ - أرسطو – أوغسطين – توما الأكوينيّ – إيمانويل كانط.
La notion d’« humanité » dans le christianisme : p
le sens, la visée et la valeur
par P. Salim Daccache
Le terme « humanité » s’est imposé récemment comme une valeur centrale dans les discours religieux et philosophiques, notamment à travers des textes comme le Document sur la fraternité humaine publié en 2019. Cet article explore la notion d’humanité sous divers angles : biologique, éthique, philosophique et théologique. L’humanité ne se réduit pas à l’appartenance à l’espèce humaine, mais englobe aussi des comportements et des valeurs telles que la compassion, la justice et la liberté. p
L’article retrace les racines du concept dans la pensée grecque (Aristote), la Bible, et la philosophie chrétienne (Thomas d’Aquin, Augustin), où l’humanité est liée à l’image de Dieu et à la dignité qui lui est intrinsèque. Il compare ensuite cette approche à la pensée moderne, avec Kant, pour qui la liberté et la dignité sont essentielles, face au pessimisme de Hobbes ou à l’appel de Rousseau à changer l’homme par l’éducation. p p .
L’article conclut en appelant à raviver l’idée d’une humanité unifiée face aux crises contemporaines. Il insiste sur l’importance de la nature humaine comme fondement éthique et met en lumière le document promulgué par Vatican « Dignitas infinita »: La dignité humaine infinie, comme un pas vers une vision commune de la valeur et des droits de l’être humain..bh
Mots-clés: L’humanité – L’humanisme – Les droits de l’homme – La dignité humaine – La nature humaine – La philosophie morale – La pensée religieuse – L’image de Dieu dans l’homme – La théologie chrétienne – La raison et la liberté – La fraternité humaine – Le document pontifical – La pensée philosophique occidentale – Aristote – Augustin – Thomas d’Aquin – Emmanuel Kant. p
الأب سليم دكَّاش اليسوعيّ: رئيس تحرير مجلَّة المشرق. رئيس جامعة القدِّيس يوسف. رئيس رابطة جامعات لبنان. عضو في الاتِّحاد الدَّوليّ للجامعات (منذ العام 2016). حائز شهادة دكتوراه في العلوم التَّربويَّة من جامعة ستراسبورغ – فرنسا (2011)، وشهادة دكتوراه في الآداب – الفلسفة من جامعة بانتيون - السُّوربون 1 (1988)، ويدرِّس فلسفة الدِّين والحوار بين الأديان والرُّوحانيَّة السِّريانيَّة في كلِّيَّة العلوم الدِّينيَّة في الجامعة اليسوعيَّة.


ديناميَّات قيادة المرأة في الاقتصادات النَّاشئة: بين العقبات الهيكليَّة وعوامل النُّهوض
تستقصي هذه الدِّراسة دور المرأة المتطوِّر في مجال الأعمال التِّجاريَّة، مع التَّركيز على مشاركتها في القيادة وريادة الأعمال والابتكار الرَّقميِّ، سواء على الصَّعيد العالميِّ أو في الاقتصادات الهشَّة مثل لبنان. بالاعتماد على الأطر النَّظريَّة، بما في ذلك نظريَّة رأس المال البشريِّ، ونظريَّة الدَّور الاجتماعيِّ، والنَّظريَّة القائمة على الموارد، والنَّظريَّة المؤسَّسيَّة، يستكشف البحث كيفيَّة مساهمة المرأة في التَّنمية الاقتصاديَّة والتَّحوُّل التَّنظيميِّ على الرُّغم من العوائق الهيكليَّة المستمرَّة. تسلِّط الدِّراسة الضَّوء، من طريق تحليل مزيج من الإحصاءات العالميَّة، ودراسات الحالة الإقليميَّة، والمبادرات الشَّعبيَّة اللُّبنانيَّة، كيف أنَّه في حين أنَّ النِّساء يمثِّلنَ ٦٪ فقط من الرُّؤساء التَّنفيذيِّين العالميِّين و٢٨٪ من المناصب القياديَّة في العالم، إلَّا أنَّ وجودهنَّ يعزِّز، بشكل كبير، الحوكمة، والمرونة، والاستدامة في الأعمال التِّجاريَّة. ففي لبنان، حيث لا تزال القيود المؤسَّسيَّة والماليَّة قائمة، تستفيد رائدات الأعمال من الشَّبكات غير الرَّسميَّة، والأدوات الرَّقميَّة، والاستراتيجيَّات المجتمعيَّة لخلق قيمة اقتصاديَّة شاملة. تشير النَّتائج إلى أنَّ مشاركة المرأة في الأعمال التِّجاريَّة لا تعزِّز المساواة فحسب، بل ترتبط بتحسين الأداء الماليِّ، وإدارة الأزمات والابتكار على المدى الطَّويل. وتختتم المقالة بالتَّشديد على الحاجة إلى إصلاحات متكاملة في السِّياسات، وبرامج التَّمكين الرَّقميِّ، والدَّعم المؤسَّسيِّ لتسريع التَّكافؤ بين الجنسَين في قيادة الأعمال وريادتها.
كلمات مفتاحيَّة: القيادة النِّسائيَّة – ريادة الأعمال – المساواة بين الجنسَين – التَّمكين الرَّقميّ – التَّنمية الشَّاملة – الإصلاح المؤسَّسيّ.
Dynamiques du leadership féminin
dans les économies émergentes: Entre obstacles structurels et leviers d’action
Cet article examine l’évolution du rôle des femmes dans les entreprises, en mettant l’accent sur leur participation au leadership, à l’entrepreneuriat et à l’innovation numérique, tant au niveau mondial que dans les économies fragiles telles que le Liban. S’appuyant sur des cadres théoriques tels que la théorie du capital humain, la théorie des rôles sociaux, la vision basée sur les ressources et la théorie institutionnelle, cette recherche explore la manière dont les femmes contribuent au développement économique et à la transformation organisationnelle en dépit de barrières structurelles persistantes. Grâce à une analyse combinée de statistiques mondiales, d’études de cas régionales et d’initiatives locales libanaises, l’étude souligne que bien que les femmes ne représentent que 6% des PDG dans le monde et 28% des postes de direction, leur présence renforce considérablement la gouvernance, la résilience et la durabilité des entreprises. Au Liban, où les contraintes institutionnelles et financières persistent, les femmes entrepreneurs s’appuient sur des réseaux informels, des outils numériques et des stratégies communautaires pour créer une valeur économique inclusive. Les résultats indiquent que l’implication des femmes dans les entreprises favorise non seulement l’équité, mais est également corrélée à l’amélioration des performances financières, à la gestion des crises et à l’innovation à long terme. L’article conclut en soulignant la nécessité de réformes politiques intégrées, de programmes d’autonomisation numérique et d’un soutien institutionnel pour accélérer la parité hommes-femmes dans la direction des entreprises et dans les initiatives entrepreneuriales. .
Mots clés: Leadership féminin – Esprit d’entreprise – Égalité des sexes – Autonomisation numérique – Développement inclusif – Réformes institutionnelles. p
الدُّكتورة ندى الملَّاح البستانيّ: رئيسة مؤسِّسة لجمعيَّة التَّميُّز للأبحاث المبتكرة والاستدامة والتَّنمية الاقتصاديَّة AXISSED. أستاذة في كلِّيَّة الإدارة والأعمال في جامعة القدِّيس يوسف ببيروت. حائزة شهادة دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة «Jean Moulin Lyon 3» – فرنسا، وحائزة شهادة «HDR» في الإدارة والأموال من جامعة «Picardie – Jules Verne» – فرنسا، وماجستير في العلوم الدِّينيَّة من جامعة القدِّيس يوسف ببيروت. أستاذة ومستشارة في الهيئة اليسوعيَّة العالميَّة للتَّعليم JWL . عضو ناشط في العديد من الهيئات البحثيَّة العلميَّة AIS, LEFMI، وعضو مؤسِّس في المنظَّمة البيئيَّة Green Community.


نشوء اقتصاد دولة لبنان في ظلِّ الانتداب الفرنسيّ- السَّنوات الأولى، الأطر العامَّة والموارد الأهمُّ
تميَّزت السَّنوات الأولى للسَّيطرة الفرنسيَّة على بلادنا بمراحل عدَّة: بدأت بالسَّيطرة العسكريَّة على أراضي لبنان الحاليِّ كافَّة، ثمَّ كامل أراضي برِّ الشَّام. وبعد ذلك تمَّت السَّيطرة الإداريَّة التَّدريجيَّة وتنظيم إدارات الدَّولة اللُّبنانيَّة وإدارة أجهزة الانتداب. وتلتها بالتَّزامن معها عمليَّة تنظيم الاقتصاد: مركزيًّا عبر «المصالح المشتركة» الَّتي صمِّمت للسَّيطرة على المفاصل الاقتصاديَّة والسياسيَّة الأساسيَّة في منطقة الانتداب: من بنك مركزيٍّ فرنسيّ الهويَّة، وعملة واحدة مرتبطة بالفرنك الفرنسيّ لكلِّ نطاق الانتداب، كذلك نظام جمركيٍّ واحد وغيرها من أدوات ضبط الاقتصاد والسُّلطات العامَّة في كلِّ منطقة الانتداب الفرنسيِّ. وتُركت قطاعات اقتصاديَّة عديدة للدُّول النَّاشئة عن الانتداب، منها دولة لبنان الكبير.
لكنَّ دور الوزارات القطاعيَّة في الدُّول المكوِّنة لنطاق الانتداب الفرنسيّ أخذ يتوسَّع بخاصَّةٍ في دولة لبنان الكبير، ثمَّ الجمهوريّة اللُّبنانيَّة مع التطوُّرات الاقتصاديَّة والسياسيَّة ابتداء من العشرينيَّات ومن ثمَّ وبخاصَّةٍ في الثَّلاثينيَّات.
وفي هذا الإطار العامِّ انحصرت أهمُّ موارد الدَّخل في لبنان بأمرَين: أوَّلًا، الهجرة الَّتي استؤنِفت في العشرينيَّات. وثانيًا، قطاع الحرير الَّذي استعاد نشاطه بدفع من سلطات الانتداب ومصالح الفرنسيِّين في هذا القطاع في فرنسا حتَّى أواخر العشرينيَّات.
كلمات مفتاحيَّة: لبنان الكبير – الجمهورية اللُّبنانيَّة – الهجرة – إنتاج الحرير - الانتداب – المصالح المشتركة.
L’émergence de l’économie de l’Etat libanais au début du Mandat Français
par Dr. Boutros Labaki
Les premières années du Mandat français sur le Liban furent marquées par plusieurs étapes: le contrôle militaire de tous les territoires du Liban actuel, puis de tous les territoires du Levant. Parallèlement, un contrôle administratif et une organisation progressive des administrations de l’État libanais et des institutions du Mandat ont été mis en place. p
Ce processus fut suivi, de manière simultanée, par l’organisation de l’économie : de manière centralisée, à travers « l’Organisation des intérêts communs » destinés à contrôler les mécanismes économiques et politiques de base dans l’espace mandataire : Une banque centrale aux capitaux français, une monnaie unique liée au franc français pour toute la zone du mandat. Egalement un système douanier unique fut établi ainsi que d’autres outils, pour contrôler l’économie et les pouvoirs publics de toute la zone du mandat français. De nombreux secteurs économiques sont cependant laissés aux États issus du mandat, notamment le Grand Liban. p
Cependant, le rôle des ministères sectoriels dans les pays du Levant sous le mandat français commença à s’accroître, notamment au Grand Liban puis en République libanaise, avec les développements économiques et politiques des années 1920 et surtout des années 1930. p
Dans ce cadre général, les sources de revenus les plus importantes du Liban étaient au nombre de deux : Les remises de l’émigration, qui reprit dans les années 1920, et le secteur de la soie, qui reprit son activité avec le soutien des autorités mandataires et les intérêts du secteur séricicole français jusqu’à la fin des années 1920. p
Mots clés: Grand Liban – République Libanaise – émigration – sériciculture – Mandat – Intérêts Communs. p
الدُّكتور بطرس لبكي: دكتوراه في التاريخ الاقتصاديِّ من جامعة السُّوربون – باريس. أستاذ ورئيس مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعيَّة – الجامعة اللُّبنانيَّة. أستاذ ومدير أبحاث في جامعة القدِّيس يوسف، وأستاذ في الجامعة الأميركيَّة – بيروت، وفي جامعة ليون الثَّانية، ويعمل في المركز الوطنيِّ الفرنسيِّ للأبحاث العلميَّة في باريس ورين، كما في جامعة أكسفورد والمعهد الألمانيِّ للأبحاث التَّربويَّة الدَّوليَّة في فرانكفورت. له العديد من الأبحاث في المجالَين الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ، وآخرها كتابُه «هجرة اللُّبنانيِّين (1850-2018) مسارات عولمة مبكِّرة».


أثر علوم اللُّغة في الخطِّ العربيّ
يُعتبر المعيار الجماليُّ أساسًا في الخَطِّ العربيِّ، وقد نَفَرَ الكُتَّاب واللُّغويُّون العرب من تكرار الحروف المتماثلة، فلجأوا إلى الحذف. يتناول هذا البحث كتابة «إذَن» بالنُّون، والألف «إذًا»؛ كما يتناول وصلَ «في» بِـ «ما» وانفصالهما؛ بالإضافة إلى وصل «لا» النَّافية بـ «أنْ» النَّاصبة للفعل المضارع، و«أنْ» المُخَفَّفة من «أنَّ»، و«أنْ» التَّفسيريَّة؛ كذلك كتابة التَّاء مربوطةً، أو مبسوطة؛ وحذف الألف وزيادتها والواو في المواضع المختلفة.
ختامًا، لو اعتمد العلماء قاعدة «كلُّ ما يُقْرَأُ يُكْتَبُ، وما لا يُقْرَأُ لا يُكْتَبُ»، لبَسَّطوا قواعد الإملاء العربيِّ.
كلمات مفتاحيَّة: الجوار – الخطّ – علوم اللُّغة – الكتابة – الحذف والزِّيادة – أثر – الألف والهمزة.
L’Influence des sciences linguistiques
sur la calligraphie arabe
par Dr. Ghassan Hamad
Le critère esthétique est considéré comme fondamental dans la calligraphie arabe. Les écrivains et linguistes arabes étaient rebutés par la répétition de lettres similaires et avaient recours à la suppression. Cette recherche porte sur l’écriture de «idhan» avec «nun» et «alif» «idhan»; ils abordent également le lien entre «fi» et «ma» et leur séparation. En plus de relier la forme négative «la» à «an» qui rend le verbe au présent nominatif, et à «an» qui est une version allégée de «anna», et à «an» qui est explicative ; De plus, l’écriture de la lettre taa’ est soit connectée, soit étendue. Suppression et ajout de la lettre alif et waw à différents endroits.
Enfin, si les savants avaient adopté la règle «tout ce qui est lu peut-être écrit, et ce qui n’est pas lu ne peut être écrit», ils auraient simplifié les règles de l’orthographe arabe.
Mots-Clés: Voisinage – Calligraphie – Sciences du langage – Ecriture – L’élision et l’ajout – Influence – La lettre Alef et le Hamza.
الدُّكتور غسَّان حمد: حائز شهادة الدُّكتوراه في اللُّغة العربيَّة وآدابها من جامعة القدِّيس يوسف – 2023، وعنوانها: أَثَرُ الجِوارِ اللُّغَويّ. مُدَرِّس في ملاك التَّعليم الثانويّ. وله عِدّة أبحاث لُغَويّة وأدبيَّة منشورة في مجلَّات مُحَكّمة، وديوانان شِعرِيَّان: قصائد حُبٍّ من جَبَل المَكْمل – دار الفارابي، 2018؛ ولقد مَسَّني الشِّعْر – دار الحداثة، 2024.


معنى النَّفي في «لا» النَّافية للجِنْس و«لا» العاملة عمل «لَيْس» و«لا» المُهْمَلة هو هو أم مختلف؟
يحاول هذا البحث الإجابة عن السُّؤال العنوان: «معنى النَّفي في «لا» النَّافية للجنس، و«لا» العاملة عمل «ليس»، و«لا» المهملة هو هو أم مختلف؟»، فيبدأ أوَّلًا بعرض أوجه «لا» السَّبعة؛ لينتقل بعدها إلى اللَّاءات الثَّلاث الَّتي هي عنوان البحث، فيفصِّل شروط عمل كلٍّ منها، وما قاله النُّحاة في معنى كلٍّ منها أيضًا في حالة مجيء الاسم بعدها مفردًا، ومثنًّى وجمعًا.
ويخلص البحث إلى أنَّ تفرقة النَّحاة في المعنى بين «لا» العاملة عمل «ليس»، و«لا» غير العاملة من جهة، وبين «لا» النَّافية للجنس من ناحية أخرى غير صحيح، فكلُّ هذه اللَّاءات تعني نفي الجنس نفيًا تامًّا، إلَّا إذا قلت: «لا رجلٌ في الدَّار بل رجلان»، عند ذلك يدلُّ السِّياق على أنَّ «لا» تنفي الوحدة لا الجنس.
كلمات مفتاحيَّة: «لا» النَّافية للجنس – «لا» العاملة عمل «ليس» – «لا» المهملة (غير العاملة) – المعنى – «لا» الجوابيَّة – «لا» الطَّلبيَّة – «لا» الزَّائدة – «لا» العاطفة – لغة تميم – المثنَّى – الجمع – البناء – الإعراب.
Le sens de la négation dans « lã » le négateur du genre, « lã » celui qui fonctionne comme « laysa » et « la » celui négligé est-il le même ou différent ?
par Dr. Ali Ahmed Ismail
Cette recherche tente de répondre à la question du titre : «Le sens de la négation dans «lā», le négateur du genre, «lā» qui fonctionne comme «laysa», et «lā» le négligé, est-il le même ou différent ?» Il commence par présenter d’abord les sept aspects de «lā»; Il passe ensuite aux trois «lā» qui constituent le titre de la recherche, et il explique les conditions de fonctionnement de chacun d’eux, et ce que les grammairiens ont dit sur le sens de chacun d’eux également dans le cas du nom qui le suit au singulier, au duel et au pluriel.
La recherche conclut que la distinction de sens faite par les grammairiens entre «lā» qui fonctionne comme «laysa» et «lā» qui ne fonctionne pas d’une part, et «lā» qui nie le genre d’autre part est incorrecte, car tous ces «lā» signifient une négation complète du genre, à moins que vous ne disiez: «Il n’y a pas un homme dans la maison, mais deux hommes», auquel cas le contexte indique que «lā» nie l’unité, pas le genre.
Mots-clés: «Lā» la particule négative – «Lā» qui fonctionne comme « laysa » – «Lā» le négligé (non opératoire) – le sens – «Lā» le creux – «Lā» l’impératif – «Lā» le redondant – «lā» l’émotionnel – le langage de Tamim – le duel – le pluriel – la construction – l’analyse.
الدُّكتور علي أحمد اسماعيل: حائز شهادة الدُّكتوراه في اللُّغة العربيَّة وآدابها من جامعة القدِّيس يوسف – 2022، بعنوان «الانزياح في شعر أدونيس». وهو مدير معهد بخعون الفنِّيِّ الرَّسميِّ. له أبحاث منشورة في مجلَّات مُحكَّمة، وتحقيق مخطوطة فتح الجليل (شرح قصيدة امرئ القيس الملك الضَّليل)، للشَّيخ أحمد السِّجاعي المصريِّ الأزهريِّ (ت. 1197هـ) – 2023، وديوانا شعر: الجدول المحترق، بيروت: دار الحداثة للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، 2023؛ وأناديكِ مِن آخر الكلمات، طرابلس: مطابع المكمل ، 2011.


«كان» ومشتقَّاتها بين إنجيل عيسى المسيح والقرآن
نشأنا، منذ صغرنا، على أنَّ «كان» هي فعلٌ ماضٍ ناقص، وأنَّ «هو» ضمير للغائب، ومع تحقيق مخطوطات إنجيل عيسى، بالعودة إلى النَّصّ السُّريانيِّ الأمِّ، تبيَّن لنا أنَّ الأمر مختلف تمامًا، فـ «كان» هي من «الكينونة» «وهو» من «الهويَّة»، وبالتَّالي فهما يلتقيان في المعنى، وينتهي بذلك مفهوم الفعل النَّاقص والجملة الاسميَّة في اللُّغة العربيَّة. قارنَّا هذا المعنى بما ورد في القرآن فوجدناه متطابقًا! علَّ أن يجد النُّحاة في نصِّ إنجيل عيسى، الَّذي سينشر قريبًا، مادَّة لإعادة صياغة قواعد كثيرة في اللُّغة العربيَّة.
كلمات مفتاحيَّة: كان – كينونة – هو – هويَّة – إنجيل عيسى – القرآن.
«Kana كان» et ses dérivés Selon l’Évangile de Issa le Christ et le Coran
par P. Hanna Skandar
Dès notre enfance, nous avons été élevés sur le fait que «kana كان» l’équivalent du verbe ‘être’ à l’imparfait «était» est un verbe qui relève du passé incomplet, et que «Huwa هو» ou le pronom personnel «il» en français est un pronom qui exprime une personne absente. p
Toutefois, lorsque j’ai édité les manuscrits de l’Évangile de Issa le Christ et je les ai comparés avec le texte mère syriaque, j’ai découvert que leur sens est complètement différent, car «kana كان» dérive du mot «kaynounat كينونة» qui veut dire « l’existence » et «Hawiyyat هويَّة» exprime « l’identité ». Donc, du point de vue sémantique, ils sont identiques, ce qui met fin au concept du verbe incomplet et à la phrase «sans verbe» en arabe… p
Nous avons comparé ce sens avec le Coran et nous l’avons trouvé identique! Dans le texte que j’ai édité sur l’Évangile de Issa le Christ et qui sera publié prochainement, les grammairiens trouveront de la matière pour reformuler de nombreuses règles de la langue arabe. p
Mots clés: kana كان – kaynounat كينونة – existence – Hawiyyat هويَّة – identité. p
الأب حنَّا إسكندر: أستاذ مادَّة التَّاريخ الوسيط واللُّغات القديمة في الجامعة اللُّبنانيَّة. نشر عشرات الكتب والمقالات البحثيَّة. فَهْرَسَ حوالى خمسين ألف وثيقةٍ وعشرات المخطوطات وحقَّقها، واشترك في عشرات المؤتمرات الدَّوليَّة في البلاد العربيَّة والأوروبيَّة.


التِّنِّين الرُّؤيويُّ بين الأساطير وأيديولوجيَّة عبادة الإمبراطور (رؤ 12-13)
يُعَدّ تنِّين سفر الرُّؤيا رمزًا قويًّا للصِّراع بين الخير والشَّرِّ، وله جذورٌ عميقةٌ في الأساطير القديمة. يَظهر التِّنِّين في الرُّؤيا ككائنٍ ضخمٍ أحمر اللَّون ذي سبعة رؤوسٍ وعشرة قرون، يسعى لافتراس الطِّفل المولود من المرأة، في صورةٍ دراميَّةٍ تشير إلى اضطهاد القوى الشِّرِّيرة لشعب الله أو للمسيح نفسه. لا ينفصل هذا التَّصوير عن رموزٍ أسطوريَّةٍ سابقة. ففي الميثولوجيا البابليَّة، على سبيل المثال، يواجه الإله مردوخ التِّنِّين تيامات، رمز الفوضى، ويقهره ليقيم نظام الخليقة. أمَّا في الأساطير الكنعانيَّة فيحارب الإله بعل التِّنِّين لاوياثان أو يمَّ. وفي الأساطير اليونانيَّة يواجه أبولو التِّنِّين بايثون. هذه الأساطير كلُّها تتحدَّث عن إلهٍ منتصرٍ على وحشٍ فوضويٍّ، يمثِّل الشَّرَّ والدَّمار. يستخدم كاتب سفر الرُّؤيا لغةً رمزيَّة مفعمةً بالصُّور المأخوذة من خلفيَّةٍ يهوديَّةٍ وهِلِّنِسْتيَّة، فيُعيد توظيف صورة التِّنِّين ليرمز إلى الشَّيطان أو الإمبراطوريَّة الرُّومانيَّة المضطهِدة، معيدًا تأويل الأسطورة القديمة في ضوء الرُّؤيا المسيحيَّة. وبذلك، يتحوَّل التِّنِّين من كائنٍ أسطوريٍّ إلى رمزٍ لاهوتيٍّ في معركة الخلاص.
كلمات مفتاحيَّة: سفر الرُّؤيا – التِّنِّين – الحيَّة – الأساطير القديمة – الثَّقافات القديمة – الإمبراطور – عبادة – أيديولوجيَّة.
Le dragon visionnaire
Entre mythes et idéologie du culte de l’empereur
(Apocalypse 12-13)
par l’Archimandrite Agapios Abu Saada
Le dragon de l’Apocalypse est un puissant symbole de la lutte entre le bien et le mal, et a des racines profondes dans la mythologie ancienne. Le dragon apparaît dans la vision comme une énorme créature rouge à sept têtes et dix cornes, cherchant à dévorer l’enfant né de la femme, dans une image dramatique indiquant la persécution des forces du mal du peuple de Dieu ou du Christ lui-même. Cette représentation est indissociable des symboles mythologiques antérieurs. Dans la mythologie babylonienne, par exemple, le dieu Marduk affronte le dragon Tiamat, symbole du chaos, et le vainc pour établir l’ordre dans la création. Dans la mythologie cananéenne, le dieu Baal combat le dragon Léviathan ou Yamm. Dans la mythologie grecque, Apollon affronte le dragon Python. Tous ces mythes parlent d’un dieu triomphant d’un monstre chaotique, représentant le mal et la destruction. L’auteur du Livre de l’Apocalypse utilise un langage symbolique rempli d’images tirées d’un contexte juif et hellénistique, réutilisant l’image du dragon pour symboliser Satan ou l’Empire romain oppressif, réinterprétant le mythe antique à la lumière de la vision chrétienne. Ainsi, le dragon se transforme d’une créature mythique en un symbole théologique dans la bataille pour le salut.
Mots-clés: Livre de l’Apocalypse – dragon – serpent – mythologie antique – cultures anciennes – empereur – culte – idéologie.
الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدى: راهب مخلِّصيٌّ من بيت ساحور - فلسطين. دكتور في لاهوت الكتاب المقدَّس، وباحثٌ في الدِّراسات المسيحيَّة الشَّرق أوسطيَّة. له عدَّة كتبٍ منشورة، ومنها: المسيحيُّون الفلسطينيُّون: أصالةٌ وطنيَّة وخصوصيَّة دينيَّة وصوتٌ جامع ودورٌ يفوق العدد؛ ابن هذا الشَّرق: دراسةٌ في الوجود المسيحيِّ في الشَّرق في القرون السِّتَّة الميلاديَّة الأولى؛ المسيحيُّون في الشَّرق الأوسط: براديغمٌ جديدٌ لتحليل إشكاليَّات الوجود والمستقبل.


قراءة كتابيَّة في «خدمة الزَّيت المقدَّس» تأوين / تحقيق الشِّفاء
كلمات مفتاحيَّة: الزَّيت المقدَّس – العهد الجديد – اللِّيترجيَّة – الكنيسة – الشِّفاء – المسيح.
Relecture Biblique de « l’Office de l’Huile Sainte » – Actualisation de la guérison
par Métropolite Nicolas Antiba
L’Eglise Byzantine célèbre, le Jeudi de la Grande et sainte Semaine avant la Pâque du Seigneur, « l’Office de l’Huile Sainte » connu sous le nom Huile des Pénitents ou Sacrement de l’Extrême Onction. Il est composé d’un grand nombre de lectures néotestamentaires (7 passages de l’Evangile et 7 passages des Epîtres), un matériau psalmique (2 psaumes, en plus de différents versets) ainsi que des hymnes et prières liturgiques (7 prières) composées avec des références bibliques. L’article est réparti en plusieurs paragraphes. Après un aperçu historique de l’office grâce à différents manuscrits du grand Eucologue et la place importante du Nouveau Testament, on aborde le rôle guérisseur de l’huile partant de l’Epître de Jacques, les guérisons évangéliques référées dans l’Office, le rôle de l’Eglise et des prêtres dans l’administration du Sacrement, avec un dernier paragraphe à propos de la grâce de la guérison octroyée par Dieu Lui-même. En conclusion, on propose que l’actualisation de la guérison s’effectue en une réponse ecclésiale sur l’importance de la place de la Parole de Dieu, l’effet de la foi du pénitent et par là la rémission des péchés. Ainsi, la Parole Divine, proclamée à la communauté croyante, pénitente et ecclésiale donne à la guérison une nouvelle dimension : restauration de tout l’être humain par le Christ ‘guérisseur de l’âme et du corps’.
Mots Clés: L’Huile Sainte – Le Nouveau Testament – La Liturgie – L’Eglise – La guérison – le Christ.
المتروبوليت نيقولا أنتيبا: النَّائب البطريركيُّ العامُّ في دمشق منذ العام 2018. تُوِّج أسقفًا في العام 2013 في دير المخلِّص، صربا، لبنان. خدم في الولايات المتَّحدة الأميركيَّة وأوروبا وسوريا ولبنان. درس اللَّاهوت واللُّغات الحيَّة والقديمة وغيرها في إيطاليا، كما أعطى دروسًا في جامعاتٍ لبنانيَّة وفرنسيَّة. له مقالاتٌ في مجلَّاتٍ عربيَّة وأجنبيَّة، وعدَّة مؤلَّفاتٍ في اللَّاهوت.


الخلاصة الفلسفيَّة للقدِّيس توما الأكويني
مقالات من أرشيف مجلَّة المشرق
السَّنة السَّابعة عشرة، العدد 2، شباط (1914)
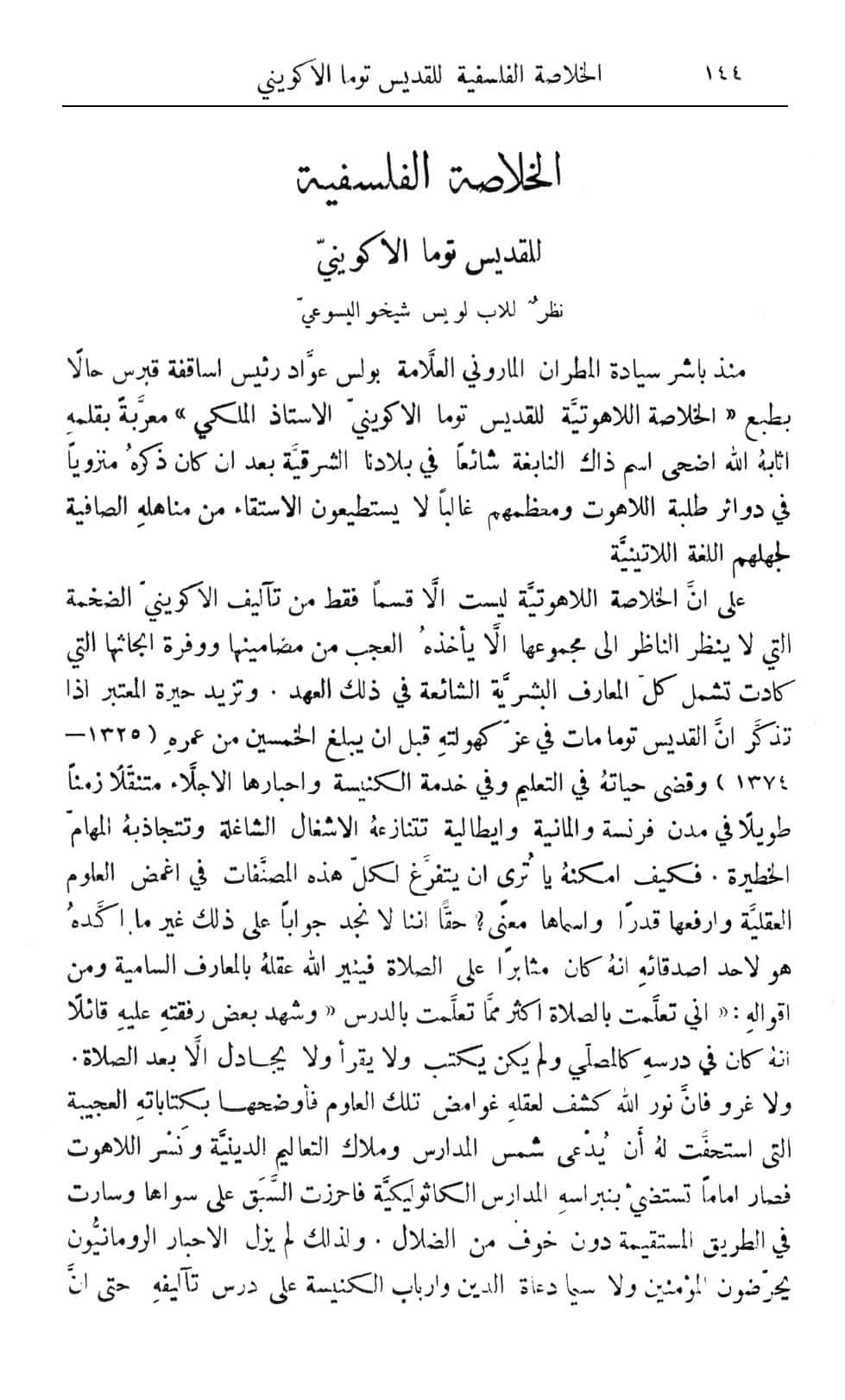
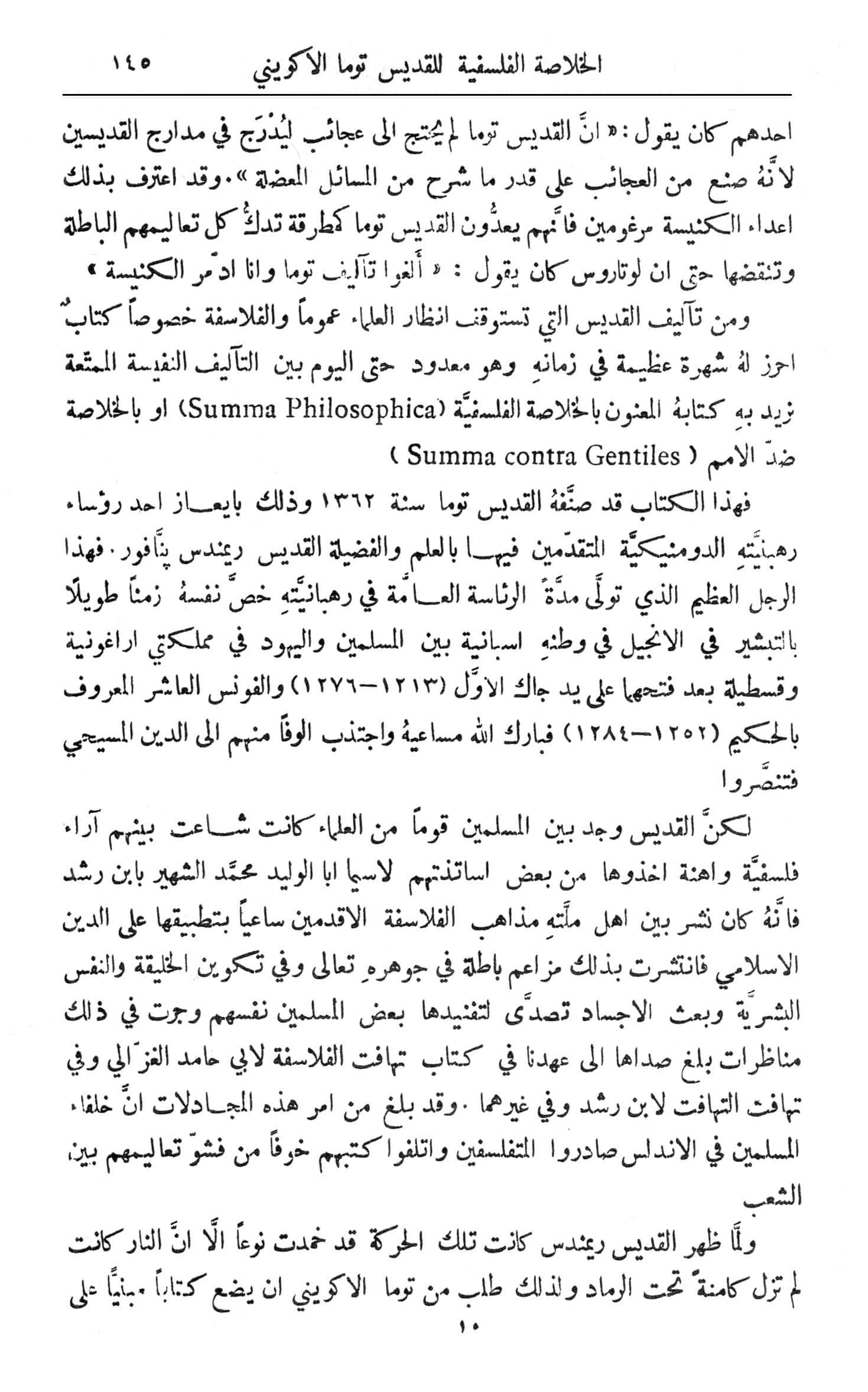
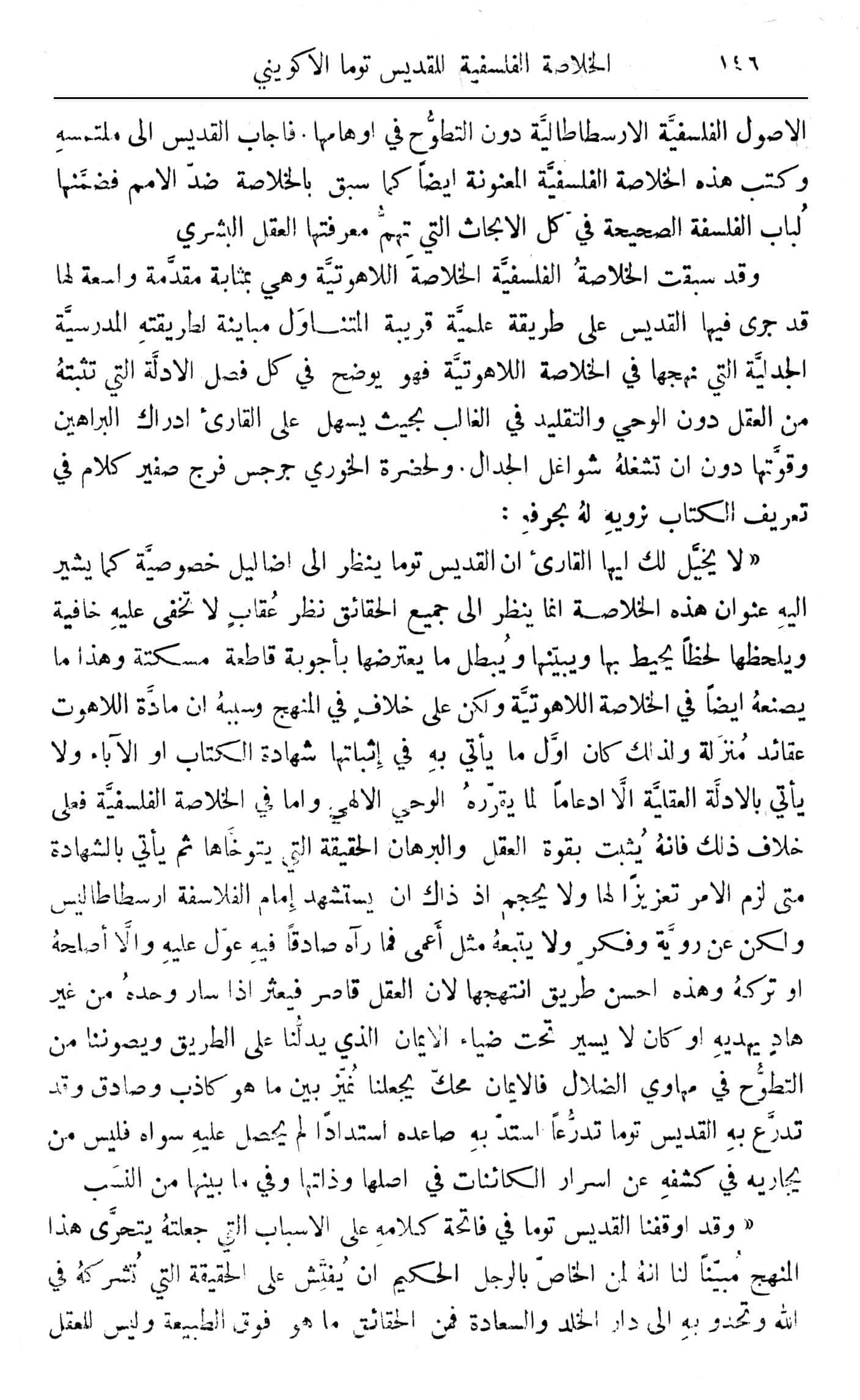
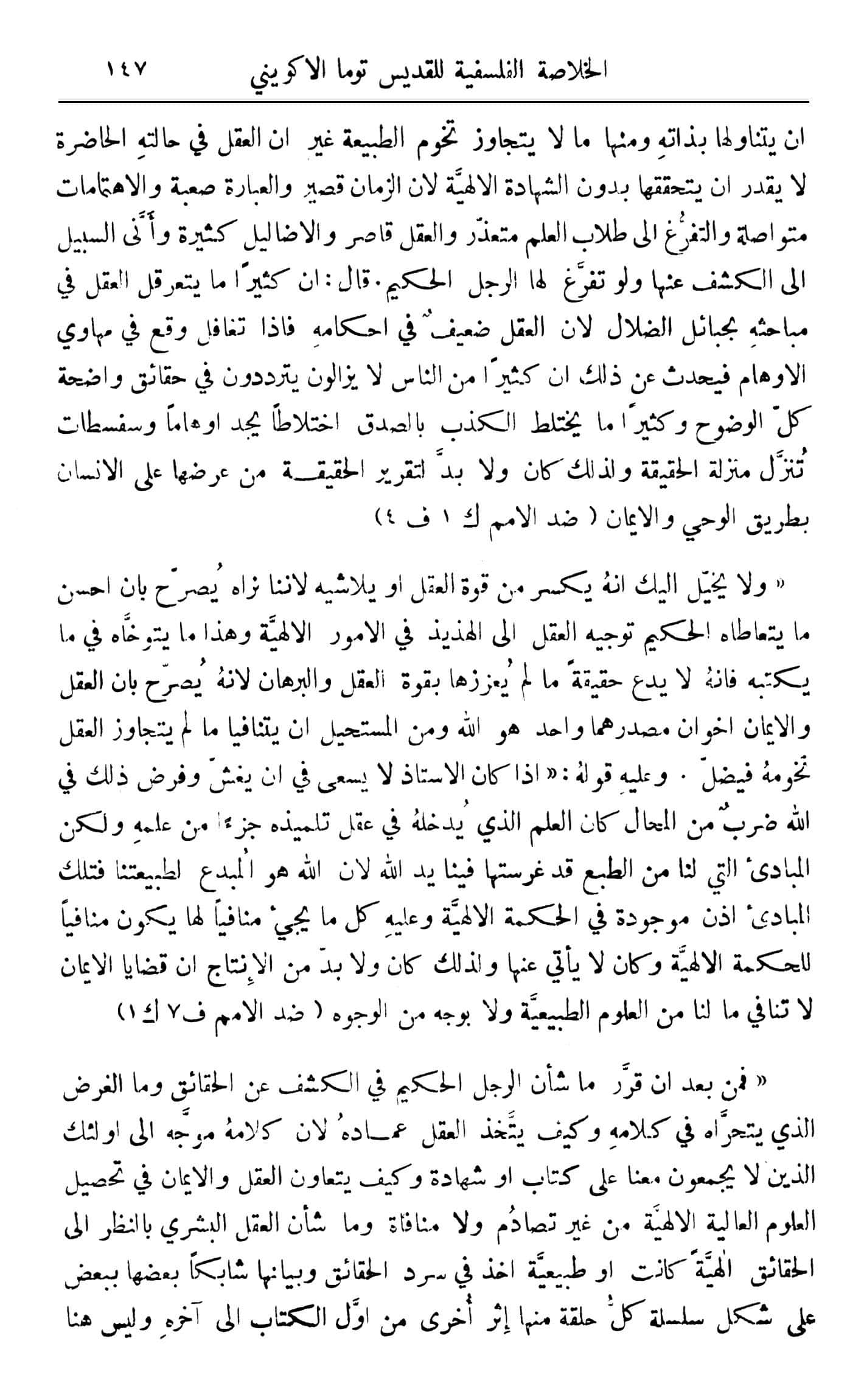
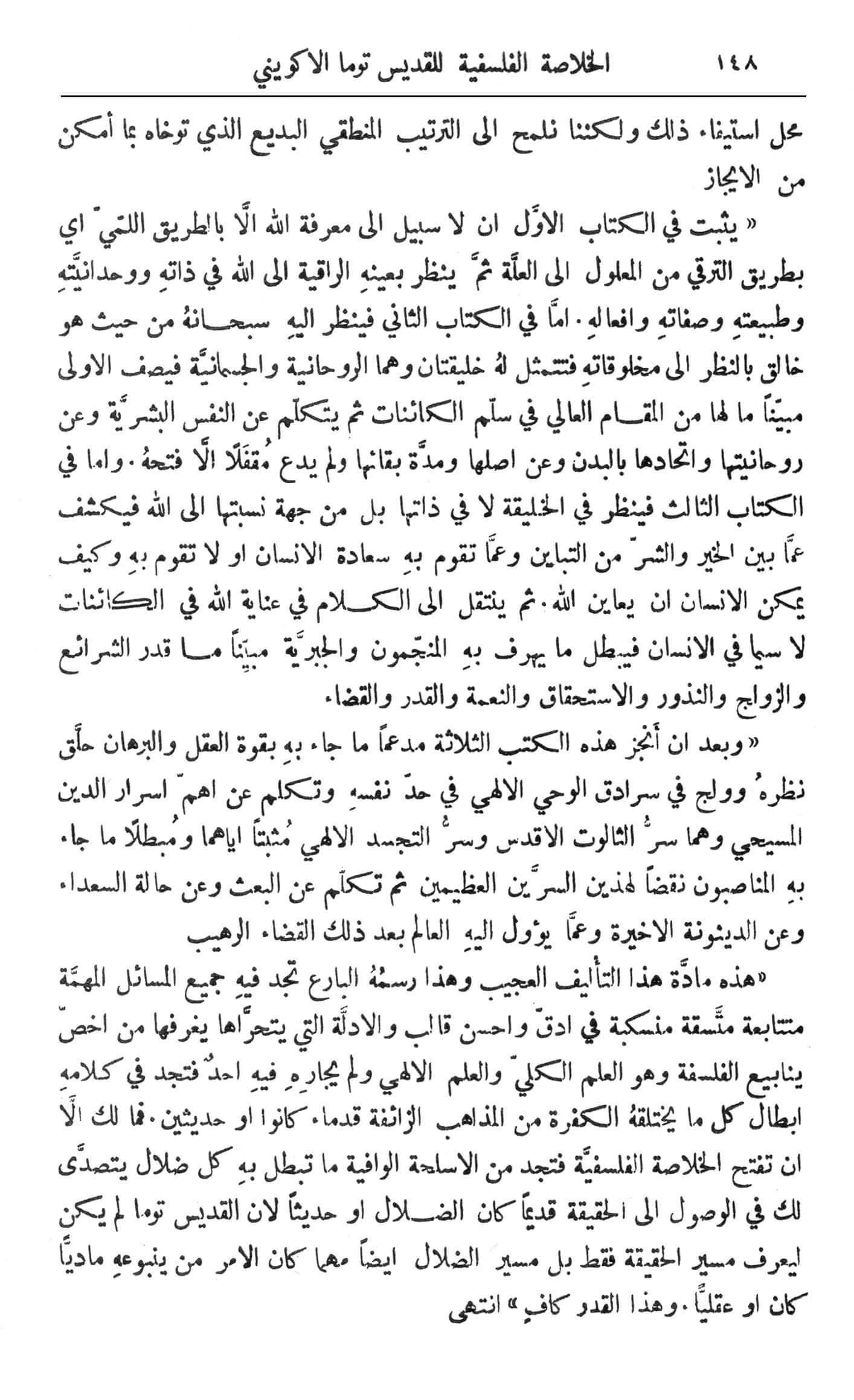
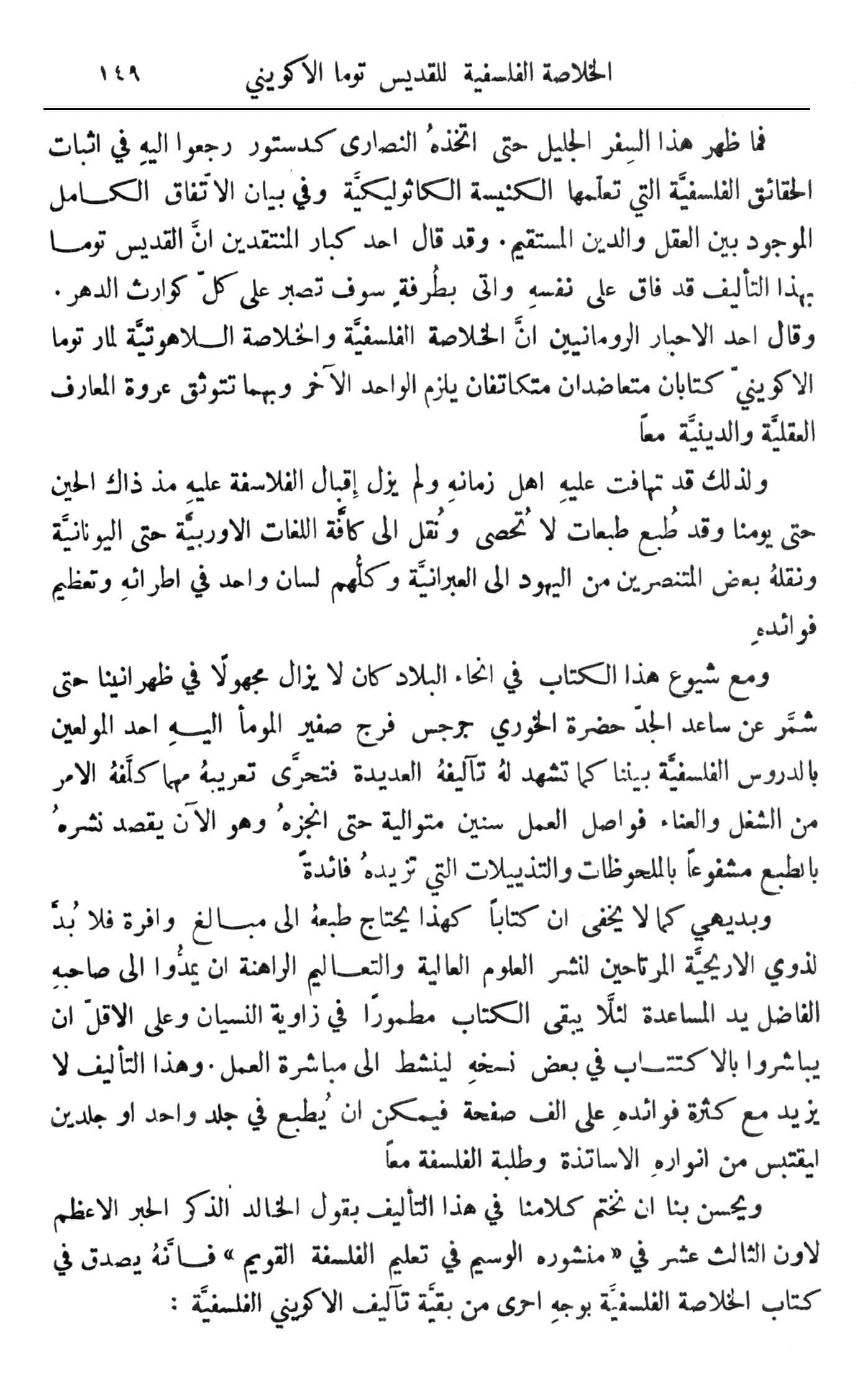
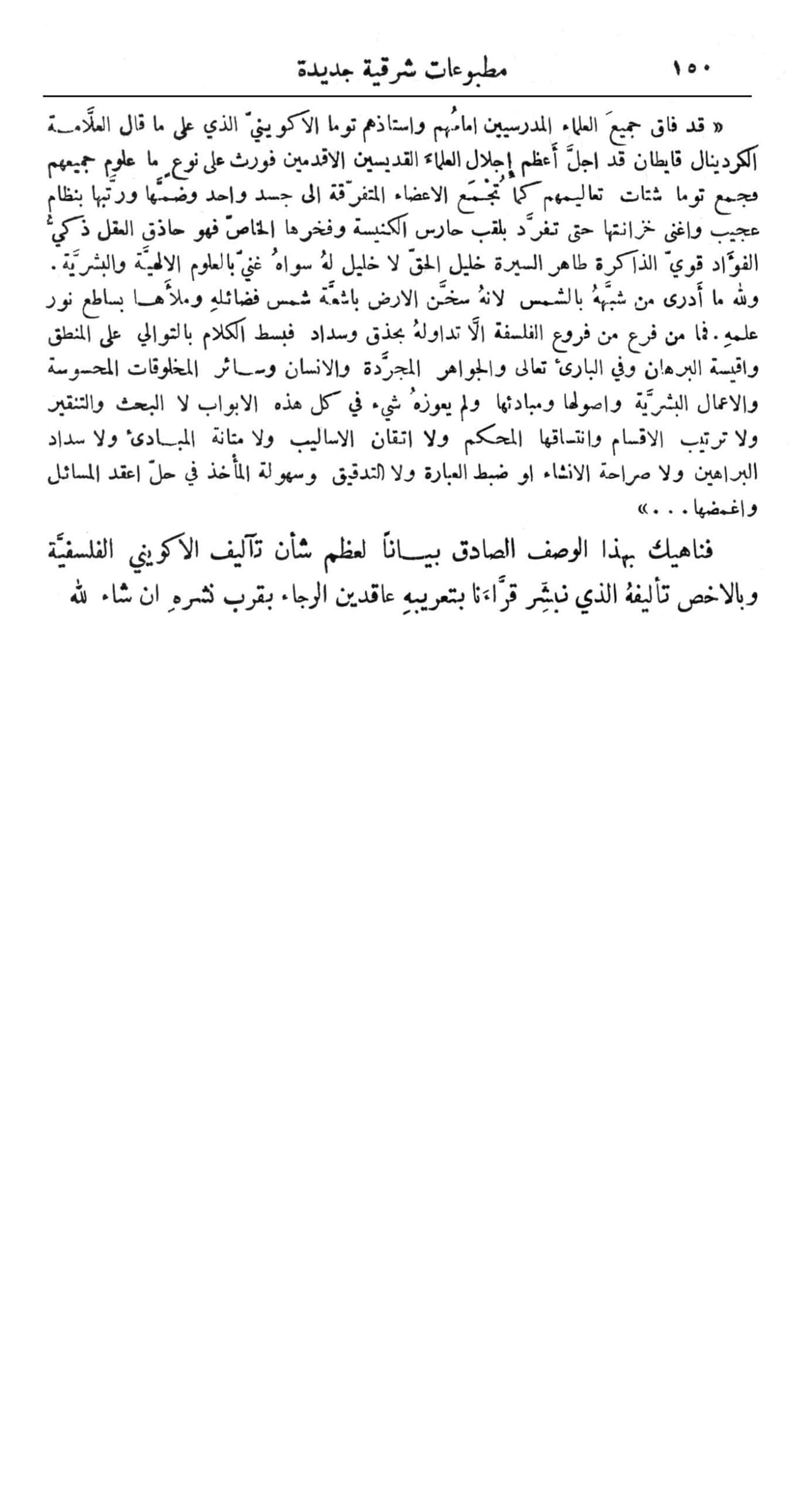


استقلالُ النِّيابة العامَّة وحِيادُها. مقاربةٌ دستوريَّةٌ وقانونيَّة – دراسة مقارَنة
سامر يونس
استقلالُ النِّيابة العامَّة وحِيادُها
مقاربةٌ دستوريَّةٌ وقانونيَّة – دراسة مقارَنة
ط.١، ٦٠٨ ص. بيروت: دار المشرق. ٢٠٢٥.
ISBN: 978-2-7214-8194-8
على يمين القوس…
يقف على يمين قوس المحكمة، قاضٍ، يمثِّل النِّيابة العامَّة، أو قُل يمثِّل مجتمعًا بكامله، بوكالةٍ ما، شعبيَّة. هكذا يفرض الادِّعاء العامُّ هيبته، بل موقعه، في مضبطة الجرائم، فتراه قاسي الملامح، يضرب بحسام القانون، يترافع مفنِّدًا ويعلن استقلاله، حتَّى، وخصوصًا عن المحكمة الَّتي على يساره! وبين يمينٍ ويسار، يُخيَّل إليك أنَّه طرف، لكنَّه في الواقع شديد التَّمسُّك بحياده، أو هكذا يراه، متمرِّدًا في الحقِّ، القاضي سامر يونس في كتابه عن دار المشرق استقلالُ النِّيابة العامَّة وحيادُها. مقاربةٌ دستوريَّة وقانونيَّة – دراسة مقارنة.
هذا الكتاب عنوانُ أطروحةِ دكتوراه في الحقوق، نالها القاضي سامر يونس في العام 2022 بدرجة جيِّد جدًّا من المعهد العالي للدُّكتوراه في الحقوق والعلوم الاقتصاديَّة والإداريَّة في الجامعة اللُّبنانيَّة، مع تنويه اللَّجنة الفاحصة والتَّوصية بنشرها. وها هو دار المشرق يتلقَّف وينشر ويعمِّم الفائدة على مساحة القضاء والمحاماة والأكاديميَّة والبحث العلميِّ. ربَّما لأنَّ المضمون يتخطَّى مجرَّد الكتاب والأطروحة، وربَّما لأنَّ الكتاب هو، فعلًا، عصارة ممارسةٍ وفكرٍ وما بينهما من شخصيَّة المؤلِّف.
من يعرف سامر يونس (أو يعرف عنه) يُدرك تمامًا أنَّ القلمَ، الَّذي خطَّ تأليفًا، يستمدُّ حبرَهُ من شرايينِ حامِلِهِ، وهي الَّتي حَمَلَتهُ إلى القضاءِ رسالةً، لا مجرَّد مهنة. قد أخدُشُ حياءَ أخلاقِه، لا من بابِ مجاملةٍ، لا هو ولا أنا نرتضيها، ولكن لاستحالةٍ عندي أن أفصلَ بين الكاتبِ والكتاب! كلاهُما واحد: في رصانةِ التَّأليف وفي بلاغةِ اللُّغة، في جوهرِ المضمون العميق وفي عمقِ البحثِ الجوهريِّ… كتابٌ في استقلال النِّيابة العامَّة وحيادها؟ كأنِّي بالكاتب، وصفًا!، مستقلٌّ إلى درجة إزعاجِ بعضِ من يهمِسُ في التَّعييناتِ والمناقلاتِ رأيًا، محايدٌ حيث الحياد واجب، إلَّا في الحقِّ، حيث يدفعُهُ عقلُهُ قبلَ قلبِه ليُدافعَ، شَرِسًا، عمَّن نالَهُ ظلمٌ من بني البشر، عندما هؤلاء يَنحدِرون إلى ما دونَ العدلِ، وهو، عنده، خطٌّ أحمر.
ولأنَّ القاضي يونس خدم في القضاء، (نعم، «خدم»)، محاميًا عامًّا في بيروت (كما في قضاء الحكم)، ولأنَّه خَبِرَ الظَّاهر والخفي وواجه بالحقِّ والقانون حالات متنوِّعة من المراجعات، ولأنَّه خرج منها كما دخلها، نقيًّا، مرتاح الضَّمير، فقد خرج أيضًا، وخصوصًا، بخلاصاتٍ ودروس مكَّنته من الجمع بين النَّظريَّة والتَّطبيق. لافتٌ جدًّا قوله، في تمهيد كتابه، إنَّه لم يعرف سوى أن يختار استقلال النِّيابة العامَّة وحيادها عنوانًا لأطروحته، وهو الَّذي شعر أنَّه ينتقل، «داخل القضاء نفسه، من جسمٍ إلى آخر، من روحٍ إلى أخرى، من طبعٍ إلى تطبُّع لم أستطع معه تأقلمًا أو تكيُّفًا»… لقد أعلن الدُّكتور يونس، منذ سطور مؤلَّفه الأولى، انتفاضةً علميَّة على الفصل القائم فعلًا بين «قاضٍ يدَّعي باسم الشَّعب والمجتمع، وآخر يحقِّق أو يحكم باسم هذا الشَّعب أو باسم هذا المجتمع ذاته». سيَّان عنده أكان القضاء واقفًا (قضاء النِّيابة)، أم جالسًا (قضاء حكم)، من حيث الاستقلال والحياد. مقاربةٌ غير تقليديَّة في مضمارٍ طَبَعَهُ التَّقليد، تعبِّر فعلًا عن جرأةِ مَن تولَّاها وحرِّيَّة فكره وصلابة دفاعه عن رؤيةٍ لا تنتمي إلى الموروث في أدبيَّاتنا بشأن النِّيابة العامَّة، يدفعه في ذلك حرصٌ واضح لتحصين القضاء الَّذي ينتسب إليه.
يأخذ القاضي المؤلِّف على واقع النِّيابة العامَّة خضوعها «التَّاريخيّ» لسلطة تسلسليَّة صارمة تقوم على حقِّ الإمرة وإصدار التَّعليمات، ما يهدِّد بتحويل قاضي النِّيابة العامَّة إلى مأمور، ويضرب استقلاله وحياده الواجبَين، وهو الَّذي يُفترض أن يكون محصَّنًا ومحميًّا من أيِّ خضوع أو تبعيَّة، حتَّى ولو تأتَّيا من سلطة تسلسليَّة وموجب «الطَّاعة». هل نسي أحدنا، في تاريخ لبنان الحديث، (ولا تعميم)، كم دخلت السِّياسة على القانون؟ بل على القضاء؟ هل يؤخذ على سامر يونس أن يكون، في بحثٍ علميٍّ رصين، قد ظهَّر، منتفضًا عليه، واقعًا فعليًّا غاب فيه الاستقلال أحيانًا، وحُرم فيه متقاضٍ من حقِّه في حياد النِّيابة العامَّة؟ وهذه الأخيرة هي محامي المجتمع والضَّامنة من أيِّ تعسُّف، أو هكذا يجب أن تكون؟
لقد خاض يونس غمار بحثه متنقِّلًا بين الأنظمة القضائيَّة عبر الحدود، داعمًا رأيه الإصلاحيَّ بأمثلةٍ عبر العالم، متوقِّفًا عند اجتهاد المحكمة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان، الَّتي أدانت افتقار النِّيابة العامَّة الفرنسيَّة لضمانتَي الاستقلال والحياد بسببِ خضوعِها إلى سلطةٍ تسلسليَّة ناجمة عن حقِّ إصدارِ «التَّعليمات الفرديَّة»، الَّتي غالبًا ما تكون شفهيَّة أو هاتفيَّة. وعلى نحوٍ مرتبط، لا يغيب الجانب الدُّستوريُّ عن الكتاب، حيث يذكِّر المؤلِّف أنَّ لبنان قد التزم في مقدِّمة دستوره، (الفقرة باء)، مواثيق الأمم المتَّحدة والإعلان العالميَّ لحقوق الإنسان، داعيًا إلى مواءمة القوانين الوضعيَّة الوطنيَّة والمواثيق الدَّوليَّة، مذكِّرًا أيضًا بالتَّوصيات ذات الصِّلة الصَّادرة عن «مجلس أوروبَّا»، في العام 2000، بشأن المبادىء التَّوجيهيَّةِ لاستقلال النِّياباتِ العامَّة الأوروبيَّة»، كما وتوصيات الأمم المتَّحدة، في شأنِ «المبادئ التَّوجيهيَّةِ المُطبَّقةِ على دورِ قضاةِ النِّيابة العامَّة»، في المؤتمر الثَّامن لمكافحة الجريمة المنعقد في كوبا في العام 1990.
وفي بحثه العميق في مكامن الخلل وفي نقده العلميِّ للمنظومة القانونيَّة الَّتي ترعى النِّيابة العامَّة، لم يكتفِ بعرض الواقع وإظهار ما يعتوِره من اضطرابٍ تراكميٍّ، تشريعًا وممارسة، بل ذهب إلى اقتراح تعديلاتٍ تشريعيَّة تهدف إلى ضبط السُّلطة التَّسلسليَّة بقيود تحول دون التَّعسُّف في التَّعليمات الَّتي تصدر عنها، كأن تكون خطيَّة، لا شفهيَّة. كما يقترح منحَ قاضي النِّيابة العامَّة حقَّ رفض تلك التَّعليمات، في حال كانت تخالِف قناعته! بل أبعد من ذلك، يقترح القاضي يونس إلغاء التَّعليمات الفرديَّة برمَّتِها، لما قد يشوبها من «شبحِ التَّسييس» والإبقاء على التَّعليمات العامَّة والمجرَّدة فحسب «Les instructions générales et abstraites» الَّتي يعود، عندها، للرَّئيس التَّسلسليِّ أن يتَّخذها. يُدافع الكاتب عن اقتراحه بالاستناد إلى ما يشوب ما اصطُلح على تسميته بالقضايا الحسَّاسة وهي، في الواقع، تلك المتعلِّقة بسياسيِّين أو بشخصيَّاتٍ عامَّة أو باعتباراتٍ ماليَّة – اقتصاديَّة.
يصرُّ القاضي سامر يونس في كتابه – المرجع على النَّظر إلى قاضي النِّيابة العامَّة على أنَّه خصم شريف في الملاحقة، منزَّه عن أيِّ موقف شخصيٍّ أو تبعيَّة، موضوعيٌّ، مهنيٌّ، شفَّاف ومتجرِّد، وُجهته الحقيقة، سواء ذهبت في اتِّجاه المدَّعي الشَّخصيِّ أم في اتِّجاه المشتبه فيه أو المدَّعى عليه أو المتَّهم. وفي السِّياق، يقترح إمكان تنحِّي قاضي النِّيابة إذا ما استشعر ظرفًا يهدِّد استقلاله وحياده.
هذا الحياد وذاك الاستقلال يحملان الكاتب، بجرأته المعهودة، على الدَّعوة إلى إصلاح قانونِ أصولِ المحاكماتِ الجزائيَّة اللُّبنانيِّ وتعديله، لا سيَّما في الشِقِّ المتَّصلِ منه بصلاحيَّاتِ النَّائب العامِّ التَّمييزيِّ، وحيث «إرادةٌ «غيرُ لبنانيَّة» قد شوَّهت، ولو بأدوات لبنانيَّة، ما كان يجب أن يكون عليه القانون المذكور.
وإلى الإصلاحات التَّشريعيَّة، يدعو القاضي سامر يونس إلى مناقبيَّة قضائيَّة تتخطَّى التِّقنيَّات. إنَّ التِّقنيَّات تُكتسب، أمَّا المناقبيَّات، فيخشى عليها من اهتمام لا يوليها دورها في تحصين القضاء. ربَّما تكون أحكام مشروع تنظيم القضاء العدليِّ واستقلاليَّته، الَّذي أقرَّه مجلس الوزراء بعد طباعة الكتاب، جزءًا مساهمًا في اتِّجاه عمليَّة التَّدريب المستمرِّ، إلَّا أنَّ الكاتب يعبِّر، مرارًا، عن ضرورة إصلاح نظام النِّيابة العامَّة وأحكامها التَّشريعيَّة، على اعتبار أنَّ هذه الأخيرة تبقى، هي، ضامنة الحقوق وحارسة الحرِّيَّات وحامية المجتمع، ومن دونها تبقى دولة الحقِّ مجرَّد مأمول، بما يذكِّر بالتَّرجمة غير الموفَّقة لـ «Etat de droit» بدولة القانون، فيما الحقُّ يعلو، كمفهوم مطلق، أمَّا القانون فمن صنع بني البشر وأهوائهم ومصالحهم.
بقَلَمِه المميَّز بذاته والموروث جينيًّا من والده الأديب الدُّكتور دياب يونس، يكتب القاضي والأستاذ الجامعيُّ عن مؤلَّفه: «هذا كتابٌ يُخاطبُ أرواحًا متمرِّدة وأجنحةً لا تنكسر». جبرانيَّات تذكِّر بأنَّ مغامرة سامر يونس الكتابيَّة الغنيَّة هي تعبيرٌ عن أجمل «الأرواح المتمرِّدة» ديمقراطيًّا وعلميًّا في كنف القضاء، ترفدُ «التَّائه» في «العواصف» القضائيَّة بأجنحةٍ تنقل السُّلطة الحامية والضَّامنة إلى ما يجب أن تكون: مستقلَّة وحياديَّة، من أجل النَّاس، كلِّ النَّاس. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وقد أحسن القاضي المؤلِّف خطواتٍ كثيرة، نيابةً عامَّةً عن أصحاب رأيٍ وعن أصحاب حقٍّ.
الدُّكتور زياد بارود : محامٍ بالاستئناف، ومحاضر في جامعة القدِّيس يوسف، ورئيس مجلس أمناء جامعة سيِّدة اللُّويزة. خدم وزيرًا للدَّاخليَّة والبلديَّات في حكومتَين متتاليتَين بين تمُّوز ٢٠٠٨ وحزيران ٢٠١١، وحازت الوزارة في أثناء ولايته المرتبة الأولى في جائزة الأمم المتَّحدة للخدمة العامَّة. بعد انتهاء خدمته الوزاريَّة، عُيِّن رئيسًا للَّجنة الخاصَّة باللَّامركزيَّة الإداريَّة الَّتي وضعت مشروع القانون الَّذي يناقشه مجلس النُّواب. له مؤلَّفات في الدُّستور واللَّامركزيَّة وقوانين الجمعيَّات والهيئة التَّعليميَّة.


Être et existant
Antoine Daher
Être et existant
ط.١، ١٨٠ ص، بيروت: دار المشرق، ٢٠٢٥
ISBN : 978-2-7214-1222-5
إنَّ المؤلِّف هو الطَّبيب المرموق والإنسانيُّ أنطوان ضاهر. وهو المحاضِر المتمرِّس في كلِّيَّة الصِّحَّة في الجامعة اللُّبنانيَّة. إلى جانب عمله، أكبَّ على مطالعة الأدب والفنِّ والفلسفة، وتدوين الخواطر الَّتي انبثقت من وجدانه، وعندما بلغ مرحلة التَّقاعد، شرع بتنظيم تلك الأفكار والتَّأمُّلات، فنُشرت بعد أعوامٍ ثلاثة على وفاته في دار المشرق، بفضل جهود ابنته السَّيِّدة دنيز ضاهر بستاني.
يتألَّف الكتابُ من قسمَيْن: الأوَّل (ص. ١٧-١١٠)، وعنوانه «الكائن». توسَّعَ فيه المؤلِّفُ بالكائن البشريِّ الحيِّ، الواعي، الاجتماعيِّ، الأخلاقيِّ، العاطفيِّ والمُفكِّر، وتطرَّق إلى إشكاليَّاتٍ عديدة كالحرِّيَّة، الحقِّ، الجسد، الأبديَّة، العدم، العالَم، الخلق والفكر. وفي الثَّاني (ص. ١١١-١٦٥)، وعنوانه «الموجود»، توقَّفَ عند ملفَّاتٍ ثلاثة: التَّصرُّف (أو العمل)، الجماليَّة، والموت. نعرض للقرَّاء ملفًّا مقتضبًا في القسمَين، ليستطيعوا اكتشافَ شيء من مقاربات الدُّكتور ضاهر الفلسفيَّة وآرائه:
– الكائنُ الأسمى (ص. ٧١-٧٧): سأل الكاتبُ عمَّا إذا كانت فكرة الله فطريَّة أم نتيجة الاستدلال المنطقيِّ؟ بدا له أنَّ الإنسان آمن بالألوهة منذ فجر التَّاريخ، فسجد للمخلوقات الَّتي استحسنها واستهابها، ثمَّ للآلهة الَّتي نسجها خياله، وأخيرًا للإله الواحد القدير والأبديِّ، مستطردًا إلى التَّباعدات والتَّناقضات بين أنبياء الدِّيانات المختلفة ورسلها، فنصح باختيار التَّعاليم الأقرب إلى الطَّهارة والنُّبل، رافضًا سعيَ الفلاسفة إلى إثبات وجود الله من طريق المنطق البشريِّ، فالإنسانُ يختار سلوك طريق الإيمان، ليس امتثالًا لبراهين عقليَّة، بل بعد عجزه عن تفسير دواعي الخلق، وقناعته بأنَّه لا يمكن أنْ يفتقر الوجودُ إلى المعنى.
– التَّوق إلى الجماليَّة (ص. ١٤٩-١٦٠): يُحسُّ المرءُ بالجمال ويعبِّر عنه غرائزيًّا، فإذا به يعبُر إلى عالم التَّأمُّل والإعجاب والتَّأثُّر الممتع. الفنُّ الأصيل لا ينسخ الواقعَ، بل يحكم عليه، كما أنَّه ينقل الإنسانَ التَّوَّاق نحو آفاقٍ مجهولة بعيدة عن الرَّتابة والحزن، ولذلك لا يعود هذا الإبداع مُلكًا شخصيًّا.
في المقدِّمة، أكَّد المؤلِّفُ أنَّه لا يحترف الفلسفة، بل هو مراقبٌ تمعَّنَ في البشر والوجود، وطبيبٌ فكَّر في المعنى بعد أن شاهد معجزة الجسم البشريِّ واحتكَّ بالموت (ص. ١٣). هدَف إلى إشراكنا في قناعاته الَّتي توصَّل إليها من خلال مسيرته واختباراته وقراءاته، علَّها تحثُّنا على الرَّغبة في الإجابة عن التَّساؤلات. فالإنسان «الَّذي وُجد مُرغمًا، باحثًا بلا كللٍ عن ذاته الهاربة منه، مدركًا أنَّه ضيفٌ في كيانه، راغب بإلحاحٍ بأن يصبح مالكًا ذاتَه» (ص. ١٧١).
أختم بفقرةٍ من الكتاب يتناول فيها الإيمان بالله : «من الثَّابت أنَّ الله حاضرٌ في اللَّاوعي الجماعيِّ. إنَّ الكسب من السُّجود له والإيمان به يفوق أضعافًا مُضاعفة ضرورةَ إثبات وجوده. فالله يظلُّ، بالنِّسبة إلى كثيرين، الحلَّ البسيط، السَّهل والمثاليَّ لإشكاليَّة الوجود. هو الَّذي خلق الكائنات، ومنحَها المعنى، ووجَّه مصيرَها. هو الدَّواءُ الشَّافي والملاذ الأخير عند الموت. هو أساسُ العدل والأخلاق والنِّظام الاجتماعيِّ. ينتج إيمانُنا به من عجزنا عن تفسير كلِّ ما يحيط بنا، ومن حاجتنا إلى عونه، ومن إملاءات عقلنا» (ص. ٧٦).
الأب غي سركيس : حائز درجة الدُّكتوراه في اللَّاهوت من الجامعة اليسوعيَّة الغريغوريَّة الحبريَّة (روما). أستاذ محاضر في جامعتَي القدِّيس يوسف، والحكمة. وهو كاهن في أبرشيَّة بيروت المارونيَّة. له مجموعة من المؤلَّفات الدِّينيَّة والتَّأمُّليَّة والفكريَّة في اللَّاهوت المسيحيِّ، وحوار الأديان والحوار الإسلاميِّ- المسيحيِّ، وبعضها من إصدار دار المشرق (نوبل للسَّلام… لمن؟، أؤمن… وأعترف، قراءة معاصرة في الإيمان المسيحيِّ، وإيمان في حالة بحث – النَّشاط اللَّاهوتيّ في المسيحيَّة، ودروس من الهرطقات، والبابا فرنسيس، صاحبُ الفطنة والسَّذاجة، جولةٌ في فكره اللَّاهوتيِّ).


البابا فرنسيس، صاحبُ الفطنة والسَّذاجة جولةٌ في فكره اللَّاهوتيّ
الأب غي سركيس
البابا فرنسيس
«صاحبُ الفطنة والسَّذاجة»
جولةٌ في فكره اللَّاهوتيِّ
ط.1، 180 ص. بيروت: دار المشرق، 2025.
ISBN: 978-2-7214-5681-6
تذخر المكتبة المسيحيَّة العربيَّة بكثير من التَّرجمات بشأن البابا الرَّاحل فرنسيس سواء في كتاباته أو عنه، لكنَّ ما كان ينقص مكتبتَنا المسيحيَّة نظرة مشرقيَّة عربيَّة أعمق في فكر الحبر الأعظم ولاهوته… وقد تمعَّن الأب غي سركيس، بحسِّه الرَّعويِّ وتعمُّقه اللَّاهوتيِّ، في هذه الرِّسالة، فقدَّم إلينا كتابًا هو من روح أسلوب البابا عينه، أي جذِلًا وبسيطًا وعميقًا، يأخذنا في «جولة» كما وعدنا، لا في فكر البابا اليسوعيِّ وحسب، بل في قلبه حيث كنزُه.
يُقال إنَّ «المكتوب يُعرف من عنوانه»، وهذا الكتاب يُعرف من مقدِّمته… فنستشفُّ مستوى الكتاب التَّحليليَّ الَّذي لا يستعرض المعلومات الدَّقيقة فحسب، بل يحلِّلها لاهوتيًّا وكنَسيًّا وكأنَّك، فعلًا، تدخل في عمق شخص البابا فرنسيس، وتعرف ما وراء المعلومة. يقدِّم الكاتب، ويشرح، ويحلِّل كلَّ مصطلح، فيبدِع، بطريقته التَّربويّة، في تعريف القارئ العربيِّ بما يمكن الإحاطة به فيما يخصُّ هذا البابا المميَّز.
وفي عالم يسهل الوصول فيه إلى المعلومة، يمكن القارئ أن يقع في فخِّ الكمِّ والسَّطحيَّة. لذلك، أصاب المؤلِّف في اختياره منهجيَّة كتابه، حين تناول رسائل البابا العامَّة وإرشاداته الرَّسوليَّة، وهي كثيرة وغنيَّة. لقد قدّم مضمون الوثيقة وتوجُّهاتها، معتمدًا أوَّلًا توضيح سبب اختيار البابا الموضوع، فمستخلِصًا العِبر للواقع المشرقيِّ العربيّ.
من هنا يبرز غنى هذا المؤلَّف بما يخصُّ كنيستنا… فالبابا فرنسيس يتوجَّه إلى العالم أجمع، وقد صدر معظم الوثائق باللُّغة العربيَّة، لكن، يبقى الرَّاعي هو من يؤدِّي دور الجسر الَّذي يصل المؤمنين بالكنيسة الجامعة، وهذا ما تصدَّى له الكاتب حين قدَّم الفكر الفرنسيسيَّ إلى مؤمنِي الشَّرق، موجِّهًا خطاهم في رحلة بحثهم الإيمانيَّة الشَّخصيَّة عن معنى وجودهم ورسالتهم في المشرق العربيِّ.
يشبه تقسيم الكتاب تقسيمات متاحف روما. فقد تختار زيارة جناح من دون غيره. وقد تختار التَّعمُّق والتَّذوُّق في غرفة، أو في عملٍ فنِّيٍّ على حساب آخر، كما في الكتاب الَّذي بين أيدينا، والَّذي لم يقسِّمه الأب سركيس التَّقسيم التَّقليديَّ، ولا جعله في أجزاء متسلسلة، بل اختار أسلوبًا مبسَّطًا في تناوله الموضوعات الأساسيَّة في فكر البابا والَّتي تعكس وثائقه المهمَّة: «البشارة، البيئة، العائلة، القداسة، الشَّبيبة، الانثقاف، الأخوَّة العالميَّة، المحبَّة المسيحيَّة، السِّينودسيَّة، كرامة الإنسان». وكأنَّ الكتاب موسوعة فرنسيسيَّة مصغَّرة، يمكن العودة إليها في كلِّ مرَّة يرغب فيها القارئ في التَّعمُّق في فكر البابا سواء أكان كاهنًا، أو خادمًا في كنيسة، أو باحثًا، أو مربِّيًا للتَّعليم المسيحيِّ… فهو يُناسب الجميع بأسلوبه المنهجيِّ العميق.
زيَّن الكاتب صفحات هذا المؤلَّف باقتباسات من النُّصوص الأصليَّة نفسها، وذيَّلها ببعض الأسئلة الَّتي تدعو المؤمنين والمؤمنات إلى التَّفكير في هويَّتهم المسيحيَّة المشرقيَّة، وماذا يعني اتِّباع المسيح اليوم؟
في الختام، لعلَّ القيمة المضافة لهذا الكتاب، هي في كونه يحثُّ القارئ على التَّفكير، ويجعله أقرب إلى منهج البابا «الكيميائيِّ»، الَّذي يجمع الحقائق ويفاعلها بعضها بعضًا ليُظهر حقيقة مبتكرة وأعمق.
الأب طوني حمصي اليسوعيّ : مدير التَّواصل الرَّقميِّ للرَّهبانيَّة اليسوعيَّة في الشَّرق الأدنى والمغرب العربيِّ. مشرف على النَّسخة الرَّقميّة للكتاب المقدَّس باللُّغة العربيَّة في ترجمته الكاثوليكيَّة. حائز شهادة ماجستير في اللَّاهوت الكتابيِّ – كلِّيَّة اللَّاهوت اليسوعيَّة – باريس، ودبلوم جامعيٍّ في الصِّحافة الرَّقميَّة، جامعة القدِّيس يوسف – بيروت. له العديد من التَّرجمات الصَّادرة عن دار المشرق.


المسيحيُّون الأوائل – الجزءان الأوَّل والثَّاني
ريمون رزق
المسيحيُّون الأوائل
ط.1، ج.1، 304 ص.؛ ج.2، 504 ص. بيروت: دار المشرق. 2024
(ج.1) ISBN: 978-2-7214-5676-2
(ج.2) ISBN: 978-2-7214-5677-9
صدر عن دار المشرق مجلَّدان عن تاريخ الكنيسة بعنوان المسيحيُّون الأوائل. ويبدو أنَّها سلسلة ستتضمَّن سبعة مجلَّدات، بحسب ما ورد في المقدِّمة.
الجزء الأوَّل
يهتمُّ الجزء الأوَّل بالقرن الميلاديّ الأوَّل، من القيامة إلى تدمير أورشليم (30-135).
الفصول الثَّلاثة الأوَل، من هذا الجزء، تعتمد اعتمادًا شديدًا على ما ورد في العهد الجديد لتتوسَّع فيه، من خلال اكتشافات التَّنقيبات الأثريَّة، وتصف لنا طبيعة حياة المسيحيِّين في القرن الأوَّل، وخصوصًا أماكن العبادة الَّتي ارتادوها.
الفصلان الرَّابع والخامس مخصَّصان للصَّلوات. التَّمهيد يبدأ بالفصل الرَّابع حيث يُشار إلى محوريَّة المسيح في الصَّلوات، ويعرض الفصلُ الخامس نماذج للصَّلوات. وبسبب شحِّ النُّصوص الَّتي أتتنا من تلك الفترة، يعتمد الكاتب كثيرًا على الصَّلوات الَّتي وردت في العهد الجديد، ويرى فيها نماذج للصَّلوات المسيحيَّة في ذلك الوقت.
بعرضٍ موجزٍ ووافٍ، يتناول الفصل السَّادس التَّعاليم والكتابات المسيحيَّة، بمعنى تشكُّلِ كتب العهد الجديد التَّدريجيّ، ويليه الفصل السَّابع المخصَّص للحياة التَّقويَّة والأسرار. وحيث إنَّنا في بدايات الكنيسة، لا يُطرَح هنا سوى سرَّين: الإفخارستيَّا أوَّلًا والمعموديَّة ثانيًا؛ وترتيب الطَّرح يأتي من أهمِّيَّة دور السِّرّ في الجماعة المسيحيَّة الأولى لا من تسلسل منحه الكرونولوجيّ. يُضاف إلى هذَين السِّرَّين واجب العناية بالفقراء وكأنَّ الكاتب يضعه في مرتبة السِّرِّ لجوهريَّته في الإيمان المسيحيّ (في الجزء الثَّاني سيطلَق عليه اسمُ السِّرّ).
الفصل الثَّامن يعرض «نسيج الجماعات المسيحيَّة الاجتماعيّ». اللَّافت في هذا الفصل هو المساحة الَّتي يخصِّصها الكاتب للمرأة ودورها في الكنيسة الأولى، وهي أكثر من نصف الفصل. هذا الدَّور انحسر تدريجيًّا مع تقدُّم العصور.
تتتالى بعد هذا الفصل الموضوعاتُ المعهودة: شخصيَّات بارزة من القرن الأوَّل، ويتمُّ الإلحاح على عرض فكرها أكثر منه عرض بيوغرافيَّتها. وعلى الرُّغم من أهمِّيَّة شخصيَّات الرُّسل، اختار الكاتب ألَّا يذكرها هنا، وقد أحسن في فعله ذلك، إذ يتميَّز الكتاب بعرض ما يُعتقَد أنَّه جديد على القارئ العاديّ، والحال، فإنَّ شخصيَّات الرُّسل معروفة لدى الجميع. يلي ذلك فصل يعطي لمحة موجزة عن الاضطهادات، ويليه آخر عن الهرطقات، ليُختتَم الكتاب بخلاصةٍ وخاتمة.
الجزء الثَّاني
يتناول الجزء الثَّاني القرنَين الثَّاني والثَّالث الميلاديَّين (136-260)، ويحمل العنوان الفرعيّ: «من بداءة الأدب المسيحيّ إلى الاضطهاد». يبدأ هذا الجزء بفصل قصير جدًّا هو بمثابة مقدِّمة تُعرَض فيها مكوِّنات الجماعة المسيحيَّة في تلك الفترة. يليها فصلان طويلان ومهمَّان: الأوَّل، ودائمًا في تلك الفترة، عن «الوجوه المسيحيَّة في الشَّرق»، والثَّاني عن «الوجوه المسيحيَّة في الغرب وأفريقيا».
بطريقة موسوعيَّة، يقدَّم كلُّ وجه بإيجاز، وتُعرَض أفكارُه والقضايا الَّتي تناولها. بعض الوجوه معروفة ولها كتب بالعربيَّة تتكلَّم عليها، وبعضها الآخر غير معروف. ولأسبابٍ صائبة، ركَّز فصل الوجوه الشَّرقيَّة على رجال الفكر وليس على البطاركة، في حين أنَّه تخطَّى، في الوجوه الغربيَّة، هذه القاعدة، وذكر باباوات روما من بين الوجوه، مع أنَّ عددًا منهم لم يشتهر بأعماله الأدبيَّة ولا بقراراته. السَّبب، برأيي، هو أنَّ قرارات مهمَّة اتَّخذها باباوات كنيسة الغرب حينها كان لها أثر في المسيحيَّة عامَّةً، ولذلك توجَّب أن يُشار إليهم. وإذ يخرج عن هذا المعيار واحدٌ أو اثنان منهم، ارتأى الكاتب، وهو على حقٍّ، أن يضع القائمة كاملةً من أجل الفائدة. لذلك راعى ذكرهم في فئةٍ واحدة، مع نبذة قصيرة عن كلٍّ منهم.
الفصل الرَّابع عرضٌ شامل لأبرز النُّصوص المسيحيَّة المنحولة، مع تحليل كافٍ لمضمونها ليكوِّن القارئ فكرةً عنها. في هذا الفصل نجد ذكرًا لكلِّ الكتب الَّتي أرادت أن تتشبَّه بأسفار العهد الجديد، سواء الأناجيل أو الرَّسائل أو أعمال الرُّسل، الَّتي تُعرَف اليوم بالكتابات الأبوخريفيَّة.
الفصل الخامس يتناول باقتضابٍ مريح ما تميَّزت به تلك الفترة: الانتشار المسيحيّ. أمَّا الفصل السَّادس فيعيد ما ورد في الجزء الأوَّل عن الكنائس البيتيَّة، مشيرًا إلى سِماتها في القرن الثَّاني. إنَّها لم تعد بيوتًا للسَّكن بل صارت بيوتًا خضعت هندستها للتَّعديل لتلبِّي حاجة العبادة. نحن أمام بدايات ما سيسمَّى: الكنيسة.
وعلى خُطى الجزء الأوَّل، تأتي فصولٌ تتكلَّم على الصَّلوات في ذلك العصر، والأسرار الَّتي بدأت تأخذ طابعًا ليترجيًّا. هنا أيضًا نجد عرضًا لسِرَّي الإفخارستيَّا والمعموديَّة، يتوسَّطهما «سرُّ خدمة القريب»، أي الاهتمام بالمحتاجين، ويضاف إلى الثَّلاثة سرٌّ جديد هو سرُّ المصالحة. ولأنَّ شروط منح المعموديَّة بدأت تتوضَّح، أفرز لها الكاتب فصلًا قصيرًا (الفصل العاشر) يعرض تحضير الموعوظين لنَيل هذا السِّرّ، يليه آخر قصير أيضًا عن الأخلاق المسيحيَّة .
التَّنظيم الكنسيّ، أو الهيرارخيَّا، الَّذي بدأ يتَّضح، معروضٌ في الفصل الحادي عشر، تليه علاقة الكنيسة بالدَّولة، وهي علاقة تسبَّبت باضطهاد المسيحيِّين. فيعرض الفصل لمحةً موجزة عن الاضطهادات وبعض الوجوه البارزة للشُّهداء.
تحت عنوان الخلافات الدَّاخليَّة والخارجيَّة، يعرض الفصل الثَّالث عشر جميع الهرطقات الَّتي ظهرت في تلك الحقبة. وبعد ذلك يأتي فصلان يتناولان مسألة الفنِّ الكنسيّ. فقد ظهر هذا الفنُّ في الدَّياميس، وبالتَّالي يتناول الفصلُ الرَّابع عشر موضوع المقابر، ويتوسَّع فيه ليشمل كلَّ الفنِّ الكنسيّ الَّذي بدأ بالظُّهور في تلك الحقبة تعبيرًا عن الإيمان.
نظرة عامَّة
تتميَّز فصول هذَين الكتابَين بأنَّها قصيرة من ناحية الحجم، تتفادى الاستفاضة الممِلَّة، وهي مزيَّنة بالصُّور، ما يجعل القراءة ممتعة حتَّى لمَن ليس متآلفًا مع قراءة الكتب. الملاحظة الَّتي لفتت انتباهنا هي الصُّور المستخدمة. لا شكَّ في أنَّها تضفي أجواء على النَّصِّ، لكنَّها في بعض الأحيان بدت كثيرة نوعًا ما، بحسب رأينا.
الأب سامي حلَّاق اليسوعيّ : راهب يسوعيّ، وأستاذ في جامعة القدِّيس يوسف – بيروت. له مؤلَّفات وترجمات عدَّة منشورة، بالإضافة إلى مقالاتٍ بحثيَّة في مجلَّة المشرق.


الحبُّ… مساحة أمان وتقدير
الحبُّ… مساحة أمان وتقدير
ط.1، 128 ص. بيروت: دار المشرق، 2025
ISBN: 978-2-7214-5678-6
«الحبُّ هو أروع وأنبل شعور يمكن أن يسكن قلبنا، وأجمل كلمة ترنُّ بعمق في وجدان كلِّ إنسان…» (ص. 7). بهذه الجملة، يفتتح المؤلِّف مقدِّمة كتابه، وحيث «نتطلَّع إلى هذه المساحة من الحياة التي تحقِّق أملنا في الحبِّ، وما يعنيه من شعور بالأمان والتَّقدير» (ص. 7).
اعتمد المؤلِّف، الأب نادر ميشيل، في بحثه الأنثروبولوجيِّ هذا، على الإصغاء إلى النَّاس محاولًا فهم ما يعبِّرون عنه وما يعيشونه، فيبدأ، في الفصل الأوَّل، «بتوضيح معنى الأمان والتَّقدير» (ص. 11-12)، متطرِّقًا إلى «مكانة الكلمة» (ص. 16-17) في حياة البشر، ومعنى وجودهم حيث يعيش الإنسان في «جسد مجنَّس»، تشدُّه الرَّغبة نحو الآخر. هنا، يتوقَّف المؤلِّف أمام واقع الإنسان البشريِّ الباحث عن اللَّذَّة والمُعاني من الألم، متلمِّسًا معنى الحياة الحقيقيَّ. «وفي هذا كلِّه نسمع صوت الله الَّذي يتكلَّم في قلبنا ومن داخل واقعنا الإنسانيّ، ويعلِّمنا طريق الحبِّ الحقيقيِّ» (ص. 9).
ثمَّ يورد المؤلِّف «شروط الأمان والتَّقدير في أيِّ علاقة» (ص. 17-19).
في الفصل الثَّاني من الكتاب (ص. 41-67)، وعنوانه «مظاهر عيش الأمان والتَّقدير»، يعرض المؤلِّف بحث الإنسان عن الحبِّ والأمان والتَّقدير في واقع حياته، وطريقة عيشه الرَّغبة ومظاهرها الصَّحيحة وغير الصَّحيحة. وهو، في الاتِّجاهات الأخيرة، يُشير إلى «الانغلاق على الذَّات، والتَّسلُّط والبحث عن القوَّة، والتَّلاعب بالمشاعر، والنِّفاق والتَّملُّق»، حيث إنَّ الإنسان مدعوٌّ دومًا إلى مراجعة ذاته ليعي في أيِّ اتِّجاهٍ تمضي حياته.
في الفصل الثَّالث (ص. 69-88) يقترح علينا الأب ميشيل فتح الإنجيل، والاقتداء بيسوع المسيح في بحثه عن الأمان والتَّقدير، وقد وهبَهما للنَّاس الَّذين يحيطون به. فبالنِّسبة إليه، «إنَّ قراءة الإنجيل توضح وتعمِّق» البحث الأنثروبولوجيَّ عن الحبّ.
في الفصل الرَّابع (ص. 89-107) دعوة إلى أن نستمرَّ في اتِّباع يسوع «فنلتقي معه» أشخاصًا مثل نيقوديمس، مرتا ومريم ولعازر، والمرأة السَّامريَّة. لقد التقاهم يسوع ودخل معهم في حوار انطلاقًا من واقع حياتهم، وسار معهم نحو طريق النُّور والحياة، ما يجعلنا نقتدي به في حبِّه التَّقيِّ والعميق للآخر الَّذي كان يلتقي به.
وفي النِّهاية، يقول المؤلِّف بضرورة التَّأمُّل بيسوع «نبع الحبِّ والأمان والتَّقدير» وهذا ما يشير إليه عنوان الكتاب الَّذي يستمدُّ معناه من التَّأمُّل بيسوع.
إنَّ الهدف الَّذي سعى إليه الأب ميشيل في بحثه المتوغِّل عميقًا في كينونة الإنسان، هو الإفادة الَّتي سيعود بها الكتاب على القُرَّاء سواء كانوا من الشَّبيبة، وهم في سعيٍ دائم إلى فهم معنى الحبِّ، أو من المتزوِّجين ومَن يستعدُّون للزَّواج، أو الرُّهبان والرَّاهبات في مراحل تكريس حياتهم لمجد الرَّبِّ، أو كلِّ شخص يبغي أن يعي نداء الحياة الحقيقيَّة، من أجل أن يغرِفوا جميعًا من معنى الحبِّ الحقيقيِّ من يسوع المسيح، نبع الحبِّ والمحبَّة.
ويوضح صاحب الكتاب أنَّ القارئ لن يجد إجابات جاهزة، بل على القارئ أن يستنير بالكلمات الَّتي تُغنيه من خلال قراءة الإنجيل، كلمة الحياة، وهي «كلمة مترسِّخة في الله » (ص. 16)، فيستمدُّ منه معنى حياته وتوجُّهاته.
في نهاية كلِّ فصل من الفصول الأربعة، يطرح المؤلِّف بعض الأسئلة الَّتي تساعد القارئ على «مراجعة ذاته»، كما يعرض بعض النُّصوص الكتابيَّة الَّتي تغذِّي صلاته وتأمُّله.
كلُّ فصول الكتاب تتنفَّس مساحة من التَّواصل والمحبَّة تساعد الإنسان في مساره نحو عيش الحياة الَّتي دعا إليها الرَّبُّ يسوع بهديٍ من نور كلمة الله الَّتي تبدِّد الظُّلمات، وتُزيح غمامة اليأس من قلب الإنسان.
الدُّكتورة بيتسا استيفانو: حائزة شهادة دكتوراه في العلوم الدِّينيّة، وإجازة في الآداب العربيَّة ودبلوم في علم النَّفس من جامعة القدِّيس يوسف في بيروت. أستاذة محاضرة في معهد الآداب الشَّرقيّة في الجامعة، ومسؤولة عن الأبحاث في مكتبة العلوم الإنسانيَّة فيها. أستاذة محاضرة في الجامعة الدُّومينيكيَّة – باريس. ولها العديد من المقالات المنشورة باللُّغتيَن العربيَّة والفرنسيَّة.


سقوط مدينة الأنا
سقوط مدينة الأنا
ط.١، ١٩٢ ص. بيروت: دار المشرق. ٢٠٢٥
ISBN: 978-2-7214-0007-9
يقدِّم أنطوان أبو جودة، في روايته سقوط مدينة الأنا الصَّادرة عن دار المشرق، ضمن «سلسلة أقلام جديدة» الَّتي تُشجِّع المواهب الأدبيَّة الشَّابَّة، الفكرة الفلسفيَّة أو الدِّينيَّة بأسلوب أدبيٍّ مشحونٍ بالصُّور والتَّساؤلات الذّاتيَّة والحوار المكتنز بالأفكار في سعيها الدَّائم إلى إجابات عن مصير الإنسان.
يعتمد المؤلِّف أدوات السَّرد الرِّوائيِّ انطلاقًا من تجربته في مقاربة التَّحدِّيات، وفي مواكبة بحث يفشل مرارًا في العثور على أجوبة عن معنى الحياة الحقيقيَّة والوجود. قد يبدو المشهد مشابهًا للسَّعي إلى الوصول إلى الأرض الموعودة الَّتي يراها المرء من بعيد، ولكنَّه لا يدخلها.
توجَّه المؤلِّف بإهدائه «إلى كلِّ الصغار الَّذين سقطوا في حروب الكبار، كبار الأنا» (ص.5)، فمواجهة الأنا هي قضيَّة إيجابيَّة للوقوع على وضوحٍ في الرُّؤية اختصرتها الرِّواية من «مغادرة الأنا» مدينتَها في الصَّفحة الأولى (ص. 7)، وهي «مدينة ظلاميَّة من كلِّ الأزمنة» (ص. 7)، حيث تبرز التَّناقضات والثُّنائيَّات كما بين العمَّال والفلَّاحين الكادحين الَّذين «يعيشون في بيوت فقيرة جدًّا» (ص. 7) والأغنياء الَّذين يتمتَّعون بحياة هانئة في «السُّوق، الَّذي هو، ساحة واسعة ونظيفة نسبيًّا» (ص. 8).
تخبر الرِّواية عن مدينة الأنا وكذلك عن قصَّة «نمُّول» (ص. 7) «رجلِنا الفقير الحالم» (ص. 10)، والَّذي «يقتات بعضًا من النَّمل لتخفيف وطأة الجوع» (ص. 14)، من هنا أتى لقبه.
تتنقَّل مشاهد الرِّواية في مطارح عدَّة، وفي مهنٍ مختلفة بأنواعها وجغرافيَّتها، من بائع الطُّيور، ورجل الدِّين الصَّالح، والآخر الطَّالح، إلى الرَّاقصة، والصَّيَّاد والشَّبكة، ثمَّ النَّاسك وغيرهم، وصولًا إلى دبي، الصِّين، التِّيبت، الهند، ولبنان… فيشير هذا التَّنوُّع إلى ضياع عبثيٍّ في البحث عن المدينة المقدَّسة، وهي رحلة الرِّواية، أساسًا، تقميشًا وتساؤلات.
وقد أتى بروز بعض الشَّخصيَّات الغامضة في الرِّواية تسهيلًا للحبكة الرِّوائيَّة وتوضيحًا لمسرى البنية القصصيَّة، كما في بائع الطُّيور (ص. 17) وحيث تظهر شخصيَّة «الكسيح» «الَّذي اختفى بعد أن وعد «نمُّول» بإرشاده إلى طريق المدينة المقدَّسة (ص. 15)، ولكنَّ نمُّول يهتدي أخيرًا، من خلال التَّأمُّل في صنائع الله، إلى «الحياة الرُّوحيَّة» (ص. 74)، والَّتي يبحث عنها كلُّ إنسان على تنوُّع حالاته الاجتماعيَّة ومشاكله.
لقد كان من اللَّافت تكرار الصُّدف في الحبكة، والَّذي بدا، وكأنَّه لخدمة سياق السَّرد ليس أكثر، فيما انبسط الخيال على مساحات واسعة من سقوط مدينة الأنا، ومعها اتَّسع فضاؤها الرِّوائيّ، وتمدَّد ليطال جغرافيا واسعة وإنْ ظهرت مشتِّتة أحيانًا، حتَّى الاهتداء إلى أنَّ مفتاح أسرار الحياة الحقيقيَّة هو في إسقاط الأنا من خلال جناحَي الحبِّ والإيمان «الله يريدكنَّ أصحَّاء روحيًّا وكاملات في الحبِّ، سرِّ السَّعادة الأبديَّة، لكنَّ هذا ليس ممكنًا إذا فضَّلتنَّ الانفصال عنه. فالأنا هي حائط يرتفع بينكنَّ وبينه، لا تتردَّدنَ في تحطيمه» (ص. 118).
وستكون محطَّة الرِّواية النِّهائيَّة، مع تعرُّف «نمُّول» إلى ناسك من لبنان يتزيَّن بفضائل: التَّواضع، الطَّاعة، التَّمييز، والإحسان (ص.149)، فيفهم مغزى وصيَّته: «انطلِقوا غدًا عائدين إلى مدينة الأنا، ومتى وصلتم، أنذروا الجميع كي يغادروا المدينة، فمن يترك الأنا ينجو، ومن يمكث فيها يهلك» (ص. 159). وهكذا تعثر الشَّخصيَّة الرَّئيسة في الرِّواية على خلاصها، لتبدأ الحقبة الجديدة (ص.183)، بتوجُّه «النَّاجين إلى الوادي المقدَّس في لبنان» (ص.185)، حيث تتجلَّى حكمة المدينة المقدَّسة بقول النَّاسك: «إمَّا أن نعبد الله وننمو في المحبَّة، أو نعبد الأنا وننمو في الأنانيَّة، وبين هاتين النَّزعتين يتخبَّط الإنسان (ص. 188)، وما يزال.
الدُّكتور جان عبد الله توما: حائز شهادة دكتوراه في اللُّغة العربيَّة وآدابها من الجامعة اللُّبنانيَّة. أستاذ محاضر في جامعات: القدِّيس يوسف، واللُّبنانيَّة، وسيِّدة اللَّويزة، ويشغل منصب رئيس قسم اللُّغة العربيَّة في جامعة الجنان. له تسعة عشر إصدارًا من كتب أدبيَّة، وشعريَّة، وروايات، ودراسات تربويَّة، وتحقيق مخطوطات.


ذكريات الحصار، مع الأب فرانس فان در لوخت اليسوعيّ
بهجت الحوش
ذكريات الحصار، مع الأب فرانس فان در لوخت اليسوعيّ
ط.١، ١٢٠ ص. بيروت: دار المشرق. ٢٠٢٥.
ISBN: 978-2-7214-0008-6
تظهر على الغلاف كلمة رواية، لكنَّ الكتاب أكثرُ من رواية، إنَّه وثيقة تاريخيَّة حقيقيَّة لم يكتبْها مؤرِّخ بل شاهد، ويمكن اعتمادها مرجعًا أكاديميًّا ومصدرًا للتَّوثيق.
الكتاب (أو الرواية) يسرد أحداثًا، بشكل لوحاتٍ حصلت بالفعل في مدينة حمص حين حاصَر الجيش السُّوريّ جماعات المسلَّحين المناهضة لنظام بشَّار الأسد، وحاصر معهم مجموعةً كبيرة من المدنيِّين الَّذين لم يتمكَّنوا، لسببٍ من الأسباب، من الفرار قبل أن يُفرَض طوقُ الحصار. ومن بين هؤلاء شخص اختار البقاء مع مَن بَقُوا، لأنَّه كاهن كرَّس نفسه لخدمة الرَّبِّ من خلال خدمته للإنسان. لقد شعر بأنَّه راعٍ لهؤلاء المدنيِّين، والرَّاعي الصَّالح لا يترك خرافه في الأزمة وينجو بنفسه. إنَّه الأب فرانس فان در لوخت اليسوعيّ.
وشاءت الظُّروف أن يكون مع هذا الرَّاعي شابٌّ أنهى دروسه الجامعيَّة، يحبُّ فتاةً، وخطبها، ويبحث عن عملٍ في مدينةٍ توقَّفت فيها كلُّ الأعمال. في فترة الفراغ هذه، طُلِبَ منه تطوُّعٌ شكلُه بسيط جدًّا: أن يقيم في الدَّير مع الأب فرانس كي لا يكون وحده، وأن يساعده في أعماله الإنسانيَّة.
لم يتردَّد هذا الشَّاب، وهو مؤلِّف الكتاب، في الموافقة. فقد تربَّى على روح الخدمة منذ نعومة أظافره، سواء في البيت أو في «الدَّير»، أي دير الآباء اليسوعيِّين الَّذي كان يتردَّد إليه. وعلى كلِّ حال، ليس لديه عمل يمنعه من قبول هذه الخدمة. فأقام في الدَّير، وهنا بدأت الحكاية. فقد حوصر مع الأب فرانس، ورضي بذلك ولم يهرب. وكان شاهدًا على أحداثٍ تجعل القارئ محتارًا تجاه ردَّة الفعل المناسبة لما يقرأه. هل يضحك، هل يتألَّم، هل يبكي، هل يشكر الله على رعايته؟ خليطٌ عجيب من هذه المشاعر في كلِّ مشهد: رائحةُ البول الخانقة لعجوز معوَّقة تعيش في القبو وتخدمها أختها الثَّرثارة الأكبر منها سنًّا، تركُ التَّابوت يسقط على الأرض وخروج الجثَّة منه للاحتماء من القذائف التي بدأت تنهار على المقبرة، ابتسامةُ طفل فقَد ساقه لقطعة سكاكر قدَّموها له، نبشُ قبرٍ وفتحُ تابوتِ عجوزٍ ماتت قبل شهر لدفنِ أختها إلى جانبها لأنَّ التَّوابيت نفدت…
لقد حاول الكاتب إبراز شخصيَّة الأب فرانس وعملَه الإنسانيّ: إسعافُ الفقراء والمعوزين، علاقاتٌ إسلاميَّة مسيحيَّة، تضامنٌ وتآخٍ بين جميع أطياف المحاصرين من أغنياء وفقراء، كبارًا وصغارًا، محاربين ومدنيِّين، مسيحيِّين ومسلمين… كما حاول الكاتب – الشَّاهد إخفاءَ نفسه قدر الإمكان، وعدم ذكر الدَّور الَّذي مارسه كمساعد للأب فرانس، والاستشارات بينهما، والقرارات المشتركة. لقد كان معه في كلِّ عمل إنسانيّ، وخاطَر معه بحياته مرارًا، وتعرَّض معه للقنص والقصف، لكنَّه لم يتباهَ بذلك بل بالعكس، سلَّط، في بعض الأحيان، الضَّوء على ضعفه وتردُّدِه، وعلى مساندة الأب فرانس له.
تمّ تأليف هذا الكتاب، وقرَّر الكاتب نشره في أيَّام حُكم الأسد مع كلِّ ما في هذه الخطوة من مخاطرة. الأسماء المذكورة فيه ليست الأسماء الحقيقيَّة. فالمطَّلعون على الأحداث يعرفون مثلًا أنَّ المصوِّر فارس هو باسل شحادة الَّذي كان يوثِّق الأحداث وقُتِلَ. وحرِص الكاتب على ألَّا ينحاز لأيِّ طرف، وحرصُه هذا لم ينبع من خوف. فحين سقط النِّظام سُئل عمَّا إذا كان يريد تعديل شيء في كتابه قبل أن يُطبَع، فالأحوال تغيَّرت، ويمكنه الكلام الآن بحرِّيَّة. لكنَّه رفض إجراءَ أيِّ تغيير، لأنَّه نهَج في كتابته منهجَ الأب فرانس: عدم الانحياز لأيِّ طرف كي نتمكَّن من أن نكون عناصرَ وفاقٍ ومصالحة.
فصول الكتاب قصيرة، مكتوبة بلغةٍ جذلة، تروي الأحداثَ بأمانةٍ ومن دون تضخيمٍ أو زخرفة. كثيرون قرأوه وقالوا: مَن يبدأ بقراءته لن يتركه حتَّى ينهيه.
الأب سامي حلَّاق اليسوعيّ : راهب يسوعيّ، وأستاذ في جامعة القدِّيس يوسف – بيروت. له مؤلَّفات وترجمات عدَّة منشورة، بالإضافة إلى مقالاتٍ بحثيَّة في مجلَّة المشرق.


مقالات العدد السابق
عبثيَّة الحروب والحقُّ في الحياة
تُعدُّ الحروب واحدةً من أقدم الظَّواهر وأبشعها الَّتي عرفتها البشريَّة، وتترك آثارًا عميقة على المجتمعات والأفراد. وعلى الرُّغم من التَّقدُّم الَّذي أحرزته البشريَّة في مختلف المجالات، إلَّا أنَّ الحروب لا تزال تفتك بالبشر وتدمِّر الحضارات. وما يجري على أرض لبنان...
موقف الكنيسة من الدَّولة بين الرَّفض والقبول- قراءة في خِبرة الكنيسة في القرنَين الثَّاني والثَّالث
في القرنين الثَّاني والثَّالث اضْطلعت الكنيسة، الَّتي غالبًا ما يُطلَق عليها اسم «كنيسة الشُّهداء»، بدور حاسم في تحديد علاقتها بالدَّولة. في أثناء تلك الفترة، ورغم أنَّ الكنيسة كانت تُصلِّي من أجل أصحاب السُّلطة، فقد كانت تعارض بشدَّة تلك السُّلطة عندما كانت تطالبُها...
لويس ماسينيون والقضيَّة الفلسطينيَّة
يُلاحَظ صمت نسبيّ من جانب المرجعيَّات الدِّينيَّة الكبرى تقليديًّا، المسيحيَّة والإسلاميَّة، أمام هول العنف واستمراره في الأراضي المقدَّسة. يكرِّس هذا الصَّمت حالة تراجع مطَّرد عن أخذ الجانب الرُّوحيّ لقضيَّة فلسطين بعين الاعتبار من قِبل جهات نفترض أن تكون معنيَّة...
المجتمع والدُّستور والدَّولة عند أرنست-فولفغانغ بوكنفوردي
تناقش هذه المقالة نظريَّة أرنست فولفغانغ بوكنفوردي الدُّستوريَّة . صاحبُها الفيلسوف والدُّستوريّ الألمانيّ، الَّذي يربط البعد الاجتماعيّ السِّياسيّ في قيام الدُّستور بـ «روح الشَّعب»، باعتباره سلطة تأسيسيَّة بأصوات ممثّليها. لكنّ بوكنفوردي يضيف عوامل أخرى في هذه...
دور مدينتَي بيروت واﻹسكندريَّة في تجارة الحرير بين السَّلطنة المملوكيَّة وأوروبَّا
إبَّان العصر المملوكيّ، عرفت مدينتا بيروت والإسكندريَّة تطوُّرًا اقتصاديًّا، وكان لهما دور رئيسيّ في تجارة الحرير، إذ إنَّ تصدير الحرير إلى أوروبَّا كان محصورًا بمينائَي هاتين المدينتين فحسب، ما جعلهما مقصدًا للتُّجَّار الأوروبِّيِّين وفي طليعتهم التُّجَّار البنادقة...
العمل التَّعاونيّ معيار لفعَّاليَّة التَّعليم في المدارس الرَّسميَّة في لبنان
يسلِّط هذا النَّصّ الضَّوء على تأثير التَّعاون في التَّعليم استجابةً للتَّحدِّيات المتزايدة الَّتي تواجهها الأنظمة المدرسيَّة. وعلى مدى العقود الماضية، بدأت بلدان عدَّة بتطبيق إصلاحات مدرسيَّة تهدف إلى تحقيق اللَّامركزيَّة في سلطة اتِّخاذ القرارات، وحثِّ الجهات...
اللَّاأرخيَّة – نحو مصطلحٍ جديد
تستكشف هذه الدِّراسة مفهوم «الأرخيّة» وضرورة استخدامه، من الآن فصاعدًا، في الفلسفة العربيَّة من خلال تحليل أصول الكلمة اليونانيَّة «ἀρχή» واستخداماتها الشَّائعة في التَّرجمة. يجادل الكاتب بأنَّ التَّعريفات الحاليَّة للأرخيَّة لا تنقل كامل دلالاتها، ويقترح العودة إلى...
في الأقانيم والجوهر مقالان ليحيى بن عديّ في التَّثليث والتَّوحيد اختصرهما الصَّفيُّ بن العسَّال
يضمُّ هذه البحث مقالَين مخطوطَين ليحيى بن عديّ يُنشران لأوَّل مرَّة: 1- مختصَرَ جواب يحيى بن عديّ عن مسائلَ في الأقانيم الثَّلاثة. 2- مختصَرَ مقالةٍ له في جواب مقالة يعقوبَ الكنديّ في الرَّدِّ على النَّصارى، وذلك في سنةِ خمسين وثلاثِمئةٍ. يتضمَّن البحث دراسةً...
الخير والنُّور والجمال كأسماء إلهيَّة لدى ديونيسيوس الأريوباغيّ المُنتحِل
كثيرًا ما تمَّت دراسة كتابات ديونيسيوس الأريوباغيّ المنتحِل انطلاقًا من الأفكار الفلسفيَّة الَّتي سبقته أو ربَّما المعاصرة له لتبيان تأثيرها في تفكيره، واكتشاف التَّحوُّل الَّذي أجراه ليلائمها مع الإيمان المسيحيّ. لكنَّ هذه الدِّراسات قلَّما أعارت العنصر الدِّينيّ،...
الرَّصافيَّات والرِّيحانيَّات، نظر للأب لويس شيخو اليسوعيّ
مقالات من أرشيف مجلَّة المشرق السَّنة الثَّالثة عشرة، العدد 5، أيَّار (1910)
Le Liban en turbulence : Naviguer entre identités confessionnelles et enjeux Régionaux
Salah Aboujaoudé S.J. t Le Liban en turbulence : Naviguer entre identités confessionnelles et enjeux régionaux 1ère édition, 204 p. Beyrouth : Dar El Machreq, 2024 ISBN: 978-2-7214-7120-8 جميل أن تهتمّ الجماعات والرَّهبانيَّات والجامعة الخاصَّة بالشَّأن العامّ في...
دليل المنهجيَّة في أبحاث العلوم الإنسانيَّة- طرائق البحث الجامعيّ في اللَّاهوت والفلسفة
الأب غي سركيس ولينا حوَّاط دليل المنهجيَّة في أبحاث العلوم الإنسانيَّة -طرائق البحث الجامعيّ في اللَّاهوت والفلسفة ط.1، 136ص.، بيروت: دار المشرق، 2024ISBN: 978-2-7214-1221-8 يطرح الأب غي سركيس والدُّكتورة لينا إسكندر حوَّاط في كتابهما دليل المنهجيَّة في أبحاث العلوم...
مَيمَر في الحُرِّيَّة
ثاودورُس أبو قُرَّة مَيمَر في الحرِّيَّة قدَّم له الأب پيير مصريط.1، 94 ص. بيروت: دار المشرق، ٢٠٢٤ISBN : 978-2-7214-5668-7 ثاودورُس أبو قرَّة المولود في الرُّها، هو أحد آباء الكنيسة الَّذي عاش ما بين أواسط القرن الثَّامن وأوائل القرن التَّاسع. اعتنق الحياة...
فقر الرُّوح – ألم البشر وآلام المسيح
يوهان بابتيست ماتس فقر الرُّوح، ألم البشر وآلام المسيح تعريب الأب باسم الرَّاعيط.1، 88 ص. بيروت: دار المشرق، 2024ISBN: 978-2-7214-5667-0 كُتيِّب صغيرٌ في حجمه، ثقيلٌ في مضمونه. جان بابتيست ماتس لاهوتيّ ألمعيّ مشهور، خصوصًا في مجال اللَّاهوت السِّياسيّ . وهذا الكتاب...
ندامةُ الله بين الرَّحمةِ والعدالةِ في أسفارِ الأنبياء
الأب فراس لطفي الفرنسيسكانيّ ندامةُ ﷲ بين الرَّحمة والعدالةِ في أسفار الأنبياء ط.1، 62 صفحة، بيروت: دار المشرق، ٢٠٢٤ISBN : 978-2-7214-5669-4 الأب فِراس لُطفي راهبٌ فرنسيسكانيّ من مواليد سوريا. حائزٌ شهادة الماجستر في اللَّاهوت الكتابيّ من الجامعة اليسوعيَّة...
جعلتُ أمامك الحياة. الإجهاض: المحرقة الصَّامتة
الأب جان پاول اليسوعيّ جعلتُ أمامك الحياةالإجهاض: المحرقة الصَّامتة ترجمة يزن غزالةط.1، 276 ص. بيروت: دار المشرق، 2024ISBN : 978-2-7214-5671-7 عنوان يلفت نظر القارئ قبل الغوص في مضمون الكتاب لأنَّ الإنسان مشروعُ حياة لا موت، مشروع نموٍّ لا إجهاض. حياة تبدأ براعمها...