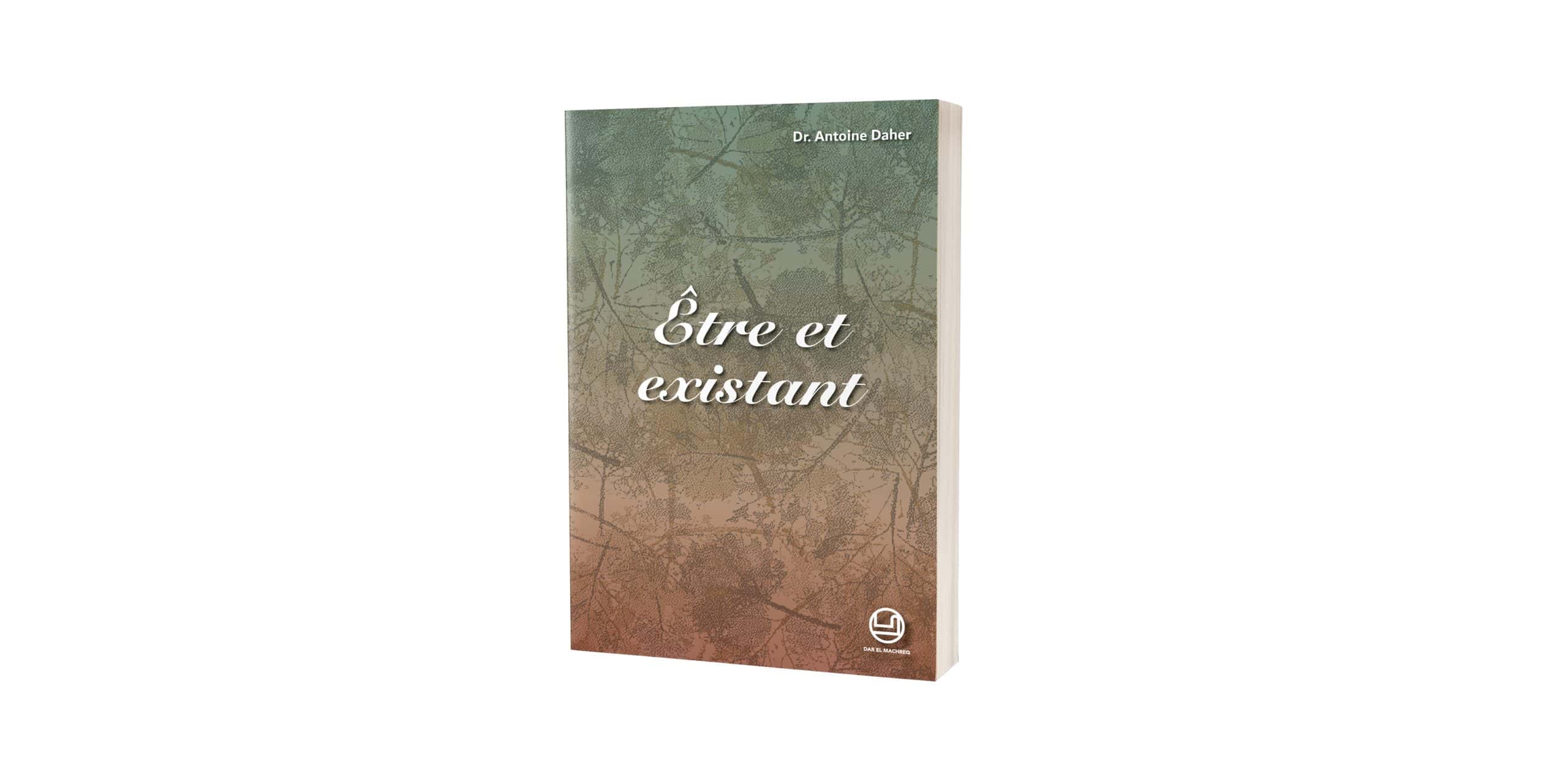Antoine Daher
Être et existant
ط.١، ١٨٠ ص، بيروت: دار المشرق، ٢٠٢٥
ISBN : 978-2-7214-1222-5
إنَّ المؤلِّف هو الطَّبيب المرموق والإنسانيُّ أنطوان ضاهر. وهو المحاضِر المتمرِّس في كلِّيَّة الصِّحَّة في الجامعة اللُّبنانيَّة. إلى جانب عمله، أكبَّ على مطالعة الأدب والفنِّ والفلسفة، وتدوين الخواطر الَّتي انبثقت من وجدانه، وعندما بلغ مرحلة التَّقاعد، شرع بتنظيم تلك الأفكار والتَّأمُّلات، فنُشرت بعد أعوامٍ ثلاثة على وفاته في دار المشرق، بفضل جهود ابنته السَّيِّدة دنيز ضاهر بستاني.
يتألَّف الكتابُ من قسمَيْن: الأوَّل (ص. ١٧-١١٠)، وعنوانه «الكائن». توسَّعَ فيه المؤلِّفُ بالكائن البشريِّ الحيِّ، الواعي، الاجتماعيِّ، الأخلاقيِّ، العاطفيِّ والمُفكِّر، وتطرَّق إلى إشكاليَّاتٍ عديدة كالحرِّيَّة، الحقِّ، الجسد، الأبديَّة، العدم، العالَم، الخلق والفكر. وفي الثَّاني (ص. ١١١-١٦٥)، وعنوانه «الموجود»، توقَّفَ عند ملفَّاتٍ ثلاثة: التَّصرُّف (أو العمل)، الجماليَّة، والموت. نعرض للقرَّاء ملفًّا مقتضبًا في القسمَين، ليستطيعوا اكتشافَ شيء من مقاربات الدُّكتور ضاهر الفلسفيَّة وآرائه:
– الكائنُ الأسمى (ص. ٧١-٧٧): سأل الكاتبُ عمَّا إذا كانت فكرة الله فطريَّة أم نتيجة الاستدلال المنطقيِّ؟ بدا له أنَّ الإنسان آمن بالألوهة منذ فجر التَّاريخ، فسجد للمخلوقات الَّتي استحسنها واستهابها، ثمَّ للآلهة الَّتي نسجها خياله، وأخيرًا للإله الواحد القدير والأبديِّ، مستطردًا إلى التَّباعدات والتَّناقضات بين أنبياء الدِّيانات المختلفة ورسلها، فنصح باختيار التَّعاليم الأقرب إلى الطَّهارة والنُّبل، رافضًا سعيَ الفلاسفة إلى إثبات وجود الله من طريق المنطق البشريِّ، فالإنسانُ يختار سلوك طريق الإيمان، ليس امتثالًا لبراهين عقليَّة، بل بعد عجزه عن تفسير دواعي الخلق، وقناعته بأنَّه لا يمكن أنْ يفتقر الوجودُ إلى المعنى.
– التَّوق إلى الجماليَّة (ص. ١٤٩-١٦٠): يُحسُّ المرءُ بالجمال ويعبِّر عنه غرائزيًّا، فإذا به يعبُر إلى عالم التَّأمُّل والإعجاب والتَّأثُّر الممتع. الفنُّ الأصيل لا ينسخ الواقعَ، بل يحكم عليه، كما أنَّه ينقل الإنسانَ التَّوَّاق نحو آفاقٍ مجهولة بعيدة عن الرَّتابة والحزن، ولذلك لا يعود هذا الإبداع مُلكًا شخصيًّا.
في المقدِّمة، أكَّد المؤلِّفُ أنَّه لا يحترف الفلسفة، بل هو مراقبٌ تمعَّنَ في البشر والوجود، وطبيبٌ فكَّر في المعنى بعد أن شاهد معجزة الجسم البشريِّ واحتكَّ بالموت (ص. ١٣). هدَف إلى إشراكنا في قناعاته الَّتي توصَّل إليها من خلال مسيرته واختباراته وقراءاته، علَّها تحثُّنا على الرَّغبة في الإجابة عن التَّساؤلات. فالإنسان «الَّذي وُجد مُرغمًا، باحثًا بلا كللٍ عن ذاته الهاربة منه، مدركًا أنَّه ضيفٌ في كيانه، راغب بإلحاحٍ بأن يصبح مالكًا ذاتَه» (ص. ١٧١).
أختم بفقرةٍ من الكتاب يتناول فيها الإيمان بالله : «من الثَّابت أنَّ الله حاضرٌ في اللَّاوعي الجماعيِّ. إنَّ الكسب من السُّجود له والإيمان به يفوق أضعافًا مُضاعفة ضرورةَ إثبات وجوده. فالله يظلُّ، بالنِّسبة إلى كثيرين، الحلَّ البسيط، السَّهل والمثاليَّ لإشكاليَّة الوجود. هو الَّذي خلق الكائنات، ومنحَها المعنى، ووجَّه مصيرَها. هو الدَّواءُ الشَّافي والملاذ الأخير عند الموت. هو أساسُ العدل والأخلاق والنِّظام الاجتماعيِّ. ينتج إيمانُنا به من عجزنا عن تفسير كلِّ ما يحيط بنا، ومن حاجتنا إلى عونه، ومن إملاءات عقلنا» (ص. ٧٦).
الأب غي سركيس : حائز درجة الدُّكتوراه في اللَّاهوت من الجامعة اليسوعيَّة الغريغوريَّة الحبريَّة (روما). أستاذ محاضر في جامعتَي القدِّيس يوسف، والحكمة. وهو كاهن في أبرشيَّة بيروت المارونيَّة. له مجموعة من المؤلَّفات الدِّينيَّة والتَّأمُّليَّة والفكريَّة في اللَّاهوت المسيحيِّ، وحوار الأديان والحوار الإسلاميِّ- المسيحيِّ، وبعضها من إصدار دار المشرق (نوبل للسَّلام… لمن؟، أؤمن… وأعترف، قراءة معاصرة في الإيمان المسيحيِّ، وإيمان في حالة بحث – النَّشاط اللَّاهوتيّ في المسيحيَّة، ودروس من الهرطقات، والبابا فرنسيس، صاحبُ الفطنة والسَّذاجة، جولةٌ في فكره اللَّاهوتيِّ).